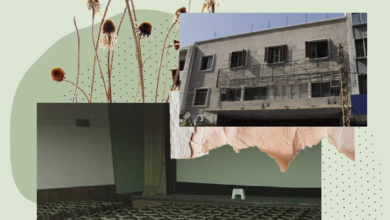سيرة ساحل النصارى الذي أصبح ضاحية بيروت الجنوبيّة

في تلك الأيّام، منذ أكثر من أربعين عامًا، أدركتُ آخر المشاهدات الريفيّة للضاحيّة الجنوبيّة، بل امتزجت بها بكامل حواسي، قاطفًا للّوز من شجرة خالي توفيق، والتوت من شجرة أمّ عزّات، والرمّان من عودة الشيخ جعفر الخليل، “العودة” التي راشقنا فيها شجرة البلح حتّى تجود علينا ببعض الزغلولي، كما شاكسنا البقرة المربوطة بالسنديانة المعمّرة، ولاحقنا الدجاجات التي يتكفّل أبو قاسم متابعة شؤونها، فكان يكلّفنا بجلب بقايا الخضار لها، وللبقرة، من سوق الشيّاح، بمحاذاة ملعب النصر، على أن تكون جائزتنا السماح بارتمائنا في مياه البركة الكبيرة، ذات اللون الأخضر، المكلّلة بغيمة من البعوض. في العودة حفرنا قنوات طويلة، فقط لمتعة تأمّل المياه وهي تمشي رويدًا رويدًا باتّجاه الحفرة الأخيرة التي تتطلّب منّا نصف ساعة لحفرها.
في أحيان كنّا نقطع شوارع عدّة، باتّجاه حيّ ماضي، أو الحدث، بغية قطف الحامض، والحمّيضة، بعد أن نرش عليها الملح الذي نحمله في جيوبنا الصغيرة، لهذه الغاية بالذات. كان في الأمر كثير من المخاطرة، حيث كان ثمّة قنّاص يستبيح مساحات لا بأس بها من ملاعبنا، والبساتين القليلة التي أهملها أصحابها بسبب الحرب.
في كلّ أسبوع كنّا نزور بيوت أصهرتي، من آل منصور، في برج البراجنة، فننزل إلى الجلول، حيث الخسّ والفجل والهندباء والنعناع مع الكثير من أشجار النخيل ذات البلح الأحمر. دهشتي الأكبر كانت حين يأخذني أقاربي هؤلاء معهم إلى بيوت أقربائهم في العمروسيّة (حيّ السلم حاليًّا) لأسرح في مساحات واسعة مزروعة بالخضار على أنواعها.
في أحيان كنّا نقطع شوارع عدّة، باتّجاه حيّ ماضي، أو الحدث، بغية قطف الحامض، والحمّيضة، بعد أن نرش عليها الملح الذي نحمله في جيوبنا الصغيرة، لهذه الغاية بالذات، كان في الأمر كثير من المخاطرة، حيث كان ثمّة قنّاص يستبيح مساحات لا بأس بها من ملاعبنا.
أوتوسترادات بتسميات
شيئًا فشيئًا بدأت مشاريع البناء تتزايد، محتلّة البقع الخضراء والحمراء. وانتصبت أربعة أبنية في تلك العودة التي صنعت ذكرياتنا الأجمل. غير أن هجمة الإسمنت الفعليّة كانت بعد انتهاء الحرب في العام 1990، حيث تفتّحت العيون على كلّ “بورة” وملعب، وجلّ وبستان. قضي الأمر في سنوات قليلة، ثمّ تمّ شقّ أكبر شارعين في الضاحية: أوتوستراد “هادي نصرالله”، وشارع “الجاموس”، لتنتشر الأبنية والمطاعم، والمتاجر من على جنباتها. في هذين الشارعين اكتمل نصاب الشوارع الكبرى، على أن نضيف إليها اوتوستراد حافظ الأسد، الوسيط بين الجنوب وبيروت.
قبل الحرب بسنوات طويلة، أيّ في مطلع القرن العشرين، حيث نهاية العهد العثمانيّ، وبداية الانتداب الفرنسيّ، اخترق الضاحية الجنوبيّة ستة شوارع رئيسة، أبرزها ما يعرف اليوم بطريق صيدا القديمة، وثانيها طريق بيروت، الحرج، الغبيري، وصولًا حتى حارة حريك. أمّا ثالثها فمن المشرّفيّة إلى المريجة مرورًا ببئر العبد، والرويس.
بالطبع كانت هناك طرقات فرعيّة وأزقّة، غالبًا ما تكون مسيّجة بالصبّار، على أن يقوم أصحاب الأراضي بتشذيب أمشاطها كلّما بدأت تتمدّد لتزعج المارّة ودوابّهم.
بين التاريخ والجغرافيا
في مخطوطة للمؤرخ صالح بن يحيى التنّوخيّ (عاش في القرن الخامس عشر)، ورد ذكر هذه البقعة الساحليّة، حيث رويت قصّة امتناع سكّان قرية “البرج” عن دفع إقطاع الأرض لأحد الأمراء الدروز، بل وقتلهم “العبد” الذي بعثه لهذا الغرض، قبيل أن يلقوا بجثته في بئر يُعرف مكانه اليوم بـ”بئر العبد”. تكاد تكون هذه الوثيقة هي الأقدم، لتستتبعها إشارات قليلة عند المؤرّخين ممّن توالوا بعد التنوخي.

من الناحية الجغرافيّة تقع الضاحية بين ساحل بيروت الجنوبيّ وبداية جبل لبنان شرق بيروت. وهي تتبع لمحافظة جبل لبنان، بينما عُرِفَت سابقًا بـ”ساحل النصارى”، ثمّ بـ”ساحل المتن الجنوبيّ”. وهو توصيف لا يزال حاضرًا في أوراق النعي، حيث يذكر مع الآسفين: أهالي ساحل المتن الجنوبيّ.
وحسب مصادر تاريخ جبل لبنان الاجتماعيّ، فقد نشأت النوى العمرانيّة للضاحية، مع البيوت المتفرّقة والموزّعة خارجها في البساتين، عن حركة الهجرات المتعاقبة من القرى الجبليّة- المسيحيّة بغالبيّتها- نحو السواحل والسهول، للعمل والإقامة فيها وذلك منذ القرن السادس عشر. بالطبع كانوا يبنون بيوتًا بمقوّمات الحدّ الأدنى من العيش، لكنّها لم تؤّلف وحدة سكّانيّة متلاصقة، كما طبيعة القرى، ذلك لأنّ المساكن تلك كانت مبنيّة في داخل البساتين التي يعملون فيها.
قوافل الجِمال
كانت الضاحية الجنوبيّة المؤلّفة من: الشياح، غبيري، حارة حريك، برج البراجنة، والمريجة، خير مصدر لحليب الأبقار والأغنام والماعز، إلى بيروت، مستغلّة خصوبة أراضيها الخضراء، ومجاورتها للعاصمة، في حين كانت القوافل تجهد بالتنقّل من البقاع والجبل والجنوب، ما يرفع كلفتها بطبيعة الحال. مع ذلك كانت هناك الكثير من العائلات التي ربّت الجمال في مزارعها، والبعض كان قوافله تنتقل بشكل معاكس من الضاحية نحو الجنوب وفلسطين، أو نحو البقاع وسوريّا، ناقلة بعض المزروعات والمنتوجات، غير أنّ الهدف الفعليّ، هو ما ستجلبه تلك القوافل من هناك إلى الضاحية.

في كتابه “الضاحية الجنوبيّة أيّام زمان” (دار الكتاب اللبناني)، يذكر المؤلف محمّد كزما، أنّ ساحة عين السكّة (في برج البراجنة) كانت محطّة للقوافل، يشرب فيها الجمال وأصحابها، كما كان يجري ذبح الجمال بشكل دوريّ هناك، ليتمّ توريد لحومها إلى أكثر من منطقة في المحيط. هو نمط بدأ بالاختفاء في نهايات الأربعينيّات، حيث امتلك كثر من المزارعين والتجّار وسائل نقل حديثة كالشاحنات والحافلات والسيّارات، فكسبوا الوقت، واستغنوا عن الوسائل التقليديّة التي تفرض عليهم السفر لأيّام وأسابيع، مع ما في الأمر من مشقّات ومخاطر.
في منتصف القرن العشرين، كسدت تجارة الحليب بعد التحوّلات التي ولّدها الإستيراد، فشاع الحليب المجفّف في الأسواق، وتردّت أحوال الرعيان، وراحت قطعان الأبقار والماعز تتضاءل شيئًا فشيئًا، ليس في الضاحية الجنوبيّة فحسب، بل في لبنان عمومًا. كانت هذه الضربة الثانية بعد انهيار سوق الحرير في الربع الأول من القرن العشرين. هكذا انتقلت الايدي العاملة نحو مجالات أخرى، مثل العمل في سياسة الخيول، بعد أن نشأت اسطبلات كثيرة بين الشيّاح والغبيري، تلبية لحاجة ملعب سباق الخيل الذي نشأ في العام 1927.
تبدّل سريع ومتفاقم
في هذه الفترة وفدت أكثر من ستّين عائلة بقاعيّة إلى الضاحية، للعمل في تربية الخيول وترويضها، كونهم من أهل الخبرة في العلاقة مع الخيل. كذلك كان التوجّه بعد سنوات نحو معمل غندور، ومعمل جبر، ومعمل العطور الذي كان يسمّى شعبيًّا بـ”معمل الريحة”. ليتبدل الحال بشكل كبير مطلع السبعينيّات، دون أن ينتكس الحال بشكل كبير في فترة الحرب، ثم لتشهد الضاحية طفرة مطلع التسعينيّات، تجاوزت في أثنائها أعداد المؤسّسات التجاريّة والاقتصاديّة لتقارب اليوم الرقم 37 ألف متجر ومؤسّسة، ويقارب عدد مستشفياتها العشرة، ويزيد عدد الفروع المصرفيّة على المئة.
مثل العديد من المناطق اللبنانيّة، كانت زراعة أشجار التوت رائجة في الضاحية الجنوبيّة، إذ كانت تنتج عائدات عالية، بسبب تربية دود القز، وسهولة تصدير المواسم إلى بيروت ومن ثمّ يتمّ نقلها إلى إيطاليا وفرنسا، وبعض البلدان الأوروبّيّة.
مثل العديد من المناطق اللبنانيّة، كانت زراعة أشجار التوت رائجة في الضاحية الجنوبيّة، إذ كانت تنتج عائدات عالية، بسبب تربية دود القز، وسهولة تصدير المواسم إلى بيروت ومن ثمّ يتمّ نقلها إلى إيطاليا وفرنسا، وبعض البلدان الأوروبّيّة.
ومثل باقي المناطق، انحسر الاهتمام بالتوت، ودود القزّ، وراحت “الكرخانات” تغلق تباعًا لصالح مزروعات واهتمامات ثانية. وهنا لا بدّ من ذكر أشهر مزروعات الضاحية بحسب كتاب “الضاحية الجنوبيّة أيّام زمان”، وهي: الحمضّيات والجارنك واللوز والعنب، دون أن ننسى البلح، والصبّار والرمان. أمّا الخضار على أنواعها فكانت تزرع على مدى مساحات واسعة.
الصيد جوًّا وبحرًا
بسبب كلّ هذه الخصوبة، كانت العصافير تغطّي بساتين الضاحية بنسب كثيفة، لدرجة أن أكثر الصِبْيَة كانوا يصطادونها بواسطة قضبان “الدبق”، بينما انتشر المئات من الصيّادين، بما يتخطّى الهواية، لتتحوّل الهواية إلى مصدر رزق، أو أقلّه وسيلة لتحضير وجبات للعائلة من تلك العصافير.
كذلك كان صيد السمك جزءًا من حياة بعض العائلات، خصوصًا أهل برج البراجنة، الذين اعتادوا نصب الخيام على شاطئ الأوزاعي، والمبيت فيها صيفًا، لأيّام وأسابيع، وفي كثير من الأحيان، كان صائد السمك صيفًا، هو عينه صياد العصافير شتاءً.
عرفت الضاحية الجنوبيّة العديد من النواعير، التي تضخّ المياه من باطن الأرض بنسب لا بأس بها لتأمين حاجيّات البيوت، وبعض المواشي والدواجن، في حين كان المطر يتكفّل بريّ المزروعات شتاء، بينما تتولّى مياه الينابيع والسواقي الدالفة من الحدث والجمهور بريّ المزروعات صيفًا. أمّا الآبار الارتوازيّة فقد حُفِرَت في أواسط عشرينيّات القرن الماضي بإشراف ومتابعة مهندس فرنسي (كما يذكر محمد كزما في كتابه)، فقلّده بعض وجهاء المنطقة من آل منصور وآل حاطوم، لتنتشر تلك الحفريّات في ما بعد في جميع أرجاء الضاحية.

سكّان الضاحية وعائلاتها
منذ ما يناهز تسعين عامًا، كان عدد سكّان الضاحية يقرب خمسين ألف نسمة، (بحسب إحصاء فرنسيّ أُجري في العام 1932) بأكثريّة شيعيّة، يليها كتلة مسيحيّة من الموارنة، وعلى وجه التحديد في حارة حريك، ومريجة، والليلكه، والشيّاح. وهناك عائلات غير قليلة من السّنّة، مثل آل العرب (أغلبهم في برج البراجنة). من العائلات الشيعية نذكر: كزما، الخليل، كنج (في الشيّاح) منصور، الحركة، جلّول، اسماعيل، عثمان، السباعي، السبع (برج البراجنة) قماطي، سليم (حارة حريك)، ومن العائلات المسيحيّة هناك: واكد، حنين، ماضي، الجاموس، معوّض، عون (الرئيس ميشال عون من حارة حريك).
في ذلك الوقت كان هناك بعض النزوح لعائلات من البقاع وجبيل، مثل آل الخنسا، وآل المقداد، وعوّاد، وبرّو، لترتفع النسبة بشكل مضطرد مع توالي السنوات، حتّى كانت الذروة مع بداية الحرب الأهليّة اللبنانيّة، إذ وفد كمّ هائل من الجنوب والبقاع، كذلك هُجّرت عائلات كثيرة من النبعة وتل الزعتر والدكوانة فلجأت إلى الضاحية بالتزامن مع نزوح معاكس لأهل المنطقة المسيحيّين، وصار هناك اقتطاع للأراضي من المشاعات، وكذلك لمساحات مملوكة، وشيّدت عليها عمارات وبيوت مرتجلة، تحديدًا في حيّ السلّم والرمل العالي، فكان تحوّلًا ديموغرافيًّا، لم تستطع الدولة علاجه بعد انتهاء الحرب، ليس بشكل فعليّ أو حتّى جزئيّ.
أمّا عن جذور العائلات، بالأرقام، وبحسب مسح إدارة الإحصاء المركزيّ للعام 2007 فإنّ 50.3 بالمئة من سكّان الضاحية هم من الجنوب، و24.3 بالمئة من البقاع، و9.7 بالمئة من بيروت، و15 بالمئة من جبل لبنان، و0.7 بالمئة من الشمال، و0.1 بالمئة من حملة جنسيّات قيد الدرس. والجدير بالذكر أنّ سُكّان هذه المنطقة الأصليّين لا يتجاوز عددهم 200 عائلة. بالطبع هي أرقام لا تلحظ الوجود الفلسطينيّ (مخيم برج البراجنة على وجه التحديد)، وكذلك النازحين السوريّين، والعمّال المصريّين والسودانيّين والاثيوبيّين، وغيرهم ممّن يشكّلون نسبة مقدّرة من سكّان المنطقة.
أمّأ بالنسبة للإحصائيّات الأقرب إلى مرحلتنا الزمنيّة، فيبلغ عدد سكّان الضاحية نحو مليون نسمة، معظمهم من الطائفة الشيعيّة، ويتوزّعون على أكثر من 200 ألف أسرة بمعدل 4.5 أشخاص للأسرة الواحدة، وفيها ما يزيد على 160 ألف وحدة سكنيّة، مقسّمة على أحياء تسعة.