“أغنيات للعتمة”.. إيمان حميدان توثّق للنضال النسوي بقاعًا
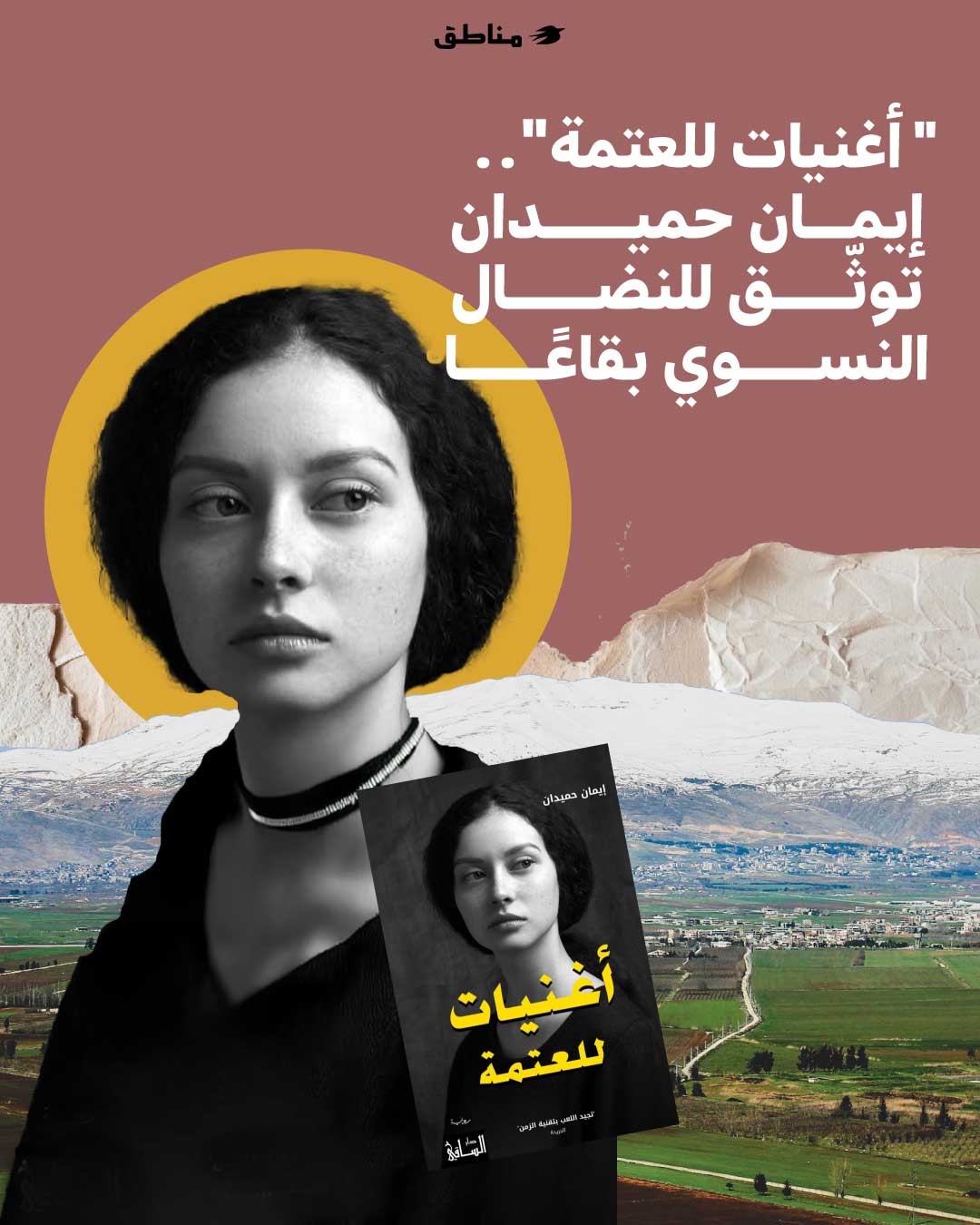
في خضمّ تنظيره لتأويل النّصّ يربط المفكّر الفرنسيّ بّول ريكور زمن السرد بالحدث الإنسانيّ، ويعطي الزمن طابعًا إنسانيًّا محضًا، وفي المضمار نفسه لجأ ميخائيل باختين إلى النظريّة الحواريّة الاجتماعيّة لتعريف التأويل، والحقّ أنّ النّصّ لا يكتسب سمته التكامليّة إذا ما كان يتمتّع بهويّة “زمكانيّة” واضحة تعكس تطلّعات الكاتب ورؤيته إلى العالم وغايته من الموضوعات التي يطرحها.
ولعلّ الديوان الأدبيّ العربيّ كان شاهدًا على محاولات المبدعين في غير مجال التطرّق إلى حال المرأة وأحوالها، وارتباطها بالحركات النسويّة قصدًا أو من غير قصد، بدءًا بمحاولات نوال السعداويّ الروائيّة مرورًا بسرديّات حنان الشيخ وعلويّة صبح وجمانة حدّاد وعزّة طويل وصولًا إلى إيمان حميدان التي توسّلت في عملها الروائيّ الأخير “أغنيات للعتمة” (دار الساقي- 2024 ) والذي تأهّل إلى القائمة الطويلة في الجائزة العالميّة للرواية العربيّة العام 2025 أن تحدّد ملامح العنف الذكوريّ المتوارث والممارس على المرأة بشكل منهجيّ متسلسل، فضلًا عن تفنيد جديد للحراك النسويّ من خلال تسليط الضوء على دور المرأة اللبنانيّة في حقبات سياسيّة مختلفة، كلّ ذلك تحت عنوان “البعد المناطقي” وتأثير بيئة البقاع الغربيّ سيّما الريفيّة منها (أجمات وكسورة) على سلوك الشخصيّات الأنثويّة.
خارطة طريق للتمرّد من كسورة البقاعيّة
راعت إيمان حميدان الطبيعة الاجتماعيّة وبقعتها التي تحتضن الفرد منذ ولادته، وبعيدًا من السجال الفكريّ القائم بين التجريبيّين والمعارضين لهم أمثال نعوم تشومسكي حول ولادة الإنسان صفحة بيضاء ومدى التأثّر والتأثير الذي يقدّمه المجتمع للفرد أو الجماعة، فإنّ الكاتبة ركّزت على الطبيعة الاجتماعيّة للريف وعلى الأعراف والظواهر السوسيولوجيّة القائمة والمتجذّرة، بدءًا بشخصيّة شهيرة التي نشأت بين مسار طفولي مستقيم سرعان ما انحرف العام 1908 حين وُضعت تحت أمر الزواج من صهرها “فايز” بعد وفاة أختها صفاء.

حدث يعكس الطبيعة المنغلقة آنذاك لقرية أجمات التي تنصاع فيها الأسرع لحكم بطريركيّ (أبويّ) قائم على سدّ ثغرات الترمّل (مشتقّة ارتجاليًّا من لفظة أرمل) الذكوريّ، والغاية هي الحفاظ على مكانة الرجل وإلصاقه بالتكامل والصورة الناصعة اجتماعيًّا، فالرجل في المجتمعات الشرقيّة المتقادمة يعدّ ناقصًا إذا ما أتمّ زواجه، فضلًا عن العرف الذي كرّسته الأديان الإبراهيميّة عبر تشديدها على أهمّيّة الزواج حتّى باتت عبارة ” كمّل نصّ دينك وتزوّج” تلازم الأسر التي تسعى إلى توسيع رقعتها الديموغرافيّة في المجتمع.
بدأت حميدان بالشخصيّة الأنثويّة ومأساتها، وصوّرتها بطابع متمرّد كي تخرج من دور الروائيّ الكلاسيكيّ القائم على تصوير المشهد/ الحدث دون أن يترك أيّ مجال لحركة أو تكاثر أحداث دراميّة، واختيارها الريف “جلمات – كسورة” غايته تسليط الضوء على منبع المشكلة أو بالأحرى جذورها، وهي الريف المتأثّر بسنن الأديان وأحكامه. ويُحسب لحميدان أنّ حرّرت بداية شخصيّاتها لا سيّما شهيرة وليلى من دور الراوي، ليكون الحدث مرويًّا بموضوعيّة ودقّة، على أن تسند الصيغة المتكلّمة والرؤية السرديّة المصاحبة لأسمهان، الحفيدة الأخيرة التي ذاقت الشقاء نفسه مع زوجها.
“إشارة إلى قدرة المرأة”
لم تكن حكاية أسمهان المرأة المتمرّدة على زوجها الأمّيّ المحبط، مجرّد دعوة للتمرّد، بل إشارة ثقافيّة إلى مدى قدرة المرأة على بناء مجتمع متكامل من خلال إصرارها على تعليم جميع أبنائها وإشارة اقتصاديّة على قدرتها بمنح الأسرة خاصّيّة إنتاجيّة من خلال استثمار الأرض وتشغيل المعصرة فيها.
إنّ الخصائص المناطقيّة الريفيّة في أجمات وكسورة، وسرد كلّ حدث مع تأريخه في حقبة الحربين العالميّتين مثلًا أظهرت كيف تعامل أهل كسورة مع المجاعة حين صوّرت حميدان توجّه نايف وأخيه سعيد إلى الشام لإحضار القمح لأسرتهما خلال فترة “السفر برلك”، وكيف بدأت النخبة المثقّفة تتجلّى في عائلة الدالي أواخر الحرب العالميّة الثانية وقيام الكيان الاسرائيليّ (نديم وكمال اللذان انتسبا إلى الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ ومنى ابنة عمّهما الناصريّة نموذجًا).
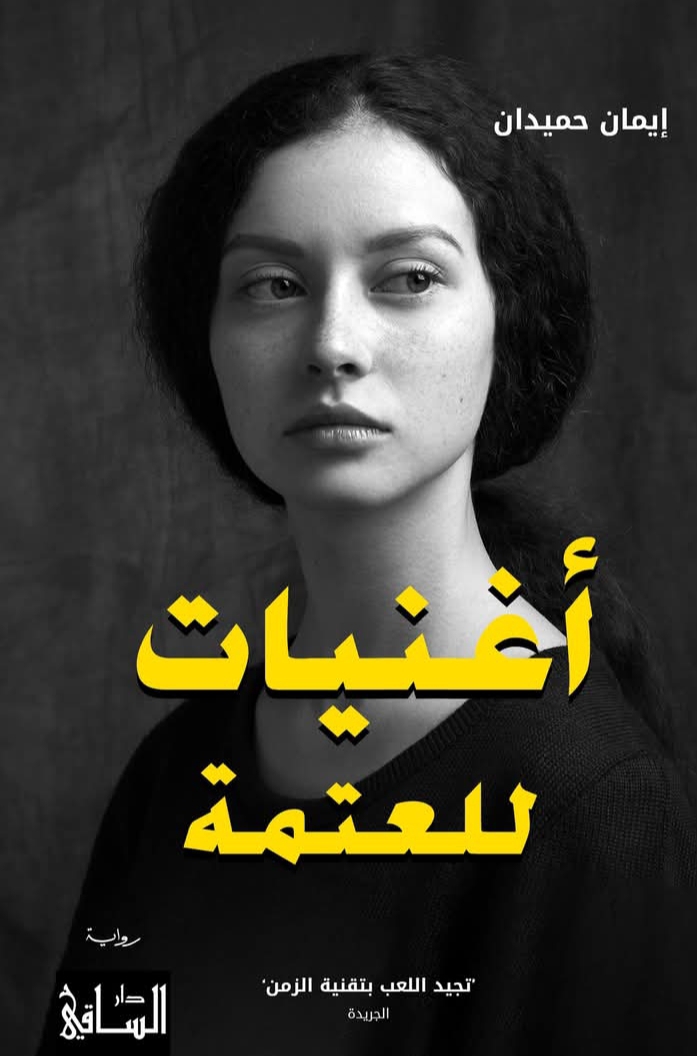
التمرّد الذي حملته الشخصيّات خصوصًا ليلى بعدما خرجت بشكل لاواعٍ من شرنقة الزواج بعد فشل تجربة جدّتها وأمّها نحو العلاقة الحرّة إلّا من العواطف مع يوسف في بيروت.
لقد شكّلت بيروت مكانًا مفتوحًا مقارنة بكسورة وجلمات وهو ما ساهم في تحولات نفسيّة اجتماعيّة عدّة لدى الشخصيّات.
نوستالجيا البقاع الغربي وثوريّة بيروت
شكّلت كسورة وجلمات البقاعيّتان العصب المكانيّ العاطفيّ الرئيس في رواية إيمان حميدان، وكان الهدف أن يبني المتلقّي علاقة مع المكان ليفهم صيغة الشخصيّة، فجلمات وكسورة شكّلتا بطبيعتهما المليئة بالقمح والثمار، والحقول والسهول مكانين مغلقين للشخصيّات الأنثويّة (شهيرة، ياسمين، ليلى وأسمهان) فقد كانت البيوت والأرض والحدائق هي مساحات يستغلّها الذكور (نايف، سالم تحديدًا) لممارسة سلطتهما الانهزاميّة المتمثّلة بالعنف والذكورة القائمة على العيب والعار، ومحاربة كلّ ما هو جديد على هذه البيئة، فالزراعة والحرث والتدجين والزواج المبكر المفروضة على النساء في كسورة كانت تجابه برغبة في التعلّم والاستقلاليّة والقراءة…
لم تكن حكاية أسمهان المرأة المتمرّدة على زوجها الأمّيّ المحبط، مجرّد دعوة للتمرّد، بل إشارة ثقافيّة إلى مدى قدرة المرأة على بناء مجتمع متكامل من خلال إصرارها على تعليم جميع أبنائها
وهي مكتسابات تعرّفت إليها الشخصيّات من خلال اختلاط الثقافات التي سلّطت حميدان الضوء عليه من خلال تطرّقها إلى مراحل الانتداب الفرنسيّ ومشاركة ليلى وكتلة نسائيّة غير منظّمة بمظاهرات تطالب بالاستقلال والإفراج عن روّاد الاستقلال المعتقلين في قلعة راشيّا، هذا الفعل الناتج عن تطوّر الأحداث روائيًّا جعل إيمان حميدان تضع تصوّرًا مقارنًا لاواعيًا بين المدينة والريف من جهة، وبين حريّة المرأة في كسورة وجلمات من جهة وحريّتها في بيروت والمهجر.
لم تكن البيئة الريفيّة البقاعيّة في رواية حميدان مجرّد تفصيل وتأطير مكانيّ للنّص، بل دليل إلى عادات لبنانيّة تراثيّة قائمة على العمل اليدويّ والزراعيّ، بالإضافة إلى تسليع المرأة واعتبارها محرّكًا لخطّة عمل روتينيّة محدودة في الأرض والمنزل، وكأنّ زواج شهيرة من نايف هو مجرّد ملء فراغ يهدّد النظام الأبويّ.
رسمت إيمان حميدان في روايتها “أغنيات للعتمة” خريطة طريق نقديّة للمفهوم النسويّ القائم على فهم الحقوق والواجبات وكيفيّة تحصيلها، في سبيل بناء عقد اجتماعيّ معقول في الريف قبل المدينة، بالاضافة إلى فتح نقاش جديد حول الأحوال الشخصيّة وثورة المرأة الشرقيّة وطمس الهوّة بين الريف والمدينة.




