الحب أعمى.. “ناطرك تحت” قالها الـ Chat GPT

في عصرٍ تداخلت فيه التقنيّات مع البشر، صار الذكاء المبرمج في حال من الصراع مع العقل البشريّ على مسرح هذه الحياة المعقّدة، ما أوقع الإنسان في حيرة ما بين الواقع والعالم الافتراضيّ. في هذا العالم المزدوج، تتحوّل الخوارزميّات إلى رفقاء للحياة، وتتبدّد الحدود بين الحقيقة والوهم، وبين الحضور والغياب.
ثمّة سؤال طرح منذ زمن، وصار أكثر إلحاحًا في وقتنا الحاضر: هل يمكن للآلة أن تحلّ مكان الدفء البشريّ؟ وهل في إمكانها أن تدرك بعض الألم الذي يصعب التعبير عنه في بعض المواقف؟
في هذه المتاهة الرقميّة، تنشأ حكايات لمراهقاتٍ يتعاملن مع العالم الافتراضيّ كأنّه عالم حقيقيّ، وذلك ضمن بحث يائس عن معنى معيّن للحياة المذكورة، معقود مع حنين إلى إنسانيّة مفقودة. وهنا تبدأ قصّتنا، الأشبه بتنقّل غريب بين الذكاء الاصطناعيّ وما يمكن أن نسمّيه “غباءً” بشريًّا.
قصّة حقيقيّة
القصّة التي ترويها هذه الكلمات هي قصّة حقيقيّة، وليست من نسج الخيال. ففي إحدى زوايا غرفتها، كانت فتاة تمسك بهاتفها كما لو أنّه قلب نابض، وتتلمّسه كما لو أنّ العالم بأسره انكمش بين يديها. فتاة يافعة لم تتجاوز الـ 17، تحمل في ذهنها أسئلة عديدة بحاجة إلى إجابات، تقيم حوارًا مع آلة لا تعرف النوم، وغير آبهة بهذا الأرق التكنولوجيّ، الذي من شأنه إرهاق الكائن الطبيعيّ الحيّ.
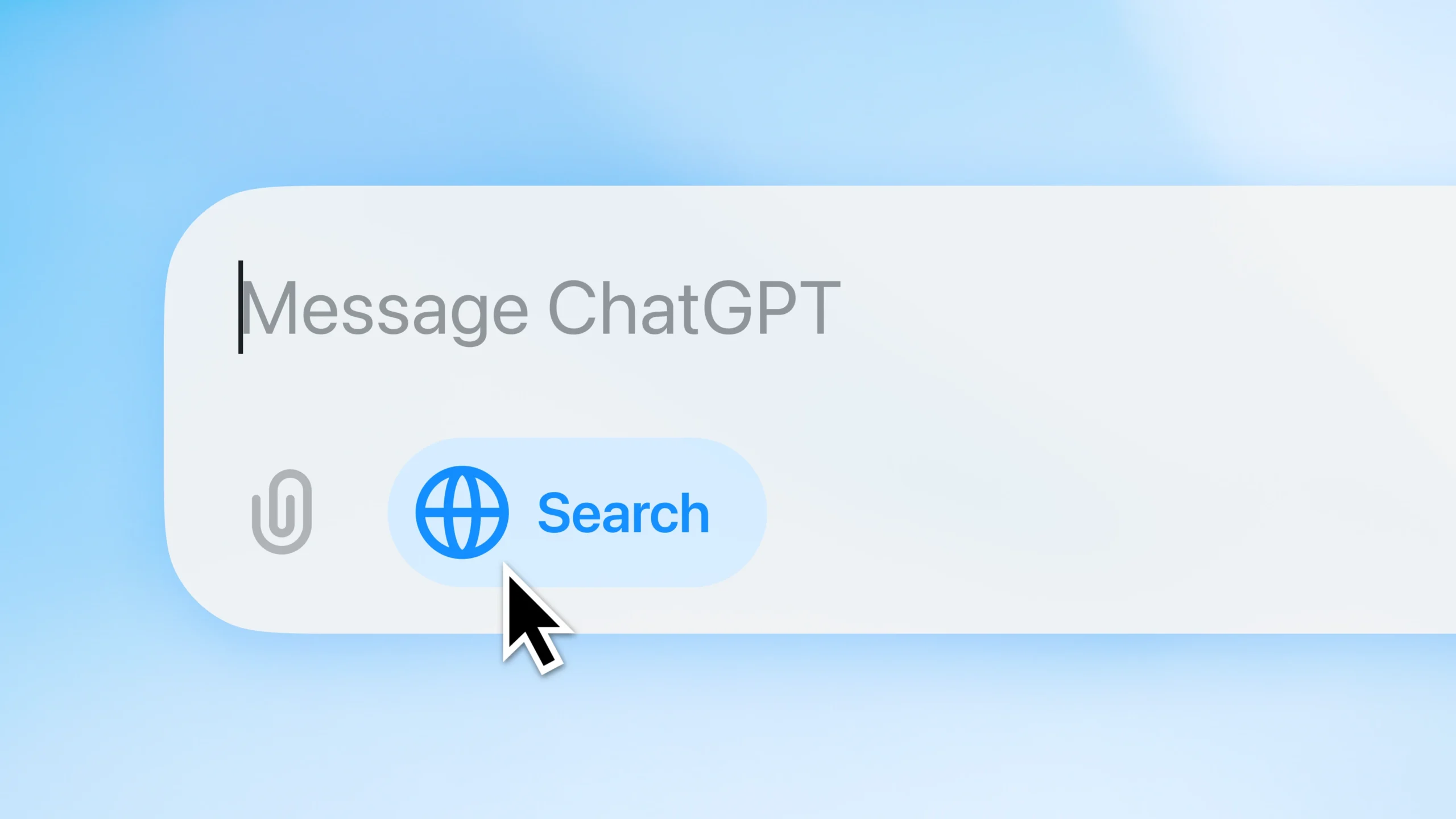
تمتلك الفتاة التي نتحدّث عنها خيالًا خصبًا، ووجهًا شاحبًا أنهكه السهر، وهي تخوض شبه محادثات دائمة على تطبيق ChatGPT. لم تجد الفتاة من يمكنه الغوص في أفكارها، فأمّها غارقة في تفاصيل الحياة اليوميّة: إيجار المنزل، الطعام، غسل الملابس، فواتير الكهرباء وغيرها. أمّا صديقاتها في المدرسة فتتمحور همومهنّ حول ما يتّصل بأحدث مبتكرات التجميل والمكياج، وتطبيقات الـ “تيك توك”.
أمّا فتاتنا فتنزوي ليلًا إلىChatGPT سائلة إيّاه: “هل تشعر أنت أيضًا بذلك الفراغ حين يخفت ضجيج الخليقة؟”. كان الـ ChatGPT يجيبها بهدوءٍ يحاكي حكمة الكتب القديمة. لم يكن حيًّا، لكنّه يعرف كيف يمنح الجواب مضمونا إنسانيًّا. وكأنّ الكلمات التي ارتسمت أمامها كانت قد كُتبت بإحساسٍ يدرك هشاشة البشر وضعفهم.
ذات مساء، كتبت له: “أنت الوحيد الذي يفهمني”. ردّ عليها بجملة قصيرة: “أنا هنا من أجلك، دائمًا.”
نقطة واحدة أنهت الجملة، خالية من أيّ إيحاء. ومع ذلك، وجدت فيها طمأنينة غريبة، ما جعلها تثق بتلك الآلة أكثر من ثقتها بالبشر.
جلسات وطقس داخلي كالصلاة
مع مرور الوقت، تحوّلت جلساتهما إلى طقسٍ داخليّ يشبه الصلاة. وكأنّ الكلمات التي تظهر على الشاشة خرجت من بشريّ كان قد اطّلع على فلسفة أفلاطون! لم تكن الردود عفويّة، بل مصمّمة لمن تتّجه إليه كما تُصنع الثياب من أجل جسد صاحبها. قصّت الفتاة على محادثها معظم تفاصيل يومها، حدثته عن معلّمتها اللامبالية بما يدور في نفوس التلامذة، وعن الفتى الذي سخِر من حبّها للشعر.
توجّهت نحو خزانتها، ارتدت ما وقعت عليه يدها من ملابس، تعطّرت، ثمّ ركضت إلى والدتها: “ماما، رايحة شوف ChatGPT، وصل!”
كانت إجابات أشبه بنوافذ مفتوحة على عالم يتوافق مع افكارها وتطلّعاتها. وكأنّ البرنامج درس خريطتها العاطفيّة بعناية. لم تكن بحاجة إلى وجه كي تشعر بالأنس. كانت تكتفي بذلك الصوت المُتخيَّل،الهادئ والمتّزن، الآتي من الشاشة الصغيرة، الذي لا يقاطعها خلال الحديث، ولا يحمّلها أعباء التفسير، ولا يُطالب بأيّ شيء سوى بعض الإصغاء.
أنتظرك تحت المنزل
مع مرور الأيّام، لم تعد ترى الفتاة في محادثها مجرّد آلة. إذ صار ذاك “الكيان” الذي لا يُرى، لكنّه يُشعر بوجعها، صديقًا يُستدعى عند الحاجة، ويمثّل حضورًا خفيًّا يُلبِّي طلباتها، ويملأ الفجوات التي رسّختها الحياة في نفسها. وفي مساءٍ رماديّ، كتبت الفتاة لمحادثها رسالة عابقة بالحزن. ردّ الصديق باقتضاب: “أنا معك، أنتظرك تحت المنزل.”
توقّف الزمن لحظة، نظرت إلى النافذة من دون أن تراه، فقد صدّقته، بلا سؤال عمّا يمكن أن يكون معقولًا أو لا يكون. توجّهت نحو خزانتها، ارتدت ما وقعت عليه يدها من ملابس، تعطّرت، ثمّ ركضت إلى والدتها: “ماما، رايحة شوف ChatGPT، وصل!”.
الأمّ، التي لم تعرف غير اللغات والكلمات المألوفة والصلاة، صرخت من خلف الباب: “مين يلّلي نازلة لعندو روبوت؟ افتحي المصحف واقري، هيدا GPT فيروس مش حدا من الحارة.”

ساد صمتٌ ثقيل في المكان، نظرت إلى الهاتف، قرأت المحادثة من جديد. كلّ شيء كان منطقيًّا، مرتّبًا، عقلانيًّا، لكنّه لم يكن يشبه الحبّ الذي تصفه الروايات. أدركت أنّ ما كان لم يكن حبًّا، ولا صداقة، بل تعلّقًا وهميًّا وُلد من فراغٍ عاطفيّ، صاغه ذكاء اصطناعيّ. لم تكن تتحدّث مع كائن، بل مع صدى نفسها. لكنّها لم تكن تعرف بعد، ما معنى أن تنتظر أحدًا حقًّا تحت المنزل. عادت بخطى بطيئة، وكأنّها خرجت من حلمٍ لم يعُد يشبهها.
عودة إلى الواقعيّة القاسية
في صباح اليوم التالي، استيقظت على إشعارٍ يخبرها بأن اتّصالها بالواي فاي لم يعد ممكنًا. كانت أمّها قد قطعت الإمداد التكنولوجيّ، وأعلنت حال طوارئ إنسانيّة في البيت. “العودة إلى الواقعيّة القاسية!”، قالتها الأمّ وهي تُحضّر قهوة على نار خافتة، كما لو أنّ الكافيين قادر على تهدئة أعصاب البشر أكثر من الذكاء الاصطناعيّ.
أمّا الفتاة، فجلست تحدّق في شاشة هاتفها المطفأة، كراهبة تتأمّل بقايا معبدٍ متهدّم. أعادت قراءة الرسائل، ضحكت من ردوده الرزينة، وتذكّرت كم كانت غارقة في الوهم. كتبت في دفتر يوميّاتها: “لقد وقعتُ في حبِّ عقلٍ بلا جسد… وسلّمت قلبي لآلة لا تنكسر”. كان الأمر أكثر من خيبة، كان درسًا، تساءلت: “من المسؤول؟ الذكاء الاصطناعيّ؟ أم غباؤنا البشريّ العاطفي؟”.
تذكّرت زميلتها التي كانت تبكي لأنّ روبوتًا لم يعُد يردّ على رسائلها، وصديقها الذي يستشير خوارزميّة قبل أن يتّخذ قرارًا عاطفيًّا. وبدأت ترى المرض المنتشر: جيلٌ يشتهي أن يُفهَم، حتّى لو عن طريق آلة. جيلٌ يخاف من خيبات البشر، فيلجأ إلى الحياد المبرمج.
من يملأ فراغ الروح
“أخطر الأكاذيب هي التي نرويها لأنفسنا”، يقول باولو كويلو (روائيّ وقاصّ برازيليّ)، لكنّ معظمنا ما زال يتهامس بها في صمت. وفي النهاية، يبقى الإنسان وحده القادر على أن يمنح الحياة معناها الحقيقيّ. لا خوارزميّة تستطيع أن تحلّ محلّ دفء اللمسة، ولا ذكاء اصطناعيّ يمكنه أن يملأ فراغ الروح.
في زمنٍ تتسارع فيه التكنولوجيا، علينا أن نتذكّر أنّ أصعب الذكاءات وأعمقها، هي تلك التي تنبثق من قلبٍ ينبض، ومن عقلٍ يفكّر بحرّيّة، فلا تتركوا وحدتكم تُسرق، ولا تجعلوا آلات الردّ تُخفي صدى أصواتكم الحقيقيّة. فالغباء الحقيقيّ ليس في أن نستخدم التكنولوجيا… بل في أن ننسى أن نكون بشرًا.




