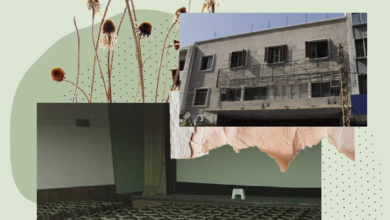الروشة صخرة الحبّ والموت والتحوّلات السحريّة

ستجد رسمها على العملة اللبنانيّة الورقيّة، فئة عشر ليرات (كان آخر إصدار منها سنة 1986) وعلى ورقة نقديّة من فئة مئة ألف ليرة لبنانيّة صدرت بتاريخ 7 كانون الأول/ ديسمبر سنة 2020، في مناسبة مرور مئة عام على إعلان دولة لبنان الكبير. كما ستراها على أكثر من طابع بريديّ، وشعارات الأندية والجمعيّات، وتعاينها موضوعًا في لوحات، وكلمات في أغنيات، وإشكاليّة في أفلام سينمائيّة، وسياقًا في روايات. هي صخرة العشّاق والأبطال، قبل أن تكون حاملة التسمية الشائعة “صخرة الموت”.
فعلى الكورنيش المطلّ على تلك الصخرة الهائلة، يتمشّى عشّاق ومغرمون، وبأيديهم عرانيس الذرة المشويّة، أو صحون الفول والترمس والحامض الموشّاة بالكمّون والفلفل الحرّ. وهنا يقف آخر المصوّرين المنتشرين ممّن يحملون كاميرات ذات صور “فوريّة” لتخليد اللحظة للسيّاح، وأبناء البلد.
حقيقة التسمية والتجويف
إنّها صخرة الروشة، القديمة قِدَم التحوّلات الجيولوجيّة، الراسمة حدود بيروت الجغرافيّة، العاصمة المسيّجة بالبحر، لناحية الغرب. يقال إنّ اسمها مستمدّ من المعنى الفرنسيّ لكلمة صخرة، وهو “لا روش”، وهو ترجيح أقرب إلى المنطق بين الترجيحات الأخرى التي تتناول منحى آراميًّا للكلمة هو “روش” ويعني “رأس”. وتسمّى كذلك “صخرة الحمام”، كونها مأوى مريحًا، ومحطّةً آمنة للطيور، ناهيك عن تسميات أخرى.

لصعوبة نطق العامّة بصيغة المثنّى، سمّيت بصخرة الروشة، بينما تشمل التسمية هنا الصخرتين المتجاورتين، اللتين تحملان اسمًا مفردًا، يجمعهما في بوتقة واحدة، عكس ما تراه العين من ثنائيّة واضحة.
الإشكاليّة الثانية تكمن في ذلك النفق الصغير في أسفل الصخرة الكبرى، وهو محلّ شكّ عند البعض بأن يكون فعلًا من صنع الطبيعة، وفي حال كان حفرًا يدويًّا، فما الحكمة أو الضرورة اللتان تستلزمان الجهد لإنجاز كهذا، هو اليوم يحمل جماليّة بصريّة وسياحيّة، من دون شك؟ غير أنّ ذلك الثقب قديم، يمكن معاينته في تجسيد الصخرة في رسومات بعض المستشرقين.
القافزون من أعلاها
يبلغ ارتفاع صخرة الروشة بين 70 مترًا (للكبيرة) و25 مترًا (للصغيرة)، بينما عمق المياه حولها يقارب سبعة أمتار، وهو ما يكفي القافزين من أعلاها للاندفاع نزولًا، بقوّة الهبوط وسرعته، إذ يتطلب بلوغ سطح الماء ما يقارب الثواني الثلاث، على حسب هواة الغطس في المياه، ومعظمهم يعرف تلك الصخرة، أو تدرّب للقفز عنها، وكثيرًا ما نظّمت مسابقات لهذا الحدث، الذي يتنافس فيه أبطال القفز، بأسمائهم المعروفة وألقابهم، على غرار الألقاب الشائعة في المصارعة الحرّة، واللقب هنا، محاولة لإخراج اللاعب من حيّزه الشخصيّ “الطبيعيّ”، ليكون ذا بعد أعمق أو أقوى، كما هو الحال مع عمر عيتاني (النسر الطائر)، علي عيتاني (حياة لبنان)، عادل حريري (العصفور الصغير)، وزكريا عكنان (نسر الجنوب).
يبلغ ارتفاع صخرة الروشة بين 70 مترًا (للكبيرة) و25 مترًا (للصغيرة)، بينما عمق المياه حولها يقارب سبعة أمتار، وهو ما يكفي القافزين من أعلاها للاندفاع نزولًا، بقوّة الهبوط وسرعته، إذ يتطلب بلوغ سطح الماء ما يقارب الثواني الثلاث.
في العام 2019، نُظِّمَت مسابقة للقفز عن صخرة الروشة، من قبل شركة منتجة لمشروب الطاقة، شارك فيها محترفون من بلدان عديدة، ليفوز في إحدى جولاتها، البريطانيّ غاري هانت (35 عامًا) بالمركز الأوّل، ويحتلّ مركز الوصافة الأميركيّ ديفيد كولتوري. وهنا سنتنبّه إلى ما يتجاوز القفز كفعل جريء، نحو شكل القفزة، وتطابقها مع شروط هذه الرياضة، لناحية ضمّ القدمين، وفتح الذراعين، والحركات البهلوانيّة في أثناء الهبوط.
منتحرون في قداستها
“كان يُدعى رالف رزق الله؛ في صباح السبت 28 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1995، أوقف سيّارته من نوع “تويوتا” خضراء اللون بمحاذاة الرصيف أمام مقهى “دبيبو”، ثمّ ترجّل منها مسرعًا، وتسلّق الحافّة الحجريّة القصيرة، وقفز إلى الفضاء. قبل أن يقفز، شرّع ذراعيه كالصليب، خلفه بيروت، وقبالته صخرة الروشة. كان يرتدي بنطلون (سروال) “جينز” قديم، وقميصًا كاكيًّا اشتراه قبل سنتين.
“كان في الخامسة والأربعين من عمره، ورمى بنفسه”، هو مقطع توثيقيّ للروائيّ اللبنانيّ ربيع جابر، يوصّف فيه ما حصل مع صديقه الدكتور رالف رزق الله، المعالج النفسيّ، والأستاذ الجامعيّ، والكاتب الصحفيّ، الذي انتحر قبالة صخرة الروشة. مع الإشارة إلى أنّ الغالبية العظمى من المنتحرين، يقفزون من كورنيش الروشة، وليس عن الصخرة ذاتها، وهو أمر فيه مشقّة السباحة، أو الانتقال بواسطة قارب، والصعود بشكل متعرّج نحو أعلاها. بالطبع لن يجهد المنتحر نفسه لتحقيق كلّ هذا، ولو أنّه يستبطن البعد الاستعراضيّ لختام حياته.
يُذكر أنّ بلديّة بيروت تمنع تسلّق الصخرة، من باب حفظ السلامة العامّة، ولذلك يتمّ الاستحصال على ترخيص خاصّ للجهات التي تنظّم مسابقات القفز، أو حتّى الأعمال السينمائيّة والتلفزيونيّة والفيديو كليب.
“أبي تحت الصخرة”!
في فيلم “أبي فوق الشجرة” (إنتاج سنة 1969) وعلى إيقاع أغنية “جانا الهوى جانا”، ستكون صخرة الروشة نقطة مركزيّة في ختام مشاهد الأغنية، حيث يستلقي البطلان عبد الحليم حافظ، وناديا لطفي على طرف القارب العابر سريعًا من فتحة الصخرة، بتوزيع متعدّد الجهات للكاميرا، فمرّة هي على القارب، أو في قارب مجاور، ومرّة العدسة تواكب المشهد من الكورنيش، لنشاهد الصخرتين، في أفضل حلّتهما، بما يخدم الفكرة السياحيّة، التي عرف بها لبنان كمقصد للسيّاح، في سنوات ما قبل الحرب، المندلعة في العام 1975.

أفلام كثيرة تقاطعت مع تلك الصخرة الأشهر، بعضها قاربها كمشهد جماليّ سريع، يدلّل على بيروت، وقد تكون فيه الصخرة ذات مركزيّة مؤثّرة في جوهر الفيلم، حال فيلم “عودة البطل”، من بطولة محمّد المولى ومادلين طبر وشوقي متّى. وفي هذا الفيلم يقفز المولى من أعلى الصخرة، ويدور حوار في ما بعد بينه وبين شوقي متّى، يتكرّس فيه تنميط الصخرة، كرمز للموت.
في هذا الفيلم الذي أنتج سنة 1983، أصرّ المخرج على وجود دوبلير للمولى، لينجز تلك القفزة، حيث وجد أن الأمر يحتاج إلى محترف عارف وقافز متمرّس، ليقوم بالأمر، ولذلك يتردّد أنّه لجأ إلى محمّد عيتاني، البيروتيّ النابت عند كعب الصخرة، كونه متآلف مع البحر، ومشهور بقفزاته عن صخرته.
نهضة خدماتيّة وسياحيّة
“حبيبي بيحب التِّشّ، عالرّوشة بيقلّي مش، وان ما خدتو عالروشة، بالبيت بيعمل دوشة”. هكذا غنّت هدى روحانا، من “استديو الفن” ١٩٧٤عن فئة الأغنية الشعبيّة ونالت المركز الأوّل بجدارة (من كلمات كمال بدوي وألحان جميل نحّاس)، لكنّ والدها فرض عليها الاعتزال وخضعت له مرغمة قبل أن تهجر الفن وتهاجر إلى كندا، بينما انطلقت الأغنية وراح اللبنانيّون يردّدونها إلى سنوات عديدة، في احتفالاتهم وأعراسهم راقصين على أنغامها.
“حبيبي بيحب التِّشّ، عالرّوشة بيقلّي مش، وان ما خدتو عالروشة، بالبيت بيعمل دوشة”. هكذا غنّت هدى روحانا، من “استديو الفن” ١٩٧٤عن فئة الأغنية الشعبيّة ونالت المركز الأوّل بجدارة.
للروشة أيضًا غنّت صباح، وفي الإطار عينه، أيّ الروشة كمقصد للزائر، حيث تقول كلمات الأغنية “خدني مشوار، عالروشة، عالمنارة”، بينما غنّى فارس كرم حديثًا للروشة، منشدًا “نزلت عالروشة، عصريي تتسلّا”. هكذا ومن دون قصد، تظهر الروشة في الأغاني كمقصد، وكأنّها بلا سكّان أصليّين، وهو أمر قابل للنقاش، حيث ترتدي المنطقة الطابع السياحيّ الخدماتيّ بين المطاعم والفنادق، في موجة ناهضة انطلقت في خمسينيّات القرن الماضي، بعد أن كانت غالبيتها مساحات زراعيّة بامتياز.
كانت البدايات مع فندق “فيدرال”، وفندق “الكارلتون”، مع أبنية ثوريّة ببصمات هندسيّة إبداعيّة، بتوقيع واثق أديب وكارل شاير وفيليب كرم، يقطنها الميسورون من عائلات بيروت والمناطق اللبنانيّة، والأثرياء العرب، بمن فيهم شريحة الفنّانين، وكان معظمهم يمتلك شققًا مطلّة على الصخرة وبحرها. وهنا لا بدّ من أن نذكر بناية “الشمس” التي حوَت أهمّ المراكز الطبّيّة والإعلاميّة والهندسيّة، وغيرها من القطاعات الحيويّة.
في أسفل المباني تلك، أو حتّى بمحاذاة الكورنيش، كانت هناك سلسلة من المطاعم والمقاهي والكازينوهات، مثل: “الجندول”، “الغلاييني”، “شي بول”، “نصر”، دبيبو”، “فريد الأطرش، “عصام رجّي”، “شانغريلا”، و”يلدزلار” الذي اشتهر بتقديم ستّين صنفًا من المازة اللبنانيّة.
لم تفقد صخرة الروشة بريقها الأخّاذ، تبدّلت الأماكن والفنادق والكازينوهات والأسماء اللامعة حولها، ولمّا تزل هي برونقها محلّ استقطاب سياحيّ، داخليّ وخارجيّ، ومقصد العشّاق، ومحبّي رياضة المشي، كما ستبقى مادة للشعراء والروائيّين والسينمائيّين. تلك الصخرة، تحتلّ مركزًا برّيًّا في بحر بيروت، ومركزًا بحريًّا في برّ بيروت، لتكون هي رأس “رأس بيروت” مهما أطلقت عليها من أسماء تربطها بالموت حينًا وبالعشّاق والمحبّين والباحثين في كينونة جمالها في أحيان كثيرة.