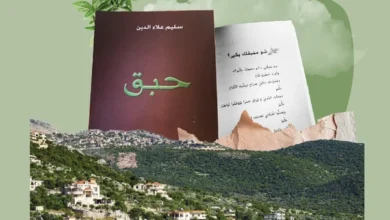الكوفية.. وجه فلسطين الملثّم الذي جاب العالم

قرّرت إدارة دار “كريستيز” في نيويورك، استبعاد لوحتين للرسّام اللبنانيّ أيمن بعلبكي، كان مقرّراً بيعهما في مزاد قريب. عنوان إحدى اللوحتين “الملثّم”، وهي لرجل يلفّ رأسه بالكوفيّة. من الواضح أنّ الحرب على غزّة هي سبب الاستبعاد، حيث انطلقت بروبّاغندا عالميّة تسعى لتشويه رمزيّة الكوفيّة، وإخراجها من دلالتها النضاليّة، المرتبطة بنضال سكّان فلسطين لاسترجاع أرضهم وحقوقهم، وأصالتهم في هذه البقعة من العالم.
لقد علّلت إدارة “كريستيز” الأمر بأنّها تلقّت شكاوى حول مضمون العملين، إذ تمّ الربط بينهما، وبين التطرّف، والحرب الدائرة في غزّة. أمّا صاحب اللوحتين، الفنّان بعلبكي فرأى أنّ “الأمر يتعلّق برقابة على الصورة والثقافة، وهو ما يذكّرنا بنظرة النازيّة إلى الفنّ المعاصر”.

يعيدنا هذا الحدث الإقصائيّ إلى الكوفيّة كنقطة ارتكاز سيميائيّة لقضيّة صار عمرها 75 عاماً، وهي عصيّة على النسيان، أو التحوير، أو حتّى الرقابة التي جاءت من واحدة من أهمّ بلاد الحرّيّات في العالم، أميركا. المفارقة في الأمر، أنّ الشعب الفلسطينيّ ومؤسّساته التربويّة في الوطن والشتات، يحييون “يوم الكوفيّة” في السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر من كلّ عام، أيّ في الأيّام القليلة المقبلة، وذلك بناء على قرار اتّخذته وزارة التربية والتعليم الفلسطينيّة في العام 2015 باعتبار هذا اليوم يوماً وطنيًّا يتوشّح فيه الطلبة كافّة ومديرو المدارس والمعلّمون والموظّفون بالكوفيّة، ويرفعون الأعلام الفلسطينيّة، وينشدون الأغاني الوطنيّة والشعبيّة؛ وتُنظّم فيه العديد من الأنشطة الكشفيّة والرياضيّة؛ كي تبقى الأجيال الناشئة متّصلة برموز الهويّة الوطنيّة الفلسطينيّة.
كوفيّة من أيّام ثورة الانتداب 1936
ارتبط ارتداء الكوفيّة في فلسطين بثورة العام 1936، التي اندلعت في وجه الانتداب والعصابات الطامحة لاغتصاب الأرض. فقد تمّ ارتداء الكوفيّة من قبل رجال الثورة كي لا تعرفهم عيون الاحتلال والعملاء؛ وطلب الثوّار من عامّة الناس وضعها كي لا يميّزهم الاحتلال من بين عامّة الناس؛ بعدما راح هذا الاحتلال يعتقل الثوّار الذين يرتدون الكوفيّة.
ارتبط ارتداء الكوفيّة في فلسطين بثورة العام 1936، التي اندلعت في وجه الانتداب والعصابات الطامحة لاغتصاب الأرض. فقد تمّ ارتداء الكوفيّة من قبل رجال الثورة كي لا تعرفهم عيون الاحتلال والعملاء.
إنّه تمويه تكرّر في فيلم “فانديتا” بعد عشرات السنين، حيث يتمّ تضليل الباحثين عن الشخصيّة المختبئة خلف القناع، فنرى أنّ الجميع قد ارتدوه في ما بعد. مع الاشارة إلى أنّ “فانديتا” فيلم نضالي بامتياز.
جذور الكوفيّة وأسماؤها
تتألّف الكوفيّة من قماش أبيض من القطن الرفيع، تزركشها نقوشٌ مستطيلة أو مربّعة الشكل باللّون الأحمر (وهو المعتاد في السعوديّة) ودول الخليج العربيّ وبادية الشام والعراق)، أمّا الزخرفة باللّون الأسود، فهي السائدة في فلسطين والعراق وسوريّا ولبنان.
ثمّة أسماء متعدّدة للكوفيّة، تختلف بين بلد عربيّ وآخر، فهي “الشماغ” في فلسطين والأردنّ والعراق ودول الخليج، و”غترة” (وهي بيضاء بامتياز) في دول الخليج، وتُعرف بـ”الحطّة” في فلسطين وسوريا ولبنان وبعض الدول العربيّة، أو “المشدّة” أو “القضاضة” أو “الجمدانة” في حوض الفرات وبعض الدول الإسلاميّة.
قبل انتقالها إلى الحيّز الرمزي الدلاليّ، كانت الكوفيّة غطاءً للرأس، يقي الجمجمة من حدّة الشمس، مثلما كانت وسيلة تدفئة في برد الشتاء، وقد يلتثمها الرجال لتكوّن غطاءً (كمامة) في مواجهة العواصف الرمليّة، وما شابه.
تُصنع الكوفيّة عادة، من القطن أو الكتّان أو البولّيستر (خيوط البلاستيك)، ويتمّ نسجها في معامل عربيّة، أو حتّى آسيويّة مثل الصين، أو غربيّة مثل بريطانيا. أمّا القطن فهو في الأغلب من الهند ومصر.
ينقسم الشماغ باللغة السومريّة إلى مقطعين صوتيّين هما: اش- ماخ، وتعني غطاء الرأس. وهناك محاولات عديدة لتفسير النقش المزيّن للكوفيّة، ترجّح في أغلبها شطحاً شعريًّا، إذ يرى البعض أنّ تلك الخطوط والألوان قد استخدمت محاكاة لشبكات صيد السمك أو إلى سنبلة القمح والحنطة، أو حتّى لأقراص الشمع التي يصنعها النحل.
كوفيّة “أبو عمّار”

إنّ أشهر شخصيّة ارتدت الكوفيّة عبر التاريخ، حتّى تماهت به وتماهى بها، هو ياسر عرفات “أبو عمّار” (رئيس منظّمة التحرير الفلسطينيّة ثمّ رئيس السلطة الفلسطينيّة حتى تاريخ وفاته أو اغتياله في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004)، الذي ارتدى الكوفيّة بقرار، وليس لأنّها لباسه الطبيعيّ التقليديّ.
وربّما كانت لحظة الذروة حينما وقف “أبو عمّار” من على منبر الأمم المتّحدة في نيويورك، بكوفيّته المرتّبة بعناية على رأسه، قائلاً جملته الأشهر: “لقد جئت حاملاً غصن الزيتون في يد وفي الأخرى بندقيّة الثائر، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي”.
ربّما كانت لحظة الذروة حينما وقف “أبو عمّار” من على منبر الأمم المتّحدة، بكوفيّته، قائلاً جملته الأشهر: “لقد جئت حاملاً غصن الزيتون في يد وفي الأخرى بندقيّة الثائر، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي”.
بعد هزيمة العرب في العام 1967، لمَع نجم الفدائيّ، الملثّم بالكوفيّة، وصار الأمل المرتجى لاستعادة الأرض، فأصبحت تلك “الحطّة”، رفيقة كلّ مناصر لفلسطين، لتظهر على أكتاف الرؤساء، والمثقفين، والمغنّين، في أميركا اللاتينيّة، كما عند بعض مؤيّدي القضيّة، في ألمانيا واليابان، وغالبيّة البلدان الأفريقيّة التي وجدت رابطاً منطقيّاً بين عرفات والمناضل السجين نلسون مانديلّا، الذي ارتدى الكوفيّة الفلسطينيّة بعد خروجه من السجن، حاله حال الزعيم الكوبيّ كاسترو، وربّما “غيفارا” الذي كان قد زار غزّة في العام 1959.
كوفيّة بتوقيع عزيز بكّاوي
مع سطوع نجم الكوفيّة، بتلك النقوش المبنيّة على تقاطع الخطوط، المتوَّجة بالنقاط السوداء، جرى التعامل معها كهويّة متجاوِزَة لغايتها الأولى، كوشاح وقاية أو حاجة بيئيّة، فتمّ رسم الكوفيّة في اللوحات وعلى الجدران، كذلك تحوَّلت إلى وشم على الأجساد، ونقش على الأكواب، والأظافر، وإلى تطريز في الثياب. وأضحت ربطة عنق، وقبّعة، وشالاً، وجلدة ساعة يدّ، بل وقاء للتنفّس في فترة جائحة كورونا.
هكذا غدت الكوفيّة جزءاً من كلّ زيّ ينجزه المصمّم المغربيّ (الهولنديّ) عزيز بكّاوي، الذي اكتسب شهرة عالميّة، تحديداً من خلال اعتماده هذا “الرمز” الفلسطينيّ، الضارب في عمق التاريخ. الجميل في الأمر، أنّ المصمّم بكاوي اعتمد الكوفيّة للسبب عينه، وليس لأنّه مفتتن بالسطح البصريّ لتلك العلامة.

في حوار صحفيّ معه، يشرح بكّاوي الأبعاد والمسوّغات التي انطلق منها في إنجاز تصاميمه: “كنت ولا أزال مغرماً بالصناعة التقليديّة. من أين يأتي الشيء؟ وكيف ولماذا صنع؟ من جهة أخرى، أيّ قطعة نسيج ليست مجرّد قطعة، بل هي تحكي حكاية. فالأنسجة بدون قصّة وتاريخ هي فارغة وبلا روح وبلا أهمّيّة. هي يمكن أن تحكي تاريخاً مباشراً، وتعوّض عن ألف كلمة”.
ويتابع: الكوفيّة قطعة قماش تتواصل وتقول لنا أشياء من قرون مضت، تحكي مقاومة الشعب الفلسطينيّ. قطعة النسيج هذه لها سلطة كبرى مرتبطة بالعادات والحِرف التقليديّة. قمت بأبحاث عن الكوفيّة، وأعدت صنعها بمعيّة متحف النسيج في هولندا. نسجنا منها عدداً من الأثواب، خيطاً بخيط، من الكشمير والصوف، حسب العادات والخبرة، وكأنّنا ننسج قصيدة”.
للكوفيّة قصائد وأغنيات
كثيرة هي القصائد التي تضمّنت مقاطع خاصّة بالكوفيّة، من محمود درويش وسميح القاسم (الفلسطينيّين)، إلى طلال حيدر (البعلبكيّ) الذي كتب بـ”العامّيّة” اللبنانيّة البدويّة:
“لبسوا الكفافي ومشوا…
وما عرفت مينن هنّ..
ما عاد رح يرجعوا
يا قلب حاجي تعنّ”.
القصيدة التي غنّتها أميمة الخليل من ألحان مرسيل خليفة. وهناك العشرات من الأغنيّات الثوريّة، وحتّى الرومانسيّة، مبنيّة على الكوفيّة، كرمز نضاليّ، ناضح بالقوّة والأصالة، والغموض، بل والنقد، كما هو الحال مع مغنّية الراب الفلسطينيّة شادية منصور، التي خصّصت أغنية للكوفيّة. أمّا فنان “عرب آيدول” الفلسطينيّ محمّد عسّاف، فقد غنّى “علّي الكوفيّة علّي، ولولح فيها”، لتصبح في مدّة وجيزة جزءاً من الفلكلور الفلسطينيّ، فتحضر في الأعراس والاحتفالات الشعبيّة.
عمق التاريخ وفضاء التأويل
تشقّ الكوفيّة طريقها نحو بناء سلوك في اللباس، لتكون بذاتها علَماَ بديلاً، وكانت كذلك في فلسطين المحتلّة بعد العام 1967، حين أصدر الاحتلال قانوناً يجرّم رفع العلم الفلسطينيّ، فكانت الكوفيّة خير بديل، لتتحوّل إلى فعل يسخر من جميع قوانين المنع.
والمستغرب أنّ أمراً مشابهاً يحصل بعد أكثر من خمسين عاماً، في نيويورك أكبر ولايات أميركا، وفي مؤسّسة متخصّصة بالمزادات الفنّيّة، لتكون لوحات أيمن بعلبكي، عنواناً عريضاً للمعنى الحقيقيّ للحرّيّات التي راكمها الغرب، كـ”سلاح حضاريّ” في مقابل بلدان ثانية، توصَف بكمّ الأفواه، وضيق الأفق، فيمنعها.

في التضامن الشعبيّ الدوليّ مع غزّة، التي تتعرّض وأهلها لحرب إسرائيليّة و”عالميّة” مدمّرة، عادت الكوفيّة الفلسطينيّة لتظهر في ساحات باريس ولندن ومدن أميركيّة وبريطانيّة وفرنسيّة وغيرها، بالرغم من قرارات المنع والحظر، في تظاهرات مناهضة لقتل الأطفال والنساء والأهالي العزّل، ولوقف إطلاق النار الفوري ودعم غزّة الفلسطينيّة وناسها.
في جوهر الطرح السيميائيّ نجد أنفسنا أمام فرصة لمعاينة السلوكيّات كافّة، التي تعتمدها الجماعات، من شعائر، وألبسة، ورقصات، وفنون شعبيّة وأمثال، لتكون بذاتها مسباراً جوّالاً، من عمق التاريخ، نحو فضاءات التأويل. والكوفيّة كانت وستبقى عنواناً للدرس، مع أساتذة مثل الانثروبولوجيّ تيد سويدنبرغ، والمؤرّخة جين تاينان، والباحثة آنو لينغالا التي ألّفت كتاباً يحمل عنوان “تاريخ الكوفيّة الاجتماعيّ والسياسيّ”.