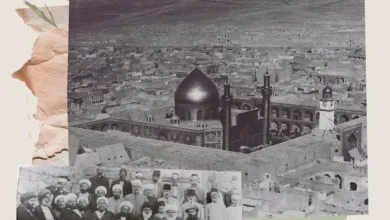طانيوس شاهين يروي لحسان الزين لماذا استحق كل ذلك
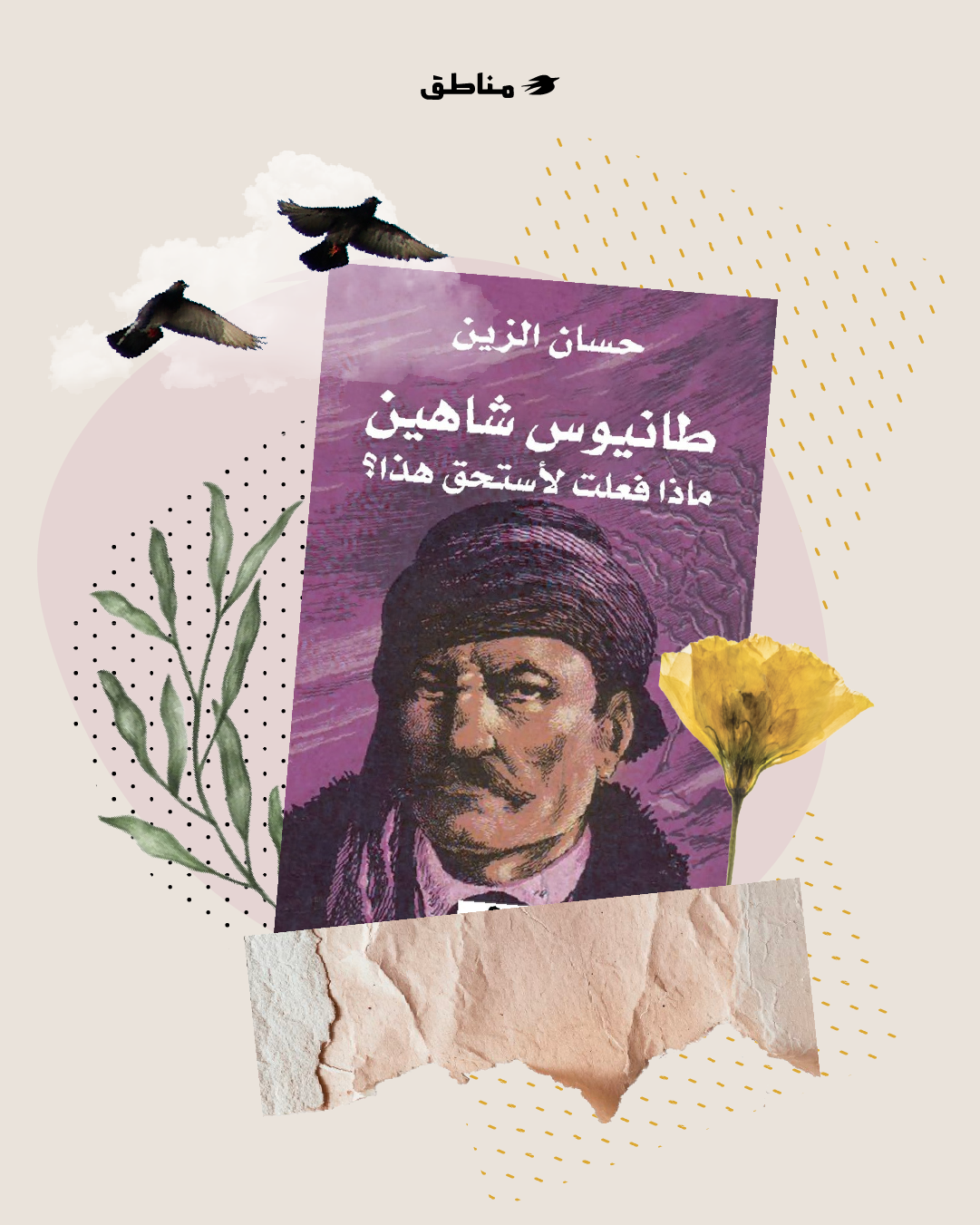
من النهاية يبدأ الكاتب والباحث اللبناني حسان الزين سرد حكاية طانيوس شاهين سعادة الرَّيفوني (1815-1895) قائد ما يُعرف بثورة الفلاحين (1858-1860) التي أسقطت حكم آل الخازن في بلاد كسروان، أي من حيث تراجع نفوذه وخسر سلطته و”جمهوريّته” على يد القائمقام يوسف بك كرم (1823-1889) الذي أحرق داره في “ريفون” واعتقل عدداً من رجاله بعد معركةٍ شرسة.
منطلقاً من سؤالٍ مرسلٍ على لسانِ بطل قصّته وراويها: “ماذا فعلتُ لأستحق هذا؟” -وهو عنوان الرواية الصادرة مؤخراً (تشرين الأول/أكتوبر 2025) في بيروت عن دار رياض الريس للكتب والنشر- يعود الزين بنا إلى البداية المتواضعة للشخصيّة التي ساهمت في رسم فصلٍ بارزٍ وإشكاليٍّ من تاريخ لبنان أواسط القرن التاسع عشر.
لم يولد طانيوس شاهين في بيت زعامة، ولا ورثها أباً عن جد، فهو ابن شاهين سعادة، حدّاد ومكاريٌّ بسيط قُتل مسموماً على يد أحد مشايخ آل الخازن بعد أن اتّهمه الأخير بالتقليل من احترامه. هكذا نشأ طانيوس يتيماً، وكبر معه حقدٌ دفينٌ على آل الخازن خصوصاً والإقطاعيين عموماً، حقدٌ ساهم لاحقاً في تحويله قائداً للفلّاحين الغاضبين الذين نجحوا في إسقاط حكم آل الخازن ونهب بيوتهم وممتلكاتهم وتهجيرهم مؤقّتاً إلى بيروت، وهي سابقةٌ لم تتكرر في تاريخ جبل لبنان.
ورث شاهين مهنةَ أبيه المكاريّ فأتقنها وطوّرها ولكنه لم يرضَ بها قدراً، فقد رأى في نفسه ما يجعلهُ مستحقّاً لما هو أكثر، ومن هنا كانت مناطحته للإقطاعيين خليطاً من الحقد والغضب
أوّل ما يلفتُ القارئ في الرّواية التي تمزج الذاتيّ بالعام والخياليّ بالتأريخيّ هو اللغة التي كتبت بها، فقد اختار الزين أن يسرد بلغةٍ مبتكرةٍ هي أقرب للفصحى “الملبننة”، تذكّرنا بعربيّة الوثائق القديمة المحفوظة في بعض أديرة جبل لبنان. وهو إذ يستخدمها إمعاناً في الواقعيّة وللدلالة على جانبٍ من شخصيّة “شاهين” الذي يصفه المؤرّخ كمال الصليبي (1929-2011) بأنه “شبه متعلّم”، فإنه من ناحيةٍ أخرى يشكّل من خلالها معجماً غنيّاً بالمصطلحات العاميّة من جبل لبنان تلك الفترة، وهي كلمات ما زال كثيرٌ منها حاضراً في اللهجة اللبنانية المعاصرة، وإن كان يسهل -نظريّاً- على القارئ اللبنانيّ فهمها فقد ترك الزين هوامش تسهّل على القارئ العربيّ فكَّ شيفراتها.
بالإضافة للّغة، حضرت الأمثال العاميّة اللبنانية بكثافةٍ بين سطور الرواية، حيث لا تكاد تخلو صفحةٌ من مثلٍ عاميٍّ أو قولٍ مأثور، بدءاً من عناوين الفصول السبعة وهي على التوالي: “ما في شي بيدوم”، “النفس مطرحها ولو شح زادها”، “لا بيرحموك ولا بيخلوا الله يرحمك”، “إجاك مين يعرفك يا بلّوط”، “الأرض محلّفة لا بتشرب دم ولا بتكتم سر”، “من هالك لمالك لقبّاض الرّواح” و”تيتي تيتي”، كأنَّ حياة شاهين تجري على سننٍ تداولتها الألسن أمثالاً فأضحت مصائر.
يبدو طانيوس شاهين في رواية الزين رجلاً قويّاً وذكيّاً وعنيداً وطموحاً ذا بطشٍ ولسان، أحبّه العامّة والفقراء ووثقوا به، ورث مهنةَ أبيه المكاريّ فأتقنها وطوّرها ولكنه لم يرضَ بها قدراً، فقد رأى في نفسه ما يجعلهُ مستحقّاً لما هو أكثر، ومن هنا كانت مناطحته للإقطاعيين خليطاً من الحقد والغضب والشعور بالاستحقاق والرغبة بالمساواة، في زمنٍ كانت الحدود بين الطبقات صارمة، وكانت أيُّ محاولةٍ للتلميح إلى فكرة المساواةِ مغامرةً قد تنتهي بمقتل صاحبها، وهو المصير الذي لقيه والد طانيوس نفسه كما أسلفنا.
استحقَّ طانيوس شاهين ما وقع عليه في النهاية لأنّه عبّر عن وعيٍ بالهويّة اللبنانيّة التي لم يرق لأيٍّ من الأطراف استحضارها في غير السّياق الذي رسمته لها المصالحُ الخارجيّة
تسلّط الرواية الضوء على فترةٍ شديدة الاضطراب من تاريخ لبنان، حيث أدّت الصراعات المتأجّجة بين المسيحيين والدّروز في جبل لبنان أواسط القرن التاسع عشر، إلى تقسيم الجبل لمنطقتيّ حكم (قائمقاميّتين) واحدةٌ للمسيحيين وأخرى للدّروز، فيما أصبحت السلطنة العثمانيّة تسمّى “رجل أوروبا المريض” وتغوّلت “الدول الفخيمة” -وهو اللقب الذي يصف به شاهين الدول الأوروبيّة في الرواية- فأصبح قناصلها “يحلّون ويربطون” في مصائر أهل الجبل الذين توزّعت ولاءاتهم بين فرنسا التي دعمت الموارنة وبريطانيا التي دعمت الدروز والنمسا حامية الكاثوليك وروسيا حامية الأرثوذكس، من غير أن ننسى “الأراتقة” (الهراطقة) وهو اللقب الذي خص به بطل الرواية المبشّرين البروتستانت الآتين من أميركا وبريطانيا، فتحوّل جبل لبنان بمساحته الجغرافية الضيّقة وتضاريسه الصّعبة وقلّة محاصيله، ساحة صراعٍ بين كلِّ هذه الدول مجتمعةً ومتفرّقة، وأصبحت طوائفه بزعاماتها وعامتها بيادق تحرّكها مصالح الدول الكبرى، ولا يخفى ما في هذا الوصف من إسقاطٍ على واقعنا الحاليّ الذي لم يتغيّر كثيراً منذ ذلك الزمن.
في هذا الخضمِّ المتلاطم بدت ثورة الفلّاحين التي قادها طانيوس -بشكلٍ ما- حركةً محليّة، تعبّرُ بالدرجة الأولى عن صوتِ النّاس المسحوقين، ما جعلها على طرف النقيض من كلِّ هذه الدول والزعامات التي -وللمفارقة- توحّدت لإجهاضها بشتّى الطّرق ونجحت أخيراً في ذلك.
وربّما تكون هذه إجابة السؤال/العنوان، فقد استحقَّ طانيوس شاهين ما وقع عليه في النهاية لأنّه عبّر عن وعيٍ بالهويّة اللبنانيّة التي لم يرق لأيٍّ من الأطراف استحضارها في غير السّياق الذي رسمته لها المصالحُ الخارجيّة.
يحاول حسّان الزين في روايته هذه إعادة اكتشاف طانيوس شاهين من غير أن يجمّله أو يغفل الجوانب “السلبيّة” لشخصيّته وحركته، معتمداً على المصادر التاريخيّة تارةً وطوراً على خيال الروائي، يفتح له مجالاً للاسترسال في سرد وجهة نظره من غير أن يطلق عليه حكماً نهائيّاً قاطعاً، تاركاً للقارئ من حيث أتى الحكم على هذه التجربة سلباً أو إيجاباً، ثمَّ يردف “ملحق معلومات” يبدو أن غايته لم تكن التوضيح فحسب بل الإشارة أيضاً إلى وجهات نظرٍ أخرى مختلفة، وفيما تعزّز الهوامش حضور المؤرّخ، تخفّف منه اللغة المبتكرة والنزعة الحسيّة لصالح النفس الروائيّ، فتنتج كتاباً ممتعاً وغنيّاً ومختلفاً عن أعمالٍ كثيرةٍ تناولت سيرة “شيخ الشّباب” وتجربته الفريدة.