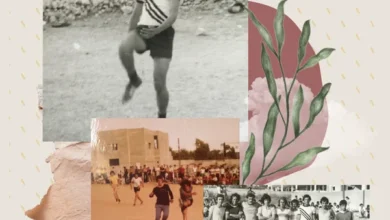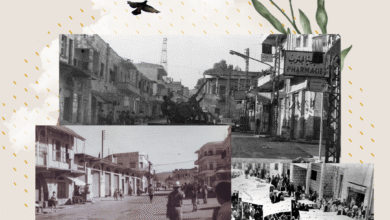عمود بعلبك السابع المتخيّل والمتشبّه به (2)

خلافًا لمدن لبنانيّة كثيرة، ثمّة مدخل رئيس إلى مدينة بعلبك من الجهة الجنوبيّة، يسلكه جميع من يقصدها، وذلك في حال عدم متابعة سيره شمالًا، في اتّجاه البقاع الشماليّ، وصولًا إلى مدينة حمص السوريّة. المدخل الآخر، من الجهة الشماليّة، هو أشبه بمخرج، ولا تنطبق عليه مواصفات المدخل الأوّل، الذي يُظهر وجه المدينة، فالمدخل الشماليّ محاط بمنازل بناها الوافدون الجدد إلى المدينة عشوائيًّا، من دون الأخذ في الاعتبار أيّ تنظيم عمرانيّ، كما تسير الأمور عادة، في منطقة لا يشكّل القانون فيها مادّة تحُترم ويُعمل على أساسها.
هذا التفصيل، الذي لا بدّ منه، يُعتبر ضروريًّا من أجل تبيان أهمّيّة المدخل الجنوبيّ، القديم العهد قياسًا مع قرينه، إذ إنّ من يسلكه لا بدّ من أن تنتصب أمام ناظريه أعمدة معبد جوبّيتير الستّة الشهيرة. كان البناء ممنوعًا لجهة المعابد اليسرى، من أجل عدم حجب هذه الإطلالة. قانون آخر جرى تخطّيه بوقاحة مشهودة، إذ شُيّدت العمارات السكنيّة والتجاريّة، وأكثرها شديد الارتفاع نسبيًّا، بحيث شكّلت سورًا إسمنتيًّا بشعًا. لم تعد تُرى الهياكل سوى قبل بضعة أمتار من الوصول إليها، وأوّل ما يُرى الأعمدة الستّة المذكورة، وكأنّ ما يحيط بها ويجاورها يبدو غير ذي أهمّيّة، من الناحية البصريّة وليس التاريخيّة بالطبع.
كما ذكرنا، في الجزء الأوّل من مقالتنا، أنّ الأعمدة الستّة صارت وجهًا من وجوه المدينة، وحتّى من وجوه البلد، ونما رابط ما بين الاثنين. لكنّ مسألة العظمة، المحيطة بما بقي من آثار بعلبك الرومانيّة، وبالأعمدة المذكورة بالذات، انتقل إلى مجالات الأدب والشعر، وإلى محافل أخرى أيضًا.

العمود السابع خليل مطران
أقامت “ندوة الخميس” البعلبكيّة، التي كانت للمرحوم والدي يد طولى في تسيير أمورها، وكان مفعمًا بحيويّة لافتة، لم تنتقل بكلّ ثقلها إلينا للأسف، نقول إنّ الندوة كانت قد أقامت، نهاية صيف العام 1972، احتفالًا جماهيريًّا لافتًا في سينما الشمس ببعلبك (انتهى عهد السينما المذكورة منذ عقود، وتحوّلت قاعتها إلى متجر لبيع الثياب)، وكان الاحتفال مكرّسًا لإحياء ذكرى 100 عام على ولادة شاعر القطرين خليل مطران (1872- 1949)، ابن بعلبك. وتناوب الخطباء على المنبر، مشيدين بصفات الشاعر المعروف، الذي ما زال البيت الذي رأى النور فيه قائمًا في بعلبك، واختتم الحفل بقصيدة للشاعر سعيد عقل، بدأها بالأبيات الآتية:
ما الموت شمخةُ رأسٍ منك تفتقدُ
واسلم بباقةِ شعرٍ عطرها الأبدُ
مهابةُ الأرزِ بنتُ الفارسيّ أنا
نبكيك، فلتتغاوى الستةُ العُمدُ
ومن ترى قال ليست سبعة
أنا، أنا ذا عينيّ إليك، أفلا يكمل العدد؟
من النافل الحديث عن الأثر الذي تركته القصيدة في نفوس الحاضرين. أبيات صارت من التاريخ، وصار وقعها أكبر مع مرور الوقت، وبخاصة لكون عائلة مطران، إحدى أشهر العائلات المسيحيّة البعلبكيّة، لم يبقَ أحد من أفرادها في المدينة.
لحظة مجازيّة
وبالعودة إلى القصيدة، نرى أنّ خليل مطران صار بمثابة العمود السابع. لحظة مجازيّة ربّما تكون الأولى في مجال الشعر ذي العلاقة بآثار بعلبك، وربّما سبقتها تشابيه أخرى، لكنّها تندرج ضمن تلك السلسلة من الاستعارات التي لم تقتصر على أبيات سعيد عقل، بل صارت نوعًا من “الكليشّيه” الذي يتمّ اللجوء إليه، من خلال الحديث العاديّ، أو في احتفالات مختلفة يتمّ فيها لصق صفة العمود السابع على أحدهم بهدف التفخيم المشتقّ من القيمة المادّيّة التي تمثّلها الأعمدة الستّة.
خليل مطران صار بمثابة العمود السابع. لحظة مجازيّة ربّما تكون الأولى في مجال الشعر ذي العلاقة بآثار بعلبك
نحن، إذًا، في صدد تشبيه من هو حيّ، أو راحل، أيّ جسد بيولوجيّ، بما هو جامد ولا حياة فيه: الحجر. هذا الأمر يطرح إشكاليّة من دون شكّ، علمًا أنّه ليس الأوّل في هذا المجال. فكم من مرّة جرى تشبيه أحدهم بالصخرة الصامدة مثلًا، أو بجذع شجرة، أو بجبل شامخ. لكنّ المفارقة تكمن في أنّ أعمدة معبد جوبّيتير الباقية بعد أهوال الطبيعة وأفعالها المدمّرة، لم تكن يومًا سبعة، بل هي انتقلت من عددها الكامل (54) إلى تسعة، إلى أن أطاح زلزال الـ 1759 بثلاثة منها. لم يعد في وسعنا سوى أن ننصح بتشبيه شخصيّات ثلاث معًا، في الوقت نفسه، وبشكل متزامن، بالأعمدة الثلاثة المتهاوية، على ما في هذه النصيحة من طرافة، وبعض من المزاح، وذلك في حال لجوئنا إلى المنطق التاريخيّ بشكل صحيح.
الأعمدة الستّة بالحديث الشعبيّ
والمقصود هنا اللغة الشعبيّة البعلبكية تحديدًا، وارتباطها، في بعض الأحيان بـ “القلعة” (كنّا قد ذكرنا سابقًا تحفّظنا على هذه التسمية). ففي حين أراد البعلبكيّون، مثلًا، التعبير عن متانة شيء وصلابته، مهما كان نوعه، وخصوصًا في مجال البناء أو سواه، قالوا “متل القلعة”. ذكر لي أحد الأصدقاء أنّه كان في بعلبك في الأيّام الغابرة فريق رياضيّ لكرة اليدّ، وقد أطلقت على أفراده تسمية “العواميد الستّة”، علمًا أن مستوى الفريق لم يكن على تلك الدرجة من الاحترافيّة، التي تتميّز بها المنتخبات الكبرى.
أمّا من كانت أحواله جيّدة، أو ثريًّا، أو كُتب له التوفيق في صفقة ما، تجاريّة أكانت أو سرّيّة وغامضة تسرّبت أخبارها إلى العامّة، فقد كان يُقال عنه: “بيتو براس القلعة”، بما معناه ليس في مكان مرتفع وحسب، بل وكأنّ منزله مختلف عن سواه، وذلك يشير عمليًّا إلى أحواله الجيّدة، وحتّى الممتازة، قياسًا بمن تقع منازلهم، أيّ أوضاعهم، في منطقة منخفضة. ولطالما فرّق العرف الشعبيّ بين من يقع منزله في مكان مرتفع، لكونه يطّل على مشهد مميّز، وبين من يقع منزله في القعر، حيث لا يرى سوى جدران البناء، فكيف بك إذا قيل عن أحدهم إنّ مسكنه يشبه القبو، لتظهر حينها مقولة أخرى تحمل طرفًا من الإهانة، إذ يقال حينها: “متل يلّي عايش بالقبر”.
في أدب الشتيمة
لم يقتصر اللجوء إلى الأعمدة الستّة، أو “القلعة” من أجل تفخيم أحدهم، بل ربّما يتحوّل الأمر إلى شتيمة. هذا النوع من الشتائم يقتصر، غالبًا، على المراهقين، أو أولئك الذين لم يبلغوا سنّ المراهقة، إذ من شأن شتائم من هذا النوع، إذا ما لجأ إليها الكبار، أن تؤدّي إلى “مجزرة”، في منطقة يتعامل بعض أفرادها “القبضايات” مع بعضهم الآخر كما الديكة (الديوك)، بحسب ما قاله أحد أصحابنا المتفاكهون.
فحين يقول مراهق لآخر: “لأعمل بأمّك عراس ستّ عواميد القلعة”، أو “لإدحش عامود القلعة بـ… أمّك”، تضيع المسبّة، شديدة الثقل، مثل سواها من تعابير المراهقة وممارساتها، في حقل اللامبالاة، في عالم الأطفال الكبار، الذي لا يقيم وزنًا كبيرًا لمسألة الشرف والعرض، فالشتيمة قد تقابلها شتيمة أخرى أقوى منها وأشد وقعًا، في حال وجودها، وينتهي الأمر عند هذا الحدّ.
ولكي نكون أقرب إلى الحقيقة والواقع، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ ما ورد ذكره من شتائم وإهانات، صار وكأنّه من الماضي، واقتصر على بعض أفراد جيلنا الخبثاء. كان ذاك الجيل، وبغياب وسائل التسلية المتوافرة حاليًّا، شديد الابتكار. هذا الميل إلى الابتكار انسحب على مسائل كثيرة، ومن ضمنها الألعاب شديدة التنوّع والشتائم كذلك.