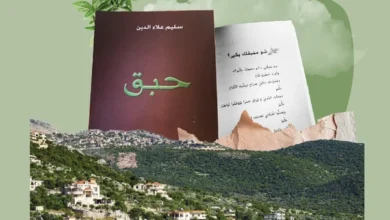فأل خير ونذير شؤم حيوانات وحكايات ترسم أقدارنا!

أن تصادف قطّة سوداء في الليل، يعني أنّك تقف أمام الجنّ وجهًا لوجه في سكون المساء. سلاحك الوحيد لسان يلهج بالبسملة والعوذلة. تعيش صدمتكَ وتغيّر طريقك لتمشي بخطىً متسارعة، لاعنًا حظّك الذي قهرك بمصادفة محمّلة بالفأل السيّء.
إلى يومنا هذا، هناك من يعتقد بالشرور المختزنة في القطط السوداء، وغيرها من الحيوانات والحشرات والأشياء، فهل هناك ما هو أكثر شؤمًا من فتح مظلّة داخل المنزل؟ أو مشاهدة مقصّ مفتوح؟ هي وغيرها من العناصر والأفعال، تشكّل بذاتها قاموسًا سيميائيًّا (علم الرموز والدلالات)، يتغيّر بنسبة بسيطة أو عالية، بين بلد وآخر، أو داخل البلد نفسه، بين سكّان السواحل والجبال. لكنّنا لا نتكلم عن ماضٍ مضى، بقدر ما نتوقّف عند كثير من تلك القناعات التي ورثها هذا الجيل، فيتفاعل معها كحقائق، على الرغم من كثرة الشهادات العلميّة المعلّقة على الجدران.
الأمر وجدانيّ، ملتصق بتربية الأهل، وتأثير المجتمع، ولذلك تبقى تلك المعتقدات راسخة في الدماغ، بنسب متفاوتة، ومتضائلة بين سكّان الأرياف، وسكّان المدن.
سلحفاة تطيل أعمارنا
في الحكايات الشعبيّة تمتزج الوصايا والحكايا والخرافات، بوقائع الحياة كشكل ضروريّ في الأزمنة التي تشكّلت بها، إذ إنّ كلّ فعل من أفعال الطبيعة، يحمل إشارات سحريّة، غير مفهومة المنابع، ولا آليات التحريك، فلا يفقه المرء العلاقة بين الزيت والنار المتولّد منه، أو الغصن اليابس الذي يفاجئنا بأوراق خضراء تضجّ بالحياة. وقتذاك، كانت الأدمغة تبحث عن إجابات لكلّ ذلك، عبر اختلاق تفاسير مرتجلة، نابعة من ذات الفعل، وخصائص الكائن الذي نقوم بتأطيره، كأن تنظر الشعوب إلى السلحفاة على أنّها حيوان جالب للحظّ، كونها تتمتعّ بعمر مديد، يفوق الـ70 سنة، وكأنّها بعمرها الطويل تمنح سكّان البيت روحها، فتزداد سنوات إضافيّة في أعمارهم.

كذلك يتعامل سكّان القرى مع بيوت العناكب في زوايا الجدران، على أنّها نذير شؤم، فهذه الخيوط المتدلّية (المشنشلة) لا يمكن أن تتكاثر، وتتشابك لولا موت سكّان هذا البيت، والدليل بقاؤها في أماكنها إلى وقت طويل دون إزالتها من قبل أصحاب المنزل.
شؤم البومة
منذ سنوات قليلة، بدأ الناس بالتصالح مع البومة، وتبرأتها ضمنًا من تهمة جلب الشؤم لمن يراها، مباشرة أو في رسم أو صورة، أو حتى في حال لفظ اسمها. اليوم تحوّلت البومة إلى وشوم على الأجساد، ورسم ملوّن على الحقائب المدرسيّة، وهناك من اقتناها في منزله، قبل أن يعلم أنّ القانون يجرّم هذا الفعل.
نعرف أنّ البومة في بعض التعريفات والتصنيفات، ينظر إليها كطائر حكيم، وهو ما ترمز إليه السلحفاة، وفي بعض الأماكن تعتبر الحيّة (الأفعى)، حيوانًا حكيمًا كذلك. أمّا أصل الشؤم الملتصق بالبومة فسببه سكنها في المنازل، والقرى التي هجرها أصحابها، حتّى ظنّ من رآها أنّها هي من فعلت ذلك بالبيوت وقاطنيها.

غراب وحمامة
الغراب رمز الشؤم الأشهر، انطلاقًا من فشله في المهمّة التي كلّفه بها النبي نوح، حينما أرسله لتقصّي امكانيّة وجود اليابسة وقت الطوفان، فذهب ولم يرجع، على عكس الحمامة التي عادت وفي منقارها غصن الزيتون، ويكون الغصن بشرى خير، وهو ما رسمه الفنّان العالمي بابلو بيكاسو في أحد المؤتمرات الدوليّة عن السلام، لافتًا النظر إلى تلك الرمزيّة، التي تلقّفها العالم، لتصبح الحمامة رمزًا للسلام.
والمفارقة أنّ الجميع يرسمونها بيضاء اللون، بينما النصوص القديمة لم تشر إلى لونها، فيكون تفسير الأمر بتناقض الأبيض مع لون الغراب الأسود، وهو خطّ من تناقضات كثيرة بين الفاتح والقاتم، المحمّل بالتمييز لصالح الأبيض، بكلّ ما في الأمر من عنصريّة.
إذا عدنا للحمامة والرمزيّة تختزنها، لا يمكننا تجاوز “سلحتها” (روثها) التي يُنظر إليها شعبيًّا على أنّها فأل خير، خصوصًا حين تلطّخ رأس البشريّ العابر أو ثيابه، ولا يعرف ما الذي سيسقط عليه من السماء. يعتبرونها خيرًا ورزقًا، مثل المطر.
الغراب رمز الشؤم الأشهر، انطلاقًا من فشله في المهمّة التي كلّفه بها النبي نوح، حينما أرسله لتقصّي امكانيّة وجود اليابسة وقت الطوفان، فذهب ولم يرجع، على عكس الحمامة
فراشة وعنكبوت
يتّفق الجميع على جماليّة الفراشة، ورمزيّتها المتقاطعة مع الزهر والربيع، كأنّها روح الطبيعة الحيّة، لكنّها عندما تدخل إلى البيت، يتعامل معها سكّانه، على أنّها روح الفقيد الذي كان يقطن المكان، أو ربّما هي روح أحد الاقارب. هكذا يتحلّق حولها الجميع، كأنّهم يتعبّدون لها، أو له، الحبيب الذي فارق البيت، وها هو يطلّ زائرًا على هيئة فراشة.
في الأمر بعدٌ نفسيّ، مسكّن لأوجاع الفقد. يصدّقون ما يعتقدونه، لأنّه يمنحهم الأمل بحضور الفقيد، بل والاطمئنان على مصيره في العالم الآخر، والدليل تحوّله إلى فراشة، وليس إلى حشرة سيّئة مثل الصرصار والعنكبوت، مثلًّا. وهذا الأخير يرمز إلى الخير عند بعض المتديّنين، كونهم يطّلعون على قصة اختباء الرسول في الغار، ودور شباء العنكبوت عند بابه، بأن المكان مقفر بلا سكّان، وهو الفعل الذي انطلى على أعداء النبيّ فغادروا المكان بخفّي حُنين.
نجاسة أبو بريص
في القرى يتناقلون حكايات كثيرة عن الخلد والحيّة والعقرب، وذلك النوع المذموم من السحالي التي تسكن أسقف البيوت وجدرانها، ألا وهو الوزغ (أبو بريص)، “النجس”، الذي ينبت له ذيل بديل في حال قُطع ذيله. علمًا أنّ الوزغ ليس نجس في الأحكام الدينيّة، كون دمه لا يسيل، مثل الأفعى والسمكة.
التمييز حاضر في نظرتنا للسحالي أيضًا، إذ نشأنا على تقبّل “الشمّوسة” تلك السحليّة الخضراء، التي قيل لنا في زمن الطفولة، إنّها تحمل مفتاح الجنّة، بينما ترمز إلى سيف الإمام عليّ، في حركة لسانها يمينًا أو يسارًا لتشبه “ذو الفقار”. أمّا الحرذون الذي يجمد لوقت طويل، ثم يحرّك رقبته صعودًا ونزولًا، فيقال في ثقافات البعض إنّه يؤدّي صلاة بحركته تلك.

إضافة إلى “أبو بريص”، النجاسة حكم دينيّ إسلامي، يلازم الكلب أو فمه على وجه التحديد، ليتمّ إعفاء كلب الصيد من هذا الوصف، كونه حاجة وضرورة تعين الصيّاد على بلوغ صيده البعيد، أو المتغلغل في عشب شائك بين الصخور.
أسطورة الضبع
لا ينافس الحيّة على المركز الأوّل، من ناحية كمّ الحكايات التي يتناقلها سكّان الأرياف سوى الضبع، الذي تتكرّر قصّته أو فعلته في كلّ قرية أو بقعة، بصفته ساحرًا يستخدم بوله وذيله لتخدير ضحاياه من البشر، فيسيطر عليهم ويدغدغهم حتى تخور قواهم، فيلتهمهم أحياء. ها هو سلام الراسي، كبير مؤرّخي الأدب الشعبيّ، يحكي عن الضبع، انطلاقًا ممّن روى له من سكّان القرى التي كان يغرف منها الحكايات والاساطير:
“يقول الحاج داود نصور إنّ عين الضبع تشعّ في الليل مثل سراج زيت الحلو، فيها مغناطيس عجيب يسيطر بواسطته على إرادة الرجل فيحمله إلى مغارته وهناك يبدأ بزكزكته فيأخذ الرجل بالضحك. إحدى هوايات الضبع: الزكزكة أيّ الدغدغة- فقد حمل الضبع إلى مغارته ولدًا من قرية الحاج داود لحق به ذووه فأدركوه يكاد يموت من الضحك بين يديّ الضبع- وبعد أن يتنهنه الرجل من الضحك يبدأ الضبع بالتهامه حيًّا. هذا دليل على قلّة دين الضبع، لأنّ سائر الوحوش تقتل فرائسها من نحورها قبل مباشرة أكلها- تمامًا كما يفعل الانسان عندما يذبح الشاة من نحرها قبل أكلها- لذلك تعتبر أسوأ النهايات، نهاية رجل بين يدي الضبع، ولذلك أيضًا يقال في بعض الأحوال “ياكلها السبع ولا ياكلها الضبع”.
حكايات يكتبها الزمن
يذهب العقل البشريّ دائمًا إلى ملء فراغات الأشياء بالمعنى، واضعًا لها تفسيرًا وتعليلًا يستريح إليه ويطمئنّ، والرمز لا بدّ من أن يتمتّع بحال من الاستقرار في فكر الجماعة، كما أشارت الدكتورة نبيلة إبراهيم (1929- 2017) كاتبة وأكّاديميّة ومترجمة مصريّة، تعدّ من أبرز المتخصّصين في الثقافة الشعبيّة والفلكلور.
وإلّا فقد الرمز أهمّيّته ومفعوله، لينتهي مع مرور الزمن. من هنا، ندرك المسار التاريخيّ للخرافة، التي يعزّزها الناس، جيلًا بعد جيل، لتصبح يقينًا لا يقبل الجدال، غير أنّ الحداثة، وسطوة مدن اليوم على الأرياف، حدَّت من عمليّة تمّدد تلك المعتقدات غير المستندة إلى دراسات، أو دلائل، ومع ذلك لم تنقرض تلك المعتقدات بشكل كلّيّ، خصوصًا في الأرياف.