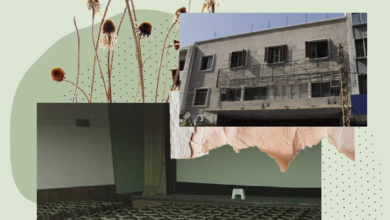“فرقيع” ببيروت و”فتّيش” في الجنوب حينما يزغرد البارود للعيد

كنّا ننتظر العيد كما ينتظر المنفى يومًا غائمًا. كنّا نهيّئ له جيوبنا الصغيرة، ونوايانا الطيّبة، وكأنّ الفرح فعلٌ يحتاج إلى التواطؤ. في طفولتنا لم يكن الاستثناء رفاهًا، بل قانونًا موقّتًا نحتكم إليه مرّات قليلة في السنة. بين ضجيج الأحذية الجديدة ورائحة الحلوى المصنّعة، كانت ثمّة طقوس أخرى، لا علاقة لها بالمائدة، بل بما يحدث في الشارع، وعلى الأرصفة، وتحت الشرفات.
في بيروت، كنّا نسمّيها “فرقيع”، وفي الجنوب “فتّيش”، وكان الاسم يحمل النكهة المحلّيّة لما هو مستورد من بلادٍ لا نعرفها، نثق بها فقط لأنّ ألعابها تفرقع. لم تكن تلك الألعاب مجرّد لهو، بل إثبات وجود في زمنٍ لم نكن نملك فيه شيئًا سوى لحظات نختبر فيها سلطة الصوت على الفراغ.
اللافت أنّ الفرح كان مجّانيًّا. يشتري أحدنا العلبة، ونصطفّ جميعًا حوله ككهنة لطفولة ساذجة. ننتظر لحظة إشعال الفتيل، تلك الثانية المعلّقة بين الفعل والنتيجة. هو وحده من يقرّر: أن يرميها في الوقت المناسب، أو يتأخّر لحظة فيغدو العيد تذكارًا لإصبع محروق. العجائز كنّ يشتمن بصوتٍ خافت، أصحاب الدكاكين يغلقون آذانهم بنظرات ضجر، ونحن نواصل، لأنّ الدويّ كان وسيلة بدائية كي نقول إنّنا أحياء، وإنّنا نستطيع، بمحطات قليلة في العام، أن نربك النظام، ونشوّش على ممالك الكبار.
لم نكن نعرف وقتها أنّ الفرح محفوف دائمًا بالمخاطر. وأنّ كلّ “دوبامين” (هرمون) في أجسادنا الصغيرة كان يستند إلى احتمال الألم. لكنّنا كبشر لا نختبر الحياة إلّا حينما تدنو أصابعنا من النار. “ومن لا يفرقع، لا يعرف العيد حقًّا”، كما يقول رفيقنا المشاغب.

صوت الحرب بقبضة طفل
لا شكّ في أنّ “الفرقيع” في زمن الحرب اللبنانيّة لم يكن مجرّد لعبة. بين عامي 1975 و1990، اكتسب بُعدًا سيكولوجيًّا مشحونًا، صار صدىً صغيرًا لانفجارات كبرى. الأطفال، وسط الخراب، لم يكونوا محصّنين من رماد القنابل، بل امتصّوه وراحوا يعيدون إنتاجه على مقاساتهم. في الشوارع المحطّمة، كانوا يُشعلون فتائلهم الصغيرة لا للفرح، بل لمحاكاة صورة “البطل” التي بثّتها الحرب في وعيهم: رجل ميليشيا مسلّح، جسده مرسوم بالوشم، وشعره مصفّف كأبطال أفلام أميركيّة لم يشاهدوها أصلًا، بل تسلّلت إليهم عبر صور وملصقات.
كانت تلك الانفجارات الصبيانيّة انعكاسًا مرضيًّا لزمن مريض. لعبٌ مشوّه، يسكنه الحنين العنيف إلى سلطةٍ ما، إلى دورٍ ما، وإلى صوتٍ أقوى من صمت الملجأ وأصوات النشرات. وربّما لهذا السبب لم يكن “الفرقيع” أداة احتفال بقدر ما كان محاكاة رمزيّة للفوضى، ومرآة مشقّقة لأطفالٍ لم يُمنحوا رفاهيّة أن يكونوا مجرّد أطفال.
ذاكرة لا تنام
تحوّلات كثيرة حدثت بعد تلك الأيّام، وحروبٌ أكثر، جاءت بإيقاعات متقطّعة كأنّها ارتجافات جسدٍ لا يُشفى: تمّوز (يوليو) 1993، نيسان (أبريل) 1996، فحرب تمّوز 2006، ثمّ الحرب الكبرى الأخيرة، تلك التي لم يلتئم جرحها بعد. البيوت المهدّمة ما زالت كأنّها تفتح أفواهها على العدم، الدكاكين المغلقة لم تُبعث من جديد، والوجوه المفقودة لا تزال عالقة في ما يشبه الظلّ. ثمّة جثث تحت الركام وأخرى مجهولة الأثر.
صار كلّ صوتٍ قويّ إنذارًا. لم يعد دويّ المفرقعات لعبة. صار احتمال غارة أو قصف أو فعل اغتيال من مسيّرة خفيّة. الأعصاب المشدودة التي تراكمت عبر العقود لم تعد تحتمل تلك الأصوات “البريئة” التي صارت تشبه الموت. المفرقعات لم تعد تفرح، بل تبثّ قلقًا جماعيًّا يزحف في الأزقّة والأحياء كما في الأجهزة العصبيّة.
ومثلما تتعلّم المجتمعات أنّ الخطر ليس فقط ما يُقال، بل ما يُتذكّر، بدأت بعض البلديّات — كبلديّة معركة مثلًا — ترفض هذا النوع من الطقوس العنيفة، وتحذّر منها. لأنّ الصوت، الذي كان يومًا صدىً للفرح، صار في الذاكرة صدىً للخراب. والذاكرة حينما تُخدش مرارًا لا تعود تنسى… بل تنفجر بصمت.
لم يعد دويّ المفرقعات لعبة. صار احتمال غارة أو قصف أو فعل اغتيال من مسيّرة خفيّة. الأعصاب المشدودة التي تراكمت عبر العقود لم تعد تحتمل تلك الأصوات “البريئة” التي صارت تشبه الموت.
حينما يغدو الفرح خطرًا
المستجدّ الفعليّ، الذي يمكن اعتباره نقلة في طبيعة الضجيج، كان في دخول المفرقعات الناريّة الليليّة إلى المشهد. لم تعد تُطلق كفعل عبثيّ فرديّ، بل كطقس جماعيّ منظّم، يستمدّ أثره من العتمة، من المفارقة بين السواد والانفجار، بين الصمت والتوهّج. لم تعد مفرقعات، بل عرض ضوء وصوت يفرض حضوره كضرورة رمزيّة في كلّ مناسبة على نحو عودة الحجاج، افتتاح المتاجر، الأعراس وأعياد الميلاد، إلى ظهور نتائج الشهادات، وكأنّ لكلّ حدث صوتًا صارخًا لا يكتمل بدونه.
لكنّ خلف هذا الابهار المُفتعل، يرتجف الجهاز العصبيّ بصمت. الأعصاب التي لم تعد تميّز بين انفجار واحتفال تبدأ بالتآكل. الصوت الذي كان مجرّد إعلان فرح، أصبح اقتحامًا. والنفوس التي جُرِّبت طويلًا بالصدمات لم تعد تملك القدرة على الفصل بين المناسبات.
كأنّ الفرح نفسه تحوّل إلى قصف ملوّن، إلى مشهديّة تتطلّب عنفًا ضوئيًّا وصوتيًّا لكي تُصدَّق. وتحت هذا العنف المكرّس، تنهار أشياء دقيقة في الداخل: نظام النوم، هدوء المساء، طمأنينة العابرين. ويصير الحزن أكثر لطفًا من الفرح، لأنّه، على الأقل، لا يطلق نارًا في الليل.
من طرد الأرواح إلى استدعاء الفزع
من المفارقات التي يصعب تجاهلها أنّ هذه الأصوات التي تثير فينا القلق اليوم، وُلدت قبل قرون بعيدة في الصين القديمة، لا كوسيلة إزعاج، بل كأداة لدرء الأرواح الشرّيرة وجلب الحظّ. اخترعها الصينيّون في القرن السابع، ببراءة غريزيّة تربط الضوء بالحماية، والانفجار بالنجاة. ومن هناك، عبرت القارّات، تسلّلت إلى أوروبّا كزخرفة مدهشة، وإلى العالم العربي كأزهار ناريّة تسكن المخطوطات، حتّى غدت طقسًا عالميًّا.
لكنّها لم تصل إلينا بريئة، وصلت متعبة، مُحمّلة بإرث البارود وبقايا الحرب، وبدل أن تتولّى تطرد الأرواح الشريرة، صار الناس يهربون منها كأنّها أرواح الحرب نفسها تعود وتقرع أبوابهم من جديد. كلّ ومضة ضوء الآن تفتح جرحًا بصريًّا، وكلّ دويّ قصير يوقظ ألف ذاكرة مدفونة في الركام.
ذاكرة الصوت والخوف
ربّما لم تكن المشكلة في المفرقعات عينها، بل في ما صرنا نحمله نحن من ذاكرة. فالصوت واحد، لكنّ الأذن تغيّرت، القلب تغيّر، العالم نفسه تبدّل، ولم يعد يحتمل فرحًا صاخبًا، ولا حتّى احتفالًا بريئًا. صار كلّ شيء معلّقًا على حافّة الخوف، وكلّ لحظة نشوة محتملة مشروطة بالانتباه والتوجّس.
لا أحد يفرح بحرّيّة، لا أحد يضحك دون أن يلتفت. كأنّنا بتنا نحتاج إلى إذنٍ نفسيّ لنفرح، وهدنة داخليّة قصيرة كي نفتح نافذة ونقول: العيد هنا. لكن حتّى العيد صار يأتي خائفًا، و”الفرقيع”، الذي كان مرآة صاخبة لطفولتنا، صار مرآة مشروخة لزمنٍ لا يعرف كيف يفرح، ولا كيف يصمت.