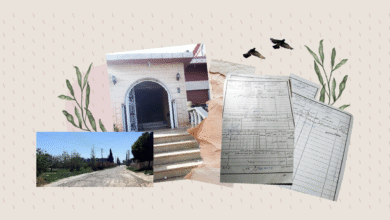في حضرة القهوة تبدأ الحكايات ولا تنتهي

ثمّة لحظات لا تحتاج إلى كثير من الكلام… لحظة الصباح الأولى، حين تعبق رائحة القهوة في المكان، تشقّ طريقها بهدوء لتوقظ الحواس، وتُعلن بداية يوم جديد. القهوة ليست مشروبًا عابرًا يُحتسى على عجل؛ هي طقس صغير يسبق زحمة النهار، ورفيقة قديمة تحفظ أسرارنا في عمق كل رشفة. في كل فنجان، نكهة تعبٍ طويل، ورحلة بذورٍ حملها الزمن من أرض بعيدة حتى وصلت إلى هذا الفنجان بين أيدينا. منذ قرون، لم تكن القهوة مجرّد مشروب صباحي، بل كانت تُباع كدواء في الصيدليات، توصف لعلاج التعب والصداع، وتُقدّم كسرٍ دفين من الشفاء في فنجان صغير.
خذ رشفة الآن… ولنبدأ الحكاية من أولها.
حين قادت عنزة الطريق إلى القهوة
لم يكن يدري أن خروجه في ذلك الصباح سيقوده إلى واحدٍ من أعظم الاكتشافات في تاريخ البشرية. لم يكن نبيًّا ولا عالمًا، بل راعيًا بسيطًا يُدعى كالدي، يرعى قطيعه بين مرتفعات إثيوبيا الوعرة. لكنّ ما شاهده في ذلك اليوم غيّر كل شيء.
وقف يتأمّل قطيعه بدهشة، إذ راحت العنزات تقفز وتعدو بنشاط غير مألوف. لم تهدأ لحظة، وكأنها أصيبت بمسّ من الجنون. اقترب منها ليرى ما يحدث، فاكتشف أنها كانت تلتهم ثمارًا حمراء من شجيرة صغيرة. استبد به الفضول، فجمع شيئًا من تلك الحبوب وتذوّقها. وسرعان ما شعر بدفقة من النشاط تسري في جسده، كأن يقظته كانت نائمة منذ دهور.

لم يحتفظ كالدي بالاكتشاف لنفسه. قصد ديرًا قريبًا ليخبر أحد الرهبان بما رآه وشعر به. لكنّ الراهب ارتاب في تلك الحبوب الحمراء، ورأى فيها عملًا من أعمال الشيطان، فألقى بها في النار. غير أن النيران لم تكن متواطئة مع الشك. إذ ما إن احترقت الحبوب حتى انبعث منها عطرٌ غامض، دافئ، بدا أشبه بنداء خفيّ من السماء.
فزع الرهبان من خطئهم، فانتشلوا ما بقي من الحبوب بين الجمر، سحقوها، وسكبوا فوقها الماء الساخن لحفظها. وما إن ارتشفوا الشراب الداكن حتى تبدّد الشك. لم يكن مجرّد شراب، بل رفيقٌ للوعي. ساعدهم على السهر خلال صلواتهم الليلية، وغدا منذ تلك اللحظة مصدر قوة داخل جدران الدير الباردة. ومن هناك بدأت الرحلة الطويلة لمشروبٍ سيغزو العالم. لكن، هل هذه القصة حقيقية؟ أم مجرّد أسطورةٍ جميلة صاغتها الذاكرة الشعبية؟
قد لا نعرف الجواب بدقة. لكن ما هو شبه مؤكّد أن أصول القهوة من أرض إثيوبيا، وتحديدًا بين قبائل الأورومو، حيث استُخدمت حبوبها بطرق بدائية، قبل أن تعبر البحر إلى اليمن، وتُزرع هناك لأول مرة بشكل منظم.
القصة بدأت من عنزة… لكنّها لم تتوقف عند حدود الجبال
لم تبقَ القهوة حبيسة الجبال الإثيوبية طويلاً، فقد عبرت طرق التجارة القديمة البحر الأحمر لتصل إلى اليمن في القرن الخامس عشر، حيث وجدت ظروفًا مثالية للنمو. بدأت القهوة في اليمن كبذور تُجلب عبر التبادل التجاري، والصوفيين الذين أدركوا فائدتها زرعوها في المرتفعات اليمنية الوعرة، التي تميزت بتربتها الخصبة ومناخها المعتدل.
كانت القهوة تُزرع في مساحات صغيرة، وكانت محصورة بين فئات معينة، خاصة الصوفيين الذين استخدموا مشروب القهوة كمساعد للسهر في عباداتهم الطويلة
في البداية، كانت القهوة تُزرع في مساحات صغيرة، وكانت محصورة بين فئات معينة، خاصة الصوفيين الذين استخدموا مشروب القهوة كمساعد للسهر في عباداتهم الطويلة. مع مرور الوقت، توسّعت زراعتها وأصبحت نشاطًا زراعيًا منظّمًا، يُدرّ دخلاً مهمًا للسكان المحليين.
مع توسّع زراعة القهوة في المرتفعات اليمنية وازدياد الإقبال عليها، لم تعد محصورة في الاستخدام الصوفي أو الأسواق المحلية. بدأ اليمنيون يدركون أن في هذه الحبوب الصغيرة كنزًا اقتصاديًا، فسعوا إلى تنظيم تجارتها بشكل احترافي. كان ميناء المخا بوابة هذه المرحلة، حيث تحوّل إلى المركز الأساسي لتصدير القهوة إلى الخارج، ومنها إلى مدن الحجاز أولًا، وتحديدًا مكة التي كانت تستقبل الحجاج من كل أصقاع العالم الإسلامي.
بحلول القرن السادس عشر، كانت القهوة قد بلغت القاهرة ودمشق، وشيئًا فشيئًا وصلت إلى اسطنبول، قلب الإمبراطورية العثمانية، التي استقبلتها بحفاوة. تبنّاها الناس سريعًا، وبدأت تظهر أولى المقاهي، ليس كمجرد أماكن لشرب القهوة، بل كمجالس فكر وأدب، ونقاش سياسي وروحي. كانت المقاهي في اسطنبول تُعرف بـ”مدارس بلا معلمين”، وجذبت المفكرين والعامة على حد سواء.
بالتزامن، فرض اليمنيون نظامًا صارمًا لحماية مصدرهم الثمين، منعوا تصدير البذور القابلة للزراعة، فكانت الحبوب تُحمّص أو تُغلى قبل شحنها. وبهذا، حافظ اليمن على احتكاره العالمي للقهوة لأكثر من قرنين.

القهوة وصلت الى اسطنبول
في منتصف القرن السادس عشر، وصلت القهوة إلى إسطنبول، وكانت المدينة على موعد مع تحول جديد في حياتها اليومية. كانت البداية في عام 1555، حين افتتح تاجرَان من دمشق أول مقهى في العاصمة العثمانية، بعد أن جلبا حبوب البن من اليمن عبر البحر الأحمر.
سرعان ما أصبحت القهوة مشروبًا شائعًا في المدينة، لا تقتصر على البلاط العثماني أو الطبقات العليا، بل امتدت إلى الشوارع والأسواق، وظهرت المقاهي في الأحياء واحدة تلو الأخرى. وبحلول نهاية القرن، كان في إسطنبول أعداد كبيرة من المقاهي، يرتادها الناس من مختلف الطبقات الاجتماعية.
لم تكن المقاهي مكانًا لشرب القهوة فقط، بل تحوّلت إلى فضاء جديد للتواصل والتبادل. فيها تُتداول الأخبار، وتُناقش السياسات، وتُلعب الألعاب، وتُروى الحكايات. كان الناس يرتادونها يوميًا، يجلسون لساعات، يتحدثون، يختلفون، ثم يعودون في اليوم التالي.
جاء القرار الحاسم في عهد السلطان مراد الرابع إذ أصدر قرارًا بمنع شرب القهوة، إلى جانب التبغ والأفيون، وفرض عقوبات قاسية وصلت إلى الإعدام
لكن هذا الانتشار الواسع لم يكن مريحًا للجميع. مع الوقت، بدأت بعض الجهات الدينية تعترض على انتشار القهوة والمقاهي، واعتُبرت القهوة شرابًا مشبوهًا بسبب تأثيرها المنشّط. ازدادت الشكوك حين بدأت بعض النقاشات السياسية تظهر داخل المقاهي، واعتبرتها السلطات مكانًا محتملًا لزرع الفتنة أو التحريض.
منع شرب القهوة
وجاء القرار الحاسم في عهد السلطان مراد الرابع إذ أصدر قرارًا بمنع شرب القهوة، إلى جانب التبغ والأفيون، وفرض عقوبات قاسية وصلت إلى الإعدام. يُقال إن السلطان نفسه كان يتنكر في زي رجل من العامة، ويتجوّل في شوارع إسطنبول ليراقب المخالفين، ويعاقبهم بنفسه.
لكن الحظر لم يدم طويلًا. أثار القرار جدلًا واسعًا، وواجه معارضة كبيرة من العلماء والمثقفين وحتى من بعض رجال الدين. من أبرز المدافعين عن القهوة كان الشيخ بستان زاده محمد أفندي، أحد كبار علماء الدولة العثمانية، الذي كتب قصيدة كاملة دفاعًا عن القهوة، رافضًا تحريمها، ومعتبرًا أنها ليست أكثر من مشروب يرافق الفكر والحوار.
أمام الضغط الشعبي والديني، تراجعت السلطة عن قرار المنع، وعادت القهوة إلى المقاهي والبيوت. ومنذ ذلك الوقت، أصبحت جزءًا من الحياة اليومية في إسطنبول، لا تفارق المجالس ولا الأحاديث.
القهوة لم تعد مجرد عادة جديدة بل أصبحت جزءًا من هوية المدينة. ومع مرور الوقت، بدأ تأثيرها يتجاوز حدود إسطنبول، متجهًا نحو عواصم جديدة.
كيف اجتاحت القهوة العالم؟
بعد أن رسخت القهوة مكانتها في إسطنبول، بدأت رحلتها الكبرى نحو أوروبا في منتصف القرن السابع عشر، حاملة معها عبق الشرق ونكهة جديدة غيرت من عادات الناس وطريقة اجتماعهم.
وصلت القهوة عبر طرق التجارة البحرية، تحديدًا من موانئ البحر المتوسط مثل فينيسيا، حيث تعرف الأوروبيون لأول مرة على هذا المشروب الداكن والغامض الذي لم يكونوا معتادين عليه. لم يكن شرب القهوة في البداية أمرًا شائعًا في البيوت الأوروبية، بل كان يُستهلك في الأماكن العامة، في المقاهي التي بدأت تنتشر تدريجيًا في المدن الكبرى.
لم تكن المقاهي مجرد أماكن لتناول مشروب ساخن، بل تحوّلت إلى فضاءات اجتماعية جديدة، تجمع الناس من مختلف الطبقات والمهن. هنا، كان بإمكان التاجر أن يلتقي بالأديب، والمفكّر أن يناقش السياسة مع رجل الحرف، بعيدًا عن صخب الأسواق أو تقاليد اللقاءات الرسمية.
في تلك الأوقات، لم يكن للمقهى في أوروبا مكان في الحياة المنزلية، إذ كان يعتبر مشروبًا خاصًا بالخروج واللقاء. هذا ما جعل المقاهي تتحول إلى ما يشبه “المجالس المفتوحة”، حيث الأفكار تنتشر، والحوارات تشعل الحماسة، وتُولد الحركات الثقافية والسياسية الجديدة.
حبوب عابرة للقارات
مع توسع نطاق التجارة الدولية، وتطور الاستعمار الأوروبي، بدأت شتلات البن تُنقل من الشرق إلى المستعمرات الأوروبية في آسيا وأميركا. زُرعت أولى مزارع البن في جزر الكاريبي وجنوب وأميركا، حيث كان المناخ مناسبًا. وهكذا، لم تعد القهوة سلعة مستوردة فحسب، بل تحولت إلى محصول زراعي عالمي، يدير تجّارها شبكات ضخمة من الإنتاج والتوزيع.
على مدى قرنين، أصبحت القهوة مشروبًا لا غنى عنه في أوروبا، ورافقها ظهور مقاهي جديدة في مدن مثل لندن وباريس وميونيخ، فشكّلت جزءًا من نسيج الحياة الاجتماعية والثقافية.
في لبنان، القهوة ليست مجرّد مشروب صباحي، بل جزء من الإيقاع اليومي، وعلامة ترحيب لا تغيب عن أي بيت
اليوم، لا تزال تلك الروح في كل فنجان، تذكرنا بأيام بدأت فيها حبة صغيرة من البن، لكنها مع الوقت غيرت من طقوسنا وأسلوب حياتنا، من شرق البحر المتوسط إلى كل بقاع الأرض.
التبصير بالقهوة: قراءة للغيب أم ترجمة للرغبة؟
إلى جانب انتشارها كمشروب اجتماعي وروحي، حملت القهوة في بعض المجتمعات بعدًا آخر أكثر غموضًا، تمثّل في التبصير عبر فنجان القهوة، وهي عادة ظهرت في القرن السادس عشر داخل الإمبراطورية العثمانية، غالبًا في أوساط الحريم، ثم انتشرت لاحقًا في مدن بلاد الشام والبلقان. تعرف هذه الممارسة في تركيا باسم “قهفة فالي”، وقد ترسّخت كطقس شعبي يعتمد على تأويل الأشكال التي تتركها الرواسب في قاع الفنجان بعد شرب القهوة غير المصفّاة.
مع مرور الزمن، نشأت رموز شبه مستقرة داخل هذا التقليد: ظهور شكل السمكة يُفسَّر على أنه بشارة رزق أو حظ؛ القلب يدل غالبًا على قصة عاطفية أو علاقة قادمة؛ طريق طويل ملتف يُشير إلى سفر أو انتظار أو عرقلة؛ الثعبان يُرتبط بالخيانة أو الخطر من شخص قريب؛ أما الطائر فيُقرأ عادةً كإشارة إلى خبر مفاجئ أو تغيير قريب. لم تكن هذه الرموز مجرد أدوات تسلية، بل كانت تُستعمل أحيانًا لتفسير الواقع أو تمنياته.
ورغم تغيّر الزمن، لم تنقرض هذه العادة. فلا تزال حتى اليوم حاضرة في كثير من القرى والبلدات اللبنانية، تمارسها نساء من مختلف الأعمار، وبعضهن يُعرفن في محيطهن بقدراتهن الخاصة في قراءة الفنجان. بل إن هناك من يربط مستقبله بما يُقال له في جلسة التبصير، ويأخذ من إشارات الفنجان قرارات صغيرة أو كبيرة. وهذا ما يُفسّر الأثر النفسي العميق الذي تتركه هذه التجربة لدى البعض، إذ يتحوّل الفنجان أحيانًا إلى مرآة خيالية تُؤثّر على المزاج والتفكير وحتى الخيارات الشخصية، رغم أن ما يُقال فيه لا يستند إلى أي دليل منطقي أو علمي. وبين الاعتقاد والتسلية، يبقى التبصير بالفنجان تقليدًا حيًّا يُمارَس في السر والعلن، ويشكّل جزءًا من الذاكرة الثقافية المرتبطة بالقهوة، في لبنان والعالم العربي.

في فنجان القهوة اللبنانيّة تختتم الحكاية
في لبنان، القهوة ليست مجرّد مشروب صباحي، بل جزء من الإيقاع اليومي، وعلامة ترحيب لا تغيب عن أي بيت. تُحضّر على مهل، وتُقدّم في كل مناسبة، وتُشرب بهدوء وكأنها استراحة قصيرة وسط تقلبات الحياة. من جلسات الفرح إلى لحظات العزاء، تبقى حاضرة، تُقال بها أشياء كثيرة دون كلمات.
تحضير القهوة في البيت اللبناني طقسٌ لا يُختَزل. تُعدّ بركوة من النحاس، مع ماء بارد وبنّ غالبًا ما يكون مع الهال، وتُغلى على نار هادئة. تُراقَب جيدًا وهي ترتفع بالرغوة، وتُرفع عن النار قبل أن تفور، وتُعاد مرّتين أو ثلاث حتى “تطبّ القهوة”. تُسكب ببطء في فنجان صغير لا يُملأ أبدًا حتى الحافة، احترامًا للتقليد.
تتنوع نكهات القهوة اللبنانية بحسب العادات المحلية. في الجبل مثلاً، تُشرب “سادة” أي مُرّة، بينما في بعض المناطق الساحلية تُقدَّم مُحلّات. بعض الناس يفضلونها “نص ونص” لا مرّة ولا حلوة بحسب الذوق الشخصي.
في المناسبات الحزينة، تُقدَّم القهوة مرّة بلا سكر، تعبيرًا عن الحزن، بينما في الأفراح تُقدَّم حلوة أحياناً، وكأنها تختصر مشاعر المناسبة. وحتى في حفلات الخطبة التقليدية، يُقدَّم فنجان القهوة كمقدّمة رمزية للقبول أو الرفض.
بين القهوة والمقهى
تاريخيًا، ارتبطت القهوة في لبنان بعادات الدولة العثمانية، لكنها مع الوقت أخذت مسارًا خاصًا. في بيروت تحديدًا، ظهرت مقاهٍ لعبت دورًا ثقافيًا مهمًا، أبرزها قهوة الروضة التي تأسست في عشرينيات القرن الماضي على كورنيش المنارة، وكانت ملتقى يوميًّا للكتّاب والصحافيين والطلاب. كما اشتهر مقهى الهورس شو الذي افتُتح عام 1959 في شارع الحمرا، وكان يُعتبر من أهم محطات اللقاءات الفكرية في المدينة.
وفي طرابلس وصيدا، كانت المقاهي الشعبية جزءًا من حياة الناس اليومية. فيها تُقرأ الصحف، وتُلعب “الطاولة”، وتُتناقل الأخبار، وتُقدَّم القهوة على الفحم أو الغاز، بلذة لا تنفصل عن صوت المدينة وروحها.
حتى في بلاد الاغتراب، ما زالت القهوة اللبنانية تحافظ على مكانتها. في مونتريال، ديترويت، برلين، وسيدني… ستجد دائمًا مطبخًا لبنانيًا يُعدّ فنجان قهوة على الركوة، بنفس الطريقة التي تُحضّر فيها في بيت الأجداد. وكأنها طريقة للحفاظ على ما تبقّى من ملامح الوطن في الغربة.
القهوة لم تعد مجرّد عادة يومية، بل صارت جزءًا من لغة الناس، وطريقتهم في التعبير والمشاركة. من فنجان إلى آخر، احتفظت بمكانتها، وتحوّلت إلى مساحة صغيرة للوقت والذوق والذاكرة.
وفي كل عام، في الأول من تشرين الأول، يُحتفل بـاليوم العالمي للقهوة. يوم رمزي، لكنه يذكّر بأن هذا المشروب، رغم بساطته، رافق العالم في أكثر من حكاية، وبقي حاضرًا في التفاصيل الكبيرة والصغيرة.