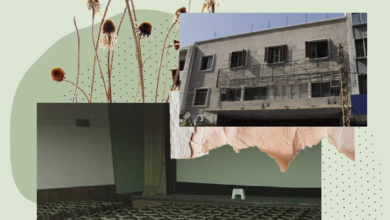قراءة في تاريخ علاقات رميش الحدوديّة والجليل الفلسطيني

تاريخيّة هي العلاقات التي جمعت بين بلدة رميش الجنوبيّة ومنطقة الجليل الفلسطينيّة، وتعود إلى منتصف القرن الثّامن عشر، وتحديدًا إلى ما بعد سنوات من استقرار “الرميشيّين” في بلدتهم، وتدشين كنيستهم، وصولًا إلى نكبة فلسطين العام 1948، ولم تقتصر على ناحية واحدة، بل شملت نواح عديدة منها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والتعليميّة.
زرع أهل رميش أرضهم لتأمين قوتهم، ثمّ اتجهوا بحكم الجغرافيا جنوبًا، بحثًا عمّا ينقُص لديهم، وذلك إلى مدن عكّا وحيفا في فلسطين، كونهما يمثّلان ثقلًا ديموغرافيًّا وقوّةً اقتصاديّة، وإلى قرى متاخمة لرميش، كونها تتماثل في ظروف الحياة والمناخ والسكن والمعيشة واللهجة والعادات والتقاليد والزَّيّ والمأكولات واحتفالات الزفاف وحتّى مراسم الجنازة، وقواسم مشتركة أُخرى جمعت سكّان طرفَي الحدود، أكثر من مائتي عام.
عندما يغضب الوالي
سياسيًّا، تُختصر علاقة رميش مع مدينة عكّا، مقرّ الوالي أحمد باشا، بسعيه الدائم للسيطرة عليها، وضمّها إلى منطقة نفوذه العسكريّ والسياسيّ، وهو ما ترجمه بهجومه عليها العام 1797، ما أدّى إلى تضرّر عدد من منازلها إضافة إلى كنيسة مار جرجس وإتلاف محتوياتها لا سيّما دفتر العماد الأوّل، وذلك حسبما كتَب الخوري جرجس الشوفانيّ في مقدّمة “سِجل العماد الجديد” الذي بدأ تحريره العام 1806، إِثر عودة الرميشيّين إلى بلدتهم وأعادوا ترميم كنيستهم.

أمّا عن أسباب هجوم الوالي، فيعود إلى تأييد الرميشيّين للأمراء الشهابيّين في صراعهم معه، وتقديمهم مساعدات عينيّة وغذائيّة إلى الجيش الفرنسيّ بقيادة نابّليون بونابّرت في أثناء حصاره عكّا، بالإضافة إلى خشية أحمد باشا من تمرّد رميش عليه باعتبارها من أكبر القرى في محيطها.
يصف الرحّالة روبنسون، الذي زار رميش في العام 1837 في طريقه إلى فلسطين، في كتابه “أبحاث الكتاب المقدّس في فلسطين والمناطق المجاورة”، الهجوم على رميش بأنّه كان خاطفًا بسبب رحيل الأهالي قُبيل الهجوم المتوقّع، وصُغر المساحة المسكونة في البلدة ما بين البركتين الشرقيّة والغربيّة، وقلّة عدد سكّانها البالغ 300 نسمة.
اشترط الوالي لتعيينه ضاهر الشوفاني، “شيخًا” على القرية، عودة الرميشيّين إلى بلدتهم ودفع الضرائب له. لكن يبدو أنّ الأهالي رفضوا هذا الشرط، وبالتالي قرّروا عدم العودة إلى بلدتهم المنكوبة، خِشيةً من نقض الوالي هذا الاتفاق، والإغارة مجدّدًا عليها، إلى أن عاد الرميشيّون إلى بلدتهم العام 1805، بالتزامن مع وفاة الوالي في العام نفسه.
التبادل التجاريّ
تعود العلاقات التجاريّة بين رميش وجوارها في الاتّجاهين اللبنانيّ والفلسطينيّ، إلى منتصف القرن الثامن عشر، وهي جاءت تلبيةً لحاجة السوق المحلّيّة على طرفَي الحدود والتي استمرّت حتّى النكبة العام 1948.
لقد احتلّت العلاقات التجاريّة بين رميش ومحيطها مكانة مهمّةً، لعدّة أسباب منها، علاقة حُسن الجوار التاريخيّة بين رميش ومعظم فلسطين لا سيّما حيفا، عكّا، صفد، كفربرعم، الجش، سحماتا، فسوطة، معليا، حرفيش، عبلين، عيلبون، الناصرة. ومنها القُرب الجغرافيّ وسهولة المواصلات سواء بالنّسبة للطّرقات أو الأوتوبيسات الّتي كانت تنطلق يوميًّا من كفربرعم، الّتي تبعُد عن رميش ثلاثة كيلومترات، ثمّ إلى باقي الجليل ذهابًا وإيّابًا.
لقد احتلّت العلاقات التجاريّة بين رميش ومحيطها مكانة مهمّةً، لعدّة أسباب منها، علاقة حُسن الجوار التاريخيّة بين رميش ومعظم فلسطين لا سيّما حيفا، عكّا، صفد، كفربرعم، الجش، سحماتا، فسوطة، معليا، حرفيش، عبلين، عيلبون، الناصرة
إضافة إلى حاجة السوق الفلسطينيّة للمنتوجات الزراعيّة الرميشيّة لا سيّما العنب والتين، وتهافُت التجّار الفلسطنيّين على شراء السلع اللبنانيّة عبر رميش بسبب تدنّي قيمة العملة اللبنانيّة في مقابل العملة الفلسطينيّة، وأيضًا تشجيع الانتداب البريطانيّ للتجارة مع الجوار الحدوديّ.
ازدهار مستدام
لعشرات السنين تحوّلت رميش إلى سوقٍ واسعة تلبّي حاجات التجّار، من السلع الرميشيّة واللبنانيّة، إلى المستوردة من أسواق بنت جبيل، صور، صيدا، بيروت، حيث توزّعت على السكّر والأرز والقمح والزّيت، إضافةً إلى التين الطّازج والمجفّف والعنب السلطيّ المحلّيّ. ووصلت هذه السلع إلى مختلف القرى الفلسطينيّة المتاخمة وإلى مناطق أخرى أكثر بُعدًا كقريتَي المغار وحرفيش، وصولًا إلى غزّة.
في المقابل فإنّ أهمّ مشتريات الرميشيّين من السلع الفلسطينيّة كانت الذرة البيضاء والصفراء والقمح والشعير والعدس والحلْبة، حيث كانت وسائل النقل حينذاك الحمير والبغال تنقل البضائع من وإلى رميش عبر طرق “المكاريّة”.
قارب عدد التجار في تلك الفترة السبعة، تملّكوا دكاكين في رميش. ويُذكر أنّ عددًا من الأفراد كانوا ينقلون السلع سالكين طرقًا وعرة بعيدًا عن أعين سلطات الانتداب البريطانيّ يحملونها على ظهورهم كسبًا للعيش. وقد استمرّت تلك الظّاهرة بعد النكبة عدّة سنوات، وقضى عدد منهم خلال عبورهم الحدود، وفي داخل الأراضي الفلسطينيّة.

وقد تداول الرميشيّون غالبًا، تجّارًا ومواطنين، في عمليّات البيع والشراء الليرتين اللبنانيّة والفلسطينيّة معًا حتّى عام النكبة، ثمّ جرى التداول لاحقًا بالليرتين اللبنانيّة والسوريّة. ومن ثم مالوا أُسوةً بالجوار، إلى التداول بالعملة الفلسطينيّة، بسبب ارتفاع قيمتها الشرائيّة مقابل العملتين اللبنانيّة والسوريّة، إذ ساوت كلّ ليرة فلسطينيّة أربعين ليرة لبنانيّة آنذاك، وبسبب حجم التبادل التجاريّ الكبير بين رميش والجوار الفلسطينيّ.
نكبة فلسطين والتحوّلات الكبرى
لقد أدّى إقفال الحدود اللبنانيّة مع فلسطين غداة النكبة العام 1948 إلى اتّجاه الحركة التجاريّة الرميشيّة نحو المناطق اللبنانيّة، بخاصّة أسواق بنت جبيل وصور وبيروت، وقد ساهم هذا الواقع التجاريّ المستجِد في تزايد العلاقات الاقتصاديّة بين رميش ومدينة بنت جبيل التي تبعُد عنها 10 كيلومترات، وأصبحت بديلًا طبيعيًّا من فقدان السوق الفلسطينيّة، وقد أمّنت مختلف حاجيّات الرميشيّين كالأقمشة السوريّة، البرتقال، المواشي، اللّحوم، الأعلاف، الخضار، الأحذية، الثّياب، الحبوب كالسكّر والأرز، والمعلّبات، الطّحين والشاي، والتين المجفّف والعنب والصبّار.
يُشار إلى أنّ معظم عمليّات البيع والشراء كانت تتمّ إمّا من خلال المقايضة أو الدّفع نقدًا بالليرة اللبنانيّة، وبالجملة والمفرّق، في حين شكّلت بيروت مصدرًا لشراء سلعٍ أُخرى يحتاجها المزارعون كخيطان “المصّيص”، والأقمشة والثّياب ومواد عديدة تعتبر من الكماليّات. وأمّا المعدّات الميكانيكيّة والآلات فكانت من مدينتي صور وصيدا.
وإلى ذلك، استفاد تجّار بنت جبيل من إغلاق الحدود فبادروا إلى عرض سلعهم في رميش ذاتها من خلال ما عُرف “بسوق الحارة” وهي سوق شعبيّة، تُقام في باحة كنيسة مار جرجس، يوم الأحد من كلّ أسبوع، ومنها الثياب النسائيّة والرجّاليّة والولّاديّة والجوارب والزنانير وأدوات الزينة وألعاب الأطفال…
التعليم والعمل
لم تنحصر العلاقة بين الرميشيّين وفلسطين بالتجارة والاقتصاد، بل تعدّتها إلى نواحٍ أخرى منها الثقافة والتعليم، والأخير تمثّل بتبادل التلامذة الرميشيّين والفلسطينيّين، العلم في مدارسها، تبعًا للظروف، فكانت مدارس الجليل قِبلة أنظار الرّميشيّين قبل النّكبة، خصوصًا الرّاغبين في تعليم أولادهم وفق المنهج الإنكليزيّ، لا سيّما في صفد وسعسع وكفربرعم، وذلك إبتداءً من العام 1870 حتّى النّكبة، وقد أجاد هؤلاء التلامذة اللّغة الإنكليزيّة.

يُشار إلى أنّ المدارس الرميشيّة بعد الانتداب الفرنسيّ، كانت تعتمد اللّغة الفرنسيّة كلغة أجنبيّة، لكن شجّع انتظام التدريس، وحسن الأبنية المدرسيّة في فلسطين، التلامذة الرميشيّين الميسورين، على الالتحاق بهذه المدارس، لمتابعة دراستهم بسبب توقّف التدريس فترات عديدة وتردّي المباني المخصّصة للمدارس الرميشيّة، كحال حوالي عشرين تلميذًا التحقوا بمدرسة الرّاهبات في صفد، الّتي تبعُد عن رميش مسير ثلاث ساعات بواسطة الحصان، والّتي تُعتبر الأقرب نسبيًّا إلى رميش. ومن أبرزهم، فارس ضاهر الشوفاني، رئيس القلم في محكمة تبنين والشاعر أسعد فارس الشوفاني.
إضافة إلى التعليم، عمل عشرات الرميشيّين منذ مطلع القرن العشرين في المدن الفلسطينيّة المجاورة حتى انتهاء الانتداب البريطانيّ، لا سيّما في مدينة حيفا، الّتي أقام فيها عددٌ من العائلات، عاد معظمها إلى البلدة، عقْب النكبة، باستثناء ثلاث عائلات نزحت بعد ذلك بسنوات.
من خلال إقامتهم في حيفا، امتهن الرميشيّون الخدمات الفندقيّة والبلديّة والميكانيك والبترول في المدينة. أمّا ما دفع الرميشيّين إلى العمل في هذه القطاعات فهو تردّي العمل الزراعيّ لا سيّما زراعة التبغ وتدنّي أسعاره، وتراجع زراعة بساتين الكرمة جرّاء انتشار مرض “الرمد” الذي فتك بغالبيّة المساحات في حيّ الكروم، وأيضًا انخفاض مردود الأشجار المثمرة كالزيتون والتين، وبسبب ارتفاع قيمة العملة الفلسطينيّة المرتبطة بالجنيه الإسترليني، إذ بلغت قيمة كلّ ليرة فلسطينيّة أربعين ليرة لبنانيّة.
الفلسطينيّون في رميش
بعد احتلال فلسطين، استضافت رميش في العام 1948 قسمًا من اللّاجئين من الجليل جرّاء الأحداث الدامية التي وقعت هناك، حيث بلغ عددهم حوالي 1500 نسمة ينتمون إلى عدّة قرى أهمّها كفربرعم، الجش، سحماتا، دير القاسي، سعسع، صفد، فسوطة والبقَيْعة. وقطنوا فور وصولهم الخيَم في أحياء البيادر، تين السفرجل، والعقبيّة، وفي بناء تابع لوقف كنيسة مار جرجس.
بعد احتلال فلسطين، استضافت رميش في العام 1948 قسمًا من اللّاجئين من الجليل جرّاء الأحداث الدامية التي وقعت هناك، حيث بلغ عددهم حوالي 1500 نسمة
كما استضافت العائلات الرميشيّة عددًا من أُسرهم الّتي تجمعها بهم صلات قربى ونسب وعلاقات اجتماعيّة، وقلّةً منها استأجر غرفًا للسكن بأجرٍ شهريّ قدره 10 ليرات لبنانيّة. يُشار هنا إلى أنّ جموعًا أُخرى من الجليل الأعلى من مختلف الطّوائف مرّت برميش إلى قرى لبنانيّة أخرى وفق توجيهات السلطات اللبنانيّة.
اندمج الفلسطينيّون في رميش في مختلف نواحي الحياة، فأدّى تهافتهم على العمل إلى انخفاض أجر العامل اليوميّ من أربع ليرات إلى ليرتين، وإلى عمل معظمهم بالمياومة في الزراعة والخدمات الأُخرى. وساهم بعض الرياضيّين منهم، اللذين لعبوا في الأندية الرياضيّة في حيفا سابقًا، في إنشاء وتدريب فِرق “رميشيّة” لكرة القدم، كفِرق الكتائب – الأحرار – الاتّحاد. وقد نُظّمت مباريات أسبوعيّة في ما بينها، في رميش ومع فِرق البلدات اللبنانيّة المجاورة.
وقد افتَتحت البعثة البابويّة في لبنان بتوجيه من البابا بيوس الثّاني عشر، خريف العام 1949 أوّل مدرسة ابتدائيّة للّاجئين الفلسطنيّين في رميش، ضمن مبنى للوقف غربيّ كنيسة مار جرجس، واستمرّت في العمل حتّى العام 1955، وضَمّت حوالي سبعين تلميذًا، توزّعوا على ستة صفوف، وزادت نسبة نجاحهم عن تسعين بالمئة.
درّس في تلك المدرسة معلّمون فلسطينيّون هم فريد الخوري وإبراهيم فرحات من قرية كفربرعم، وأندراوس صرّوع ومنصور زكريّا. كما درّس فيها، الأستاذ جريس اجريس من رميش. وقد أدارها الخوري يوسف الخوري نائب مطران صور للطّائفة المارونيّة، وهي الأولى الّتي علّمت اللغة الإنكليزيّة في رميش، وضمّت تلامذة رميشيّين أيضًا.

درّست المدرسة اللغة الإنكليزيّة، في حين كانت المدارس في البلدة تعتمد اللغة الفرنسيّة، كلغّة أجنبية، تماشيًا مع الانتداب الفرنسيّ على لبنان، أُسوةً بمدارس في صفد وكفربرعم. وقد أُلزم التلميذ لاحقًا دفع نصف ليرة لبنانيّة مساهمةً في القسط السنويّ لتغطية أجور المعلّمين التي بلغت ثلاثين ليرة لبنانيّة شهريًّا لكلّ معلّم.
اللّجوء الثاني…
بعد مرور عدّة سنوات، نزح اللاجئون في رميش مجدّدًا إلى بيروت ابتداءً من العام 1951، بُغية العمل والإقامة، إذ بدا أنّ “العودة إلى الدّار” أصبحت بعيدة، وبناءً على قرار الحكومة اللبنانيّة العام 1955 تمّ نقلهم من رميش والقرى الحدوديّة بعيدًا من الحدود، تطبيقًا لاتّفاق لبنانيّ- أميركيّ، مقابل مساعدة ماليّة بلَغت أربعة ملايين دولار أميركيّ، حسبما أُشيع في رميش آنذاك. ونُقل المسيحيّون منهم إلى القرعون ثمّ إلى ضبيّه، بالأخص أهالي كفربرعم والجش، كما نُقل المسلمون إلى مخيّمات صور وصيدا وتلّ الزّعتر، بخاصّة أهالي سعسع وسحماتا ودير القاسي.
هذا بعضٌ من سمات العلاقة الرميشيّة مع قرى الجليل، وبعض مدن الساحل، كما يذكرها العارِفون، وهناك بعضٌ آخر عن هجرة الرميشيّين إلى مدينة حيفا مطلع القرن العشرين للإقامة والعمل، سيأتي ذِكرها في المُقبل من الأيّام.
في الجغرافيا
جغرافيًّا، تقع رميش بمحاذاة الحدود الفلسطينيّة جنوبًا، وتلُفّها بلدات يارون شرقًا وعيتا الشعب غربًا وعين إبل ودبل وحنين شمالًا، وتبلغ مساحتها 14 كيلومترًا مربّعًا ويراوح ارتفاعها عن سطح البحر ما بين 570 مترًا في المرج و730 مترًا في قطمون، أمّا مناخها فمتوسطيّ معتدل الحرارة والأمطار. أمّا تربتها فتصلح لزراعة التبغ والزّيتون والحبوب والكرمة والتين. تبعد عن مركز القضاء مدينة بنت جبيل 10 كيلومترات وعن بلدة النّاقورة 35 كيلومترًا، وتتبع محافظة النّبطية. أمّا عدد سكّانها، فكان أواخر القرن السابع عشر حوالي 300 نسمة، وارتفع أواخر القرن التاسع عشر إلى حوالي 800 نسمة، وبلغ أواخر القرن العشرين 10 آلاف نسمة، مقيمين ومهاجرين.