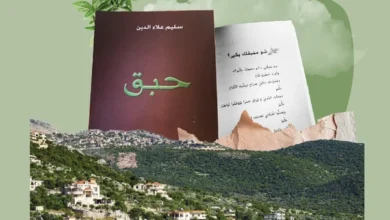قصص المنسيّين في الحانة

“أو حانةٌ من الخشب الأحمر/يرتادها المطر والغرباء” محمد الماغوط
أفكّر بمن يستمعون أكثر، ويتحدّثون أقل. يغريني فعل السّماع. الإستماع إلى المتكلّمين، إلى الموسيقى، أو لضجّة حانة تغرق بأصوات ناسها المختلطة. هل يفهمون ما يتحدّثون؟ على عكسنا نحن الّذين نسمع أصواتهم العديدة كصوتٍ واحد.
أفكّر بالأصوات الثّابتة أيضًا، زمّار سيّارة واحدة بعد أن يتحوّل لون الإشارة إلى أخضر. ستسمع هذا الصّوت دائمًا ولن تدري من صاحب الزمار ولماذا يفعل هذا وكأنه من طقوس العبور عند الإشارة. هو يزمّر بلا سبب ويعرف أن لا نتيجة حقيقية من ذلك فلن يتحرّك السير في لحظته. أو ربما يخمن أن جميع العابرين عميان وعليه أن يحلّ محلّ حاسّة الرؤيا فيطلق صوتًا عبثيًا لينبّه جميع الذين رأوا الضوء الأخضر لا محالة. هذا بالتّحديد مِن المستمعين أكثر، والمستمع عادةً لا يمكن أن يثق بغير أذنيه. هؤلاء لا تُدفن ذاكرتهم أبدًا، لأنّهم يخلّدون ناسًا فيها، ناسًا ربما ماتوا، أو سيموتون قريبًا.

في الشتاء كنت أحب وجوه الناس الحزانى في الحانات. لأحزانهم هالة تحيط الأماكن. تعابيرهم المستسلمة للكأس على الطّاولة، أياديهم التي تقبض على الكأس فيصير الويسكي أيرلنديًا في لحظة خاطفة، والمنتظرين، والمتأخرين الذين لم يأتوا فانتهى بهم الأمر منتظرين مَن انتظرهم.
في الشتاء صرت أحب من يشهد على وجوه الناس الحزانى في حانته. يرى تعابيرهم المستسلمة، يعطيهم الويسكي الأيرلندي جاهزًا تفاديًا لقبضة يدهم المشدودة على الكأس، وينتظر مع المنتظرين قبل أن يشي بالخبر السيء للمتأخرين الذين سيعيدون الكرّة في الإنتظار. هؤلاء من يرتادون الحانات للحديث فقط، لإيجاد رفيق في الوحدة العارمة. نادرًا ما يلتقون بوحيد مثلهم يرتاد الحانة للسبب ذاته، وغالبًا ما يتحدّثون للخيار الأسهل المتوفّر دائمًا، النادل. النادل الذي يبدو من ضمن مهامه التي لا يتقاضى أجرًا عليها، الإستماع إلى زبائنه ومساعدتهم في مشاكلهم وتقديم النصائح والحلول.
لم أعرف كل ذلك حتى عملت في حانة في الحمرا وصرت أنا النّادلة. عرفت أنّ الإكرامية الأكبر تذهب للذي استمع أكثر. أما الذين لا يتركون إكراميات كبيرة فهم الذين لم يجدوا من يتحدث إليهم. أن تكون نادلًا أو ساقيًا يعني أن تؤدي المهام الأكثر شقاءً، يعني أن تجمع بين شخصية الطبيب، والعبد الذي يتقاضى أجر أكله وشربه كل يوم بيومه، وأن تكون المبتسم دائمًا للوحيد، والسعيد، والثرثار، والمعجب من النظرة الأولى، واللئيم، والبخيل والمتحرش. أن تكون نادلًا يعني أن تتقمّص شخصية القاصّ والروائي، أن تمارس فعل السمع وتدوّن.
كل الذين مرّوا على الحانة كانوا غرباء تمامًا، حتّى عرفت قصصهم الأكثر صلافةً ودوّنت.
أن تكون نادلًا أو ساقيًا يعني أن تؤدي المهام الأكثر شقاءً، يعني أن تجمع بين شخصية الطبيب، والعبد الذي يتقاضى أجر أكله وشربه كل يوم بيومه، وأن تكون المبتسم دائمًا للوحيد، والسعيد، والثرثار، والمعجب من النظرة الأولى، واللئيم، والبخيل والمتحرش. أن تكون نادلًا يعني أن تتقمّص شخصية القاصّ والروائي، أن تمارس فعل السمع وتدوّن.
تخبرني نور أنها تركت والدها وأختها في طرابلس وهربت. تخبرني أنها زارت هذه الحانة قبل هروبها بفترة قصيرة ولم تكن تعرف أن زيارتها هذه ستحرّضها على الهروب بعدها بأسبوع واحد فقط. أعجبها المكان، والسحر الذي يصنعه الساحر الساقي وراء البار. تركت المنزل كما تركته أمها في المغرب بعد أن كان يضربها والدها كما ضرب أمها أيضًا.
تحرّض بيروت على الأفعال الأكثر دراميّة، وتجعلني أؤمن أكثر أنها مدينة مختَرعة في فيلم ما وساكنوها مجرّد طاقم عمل في هذا الفيلم الطويل. هَربَت نور ولكنها عارضَت هرَب أختها الأصغر بعدها بسنة واحدة. تقول إنّ الأفضل لها أن تبقى في المنزل مع والدها وتعايرها بحرّيّتها التي لم يمنحها الوالد لأحد غيرها. هي الدّوامة ذاتها تُعاد وتتكرّر. ولكن كما تركت الأمّ طفلتيها مع الرجل المعنّف ظنًا منها أنهما آمنتان هكذا، تركت نور أختها. ولو هربت أختها كانت ستعاير زوجة والدها الجديدة على تفكيرها في الهرب. كأنَّ النساء هنَّ أوّل أعداء النساء.
يتذمّر أيمن، الزبون الغريب عنّا تمامًا من ربطة العنق التي أرتديها واضعةً إيّاها تحت القميص بين الثديين. يتذمّر بكلّ فجاجة ويلومني على تخبئة هذا الجزء المثير من صدري، يقول إنّني فعلت ذلك لأشوّقه وأرغّبه برؤية المزيد. ثم يلامس كتفي بلا خوف أو خجل. أخبرت “أحمد” المسؤول عن المكان بذلك. فقال “تلذّذي”. وضحك بلا مبالاة.
هجر “أحمد” موطنه سوريا بسبب خيبة الحبّ. ترك بيته وكلبه الذي ربّاه عمرًا وحبيبه السّابق وذهبَ عبر الحدود. يفضفض لي ضائعًا في غصّته ويقول إنّ مناطق سوريا لم تكفه للنّسيان. سوريا كبيرة جدًا، لا محالة أنّ الحبّ كان كبيرًا بحجمها أيضًا.

ليلة الخميس يقف “محمد” أعلى البار ويرقص داعسًا على الخشب العتيق. يدوس على بقايا الشراب، وعلى أيدي الناس أمام البار وهم لا يشعرون. الجالسون أمام البار هم الأكثر غرقًا في حزنهم. حين ينتهي من رقصته يجلس أمام البار على كرسي محفوظ باسمه منذ افتتاح المكان، ويشرب البيرة. يضحك الرجل دائمًا، يزيل الهم من القلوب. كنا ننتظره حتى يغير لنا رتابة ليلتنا الطويلة. محمد أول زبون يجلس أمام البار ولا يظهر حزنه علانيةً. ثمّ ينهي كلّ ليلةٍ باصطحاب امرأةٍ معه إلى المنزل.
لم يخرج لو لليلة خالي الوفاض. كنّا نتعجّب من قدرته الهائلة على جذب النساء والرجال. حتى أتت ليلة الخميس الأخيرة، قبل تركي العمل بأسبوع. أراني صورة له ولحبيبته السابقة التي هجرته دون أن تترك له توضيحاً. كان صغيرًا في الصورة، مر على الأقل عشر سنوات على التقاطها. سألته إن كان قد تخطى حبه، فقال ” لا. ولكنّني حاولت. بعدد نساء كل ليلة”.
يقف الصبي “محمود” أمام الباب ويحاول بيع الورد للزبائن فأحاول إبعاده عن المشهد. يسترسل في حديث عبثي ما، يخبرني عن أخته التي تزوجت إبن عمّها في سوريا الأسبوع الفائت، وهي لم تبلغ بعد. يقول أنّ نصيبها كان مقطوعًا لفترة طويلة فأحضروا لها شيخًا اسمه “شهدباد” وضربها بالعصا قارئًا عليها آياتًا قرآنية من سورة “الجنّ” وسورة “الواقعة” حتى فتح لها نصيبها.
يخبرني محمود برغبته العارمة في أن يصير شيخًا يومًا ما فيضرب الناس بالعصي فاتحًا أبوابهم المغلقة، ويأمرني أن أدعو له بالتيسير لأنه سيذهب إلى سوريا غدًا. “ادعيلي يسكروا الحدود سنتين. هيك باخد عطلة من الشغل وببقى ببلدي” يقول ابن التسع سنوات. لم أدعو له بذلك، ولم يغلقوا الحدود، ولم يعد. هذه البلاد لا تحتاج إغلاق حدودها لتحبسك بداخلها كالموت المفاجئ السريع.
ليلة الخميس يقف “محمد” أعلى البار ويرقص داعسًا على الخشب العتيق. يدوس على بقايا الشراب، وعلى أيدي الناس أمام البار وهم لا يشعرون. الجالسون أمام البار هم الأكثر غرقًا في حزنهم. حين ينتهي من رقصته يجلس أمام البار على كرسي محفوظ باسمه منذ افتتاح المكان، ويشرب البيرة
تخبرني “لمياء” الصبيّة الجميلة التي تحمل كاميرتها وتلتقط لنا صورًا تذكاريّة في الحانة أنها سافرَت إلى أميركا لمقابلة حبيبها الذي كان سيصير زوجها. في المطار أرسل لها رسالة طويلة بالأجنبية قائلًا ” لا تأتِ. لا أستطيع الإستمرار”. بكت لمياء عن كل المسافرين والعائدين في المطار.
تجلس “مريم” دائمًا في زاوية البار، في نهايته تمامًا. تشرب البيرة، تراقب الكؤوس التي أصنعها، ترقص مع محمد في المكان وتلتقط صورًا على هاتفها للمنتظرين في الحانة. بعد أن انكسر قلب مريم من الحب صارت تجلس في مقدّمة البار، تتلّفت إلى الخارج، تراقب المشاة، تبادر بالحديث إلى المتسوّلين الصغار في الشارع عسى أن يدخل حبيبها الشارع مشيًا في أيّة لحظة، وتعد السيارات وأرقامها الرتيبة بانتظار سيارته الحمراء.
في الحانة صارت كلّ كؤوسي مشرّدة لا أحد لينظر إليها، لا أحد ليلتقط صورًا للمنتظرين. صارت هي المنتظرين.
في الشتاء القادم أريد أن أصنع فيلمًا للسينما من لقطة طويلة عن كل الذين قابلتهم وسقيتهم مشروبًا يليق بأحزانهم وكل الذين استمعت إليهم لساعات في الحانة المنسيّة. الأفلام السعيدة مملّة، يحلو لي أن تكون الحياة مجرّد فيلم طويل لساقيةٍ في حانة، تفكّر بنا كأحزانٍ في رأسها، ولا أحد ليستمع إليها.