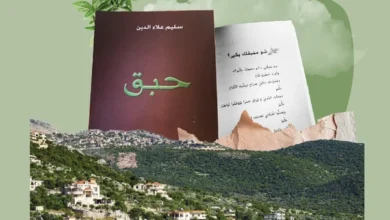من السطح إلى القرميد فالفنّ.. تحوّلات البيت اللبنانيّ

ما أن يتمكّن الطفل من حمل قلم- أقلّه في بلادنا-ـ حتّى يشرع بإنجاز ذاك الرسم الذي عرفناه جميعًا: بيتًا بسطح من قرميد، شجرة إلى جواره، وشمس عند طرف الورقة. ثمّ يتكرّر الرسم عينه مرّات حتّى يلتصق بالمخيّلة كحلم لا واعٍ، يطمح المرء إلى تحقيقه يومًا ما. يترصّع الحلم مع سنوات الدراسة الأولى، حيث تجود علينا كتب القراءة والاستظهار، بتلك الرسوم الجامعة للعائلة في حضرة الجدّة المنشغلة بحياكة الصوف. دفء رحم البيت، المكمّل لهندسته التي رسمناها بخطوط طفوليّة متعرّجة.
سوف يخال المترصّد شيوع ذلك الحلم البدائي أنّ بيوت القرميد كانت ها هنا، مغروزة في أرضنا منذ مئات السنين، لتكون الإجابة الصادمة بأنّ القرميد لم يكن يومًا من تراثنا، فمجتمعاتنا اعتمدت السطوح الافقيّة كضرورة وحاجة، مِن تيبيس القمح، وتجفيف أوراق الملوخيّة، وتشميس البندورة والتين وغيرها من الأطعمة التي ترافق الرفوف كمؤونة وأمان.
القرميد الوافد
مخطئ من يضع سنة محدّدة لبدايات تغلغل القرميد إلى هندسة البيوت اللبنانيّة، لكن غالبيّة الاحتمالات تربط وجوده بزمن الأمير فخر الدين، إذ جلب الفكرة من أوروبّا؛ وكذلك بعض الأفكار الأخرى التي انتشرت في فترة حكمه. آنذاك كان القرميد حلًّا ناجعًا للسطوح التي تدلف المياه على سكّان البيوت شتاءً، مع ما يصاحب الأمر من حدل للسقوف المبنيّة من الطين والقشّ، في حين كان الأمر أكثر كارثيّة في البيوت الجبليّة، حيث يتكدّس الثلج فوق السطوح.

تزامن اعتماد اللبنانيّين القرميد مع استيرادهم الخشب القطران على الرغم من تواجده في بلدنا في أشجار الأرز، لكن يبدو أنّ استيراده كان اكثر يسرًا، فهذا النوع يتمتّع بكمّيّة عالية من الرزين المانح للقوّة، المقاوم لعوامل الطبيعة. إذًا كانت هناك لمسات هندسيّة ثانية غير القرميد، مثل واجهات البيوت المعتمدة على القناطر الثلاث، في تلك البيوت المربّعة.
بيوت الجبل
بطبيعة الحال كان جبل لبنان المتلقّف الأوّل للفكرة الوافدة، كذلك حال راشيّا الوادي، حيث بنيت كنيسة السريان في العام 1850. بدا القرميد مثل طربوش للبيوت، ثمّ راحت جدرانها تأخذ وضعيّة الثبات بالحجر الصخريّ، ذو الكلفة العالية، نسبة للطين. “النحلة” هو الاسم الذي كان يطلق على ذلك القرميد الأحمر الفرنسيّ.
تأخّر القرميد في زحفه نحو الجنوب اللبنانيّ، أو البقاع وبيروت، وحينما حضر لم يتحوّل إلى حالة عامّة منجبلة في هندسة بيوت القرى، سوى في بعض الصروح الرسميّة، مثل السرايا أو القصور وقلّة من بيوت، حيث أخذ القرميد البعد الجماليّ، ومن ثمّ الوظيفيّ. وبالطبع أصبح القرميد جزءًا من هويّة البيت اللبنانيّ، وغدت بعض البلدات- مثل دير القمر ودوما- أماكن سياحيّة، يُتباهى بها كما غابات الأرز.
الرسّام المؤرخ
مثل حال القرميد، لم يكن للفنّ التشكيليّ موطئ جدار، أو إطار، في تاريخ لبنان، فكانت هناك إرهاصات بدائيّة غير موثّقة، ثمّ تبلور هذا الفنّ في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، مع الروّاد الأوائل مثل داود قرم، جبران خليل جبران، خليل صليبي وحبيب سرور، ثم كان عهد مصطفى فرّوخ وقيصر الجميّل وعمر الأنسي وصليبا الدويهي وماري حداد…
تأخّر القرميد في زحفه نحو الجنوب اللبنانيّ، أو البقاع وبيروت، وحينما حضر لم يتحوّل إلى حالة عامّة منجبلة في هندسة بيوت القرى، سوى في بعض الصروح الرسميّة، مثل السرايا أو القصور
في بعض لوحات هؤلاء الروّاد بعد تأريخيّ، ولو لم يكن الأمر متعمّدًا، حيث كان الرسّام منهم يسجّل ما يراه بجمالية واحترافية، سوف تساهم في تعريفنا على الأبعاد الهندسيّة للبيوت اللبنانيّة، ثمّ يكتمل الفعل التأريخيّ التوثيقي مع التصوير الفوتوغرافيّ الذي أدّى دوره على أفضل ما يكون، ولو أنّ غالبية تلك الصور بعدسات مستشرقين. لكن بطبيعة الحال كانت تلك العدسات بدائيّة تلتقط الصور بالأسود والأبيض، بينما ألوان الفنّانين ناضحة بالحياة في أعمالهم الزيتيّة تلك.
البيئة المحيطة
سيلاحظ المراقب للوحات الفنّانين اللبنانيّين الأوائل أنّهم وثّقوا البيوتات بقرميدها وسطحها الأفقيّ، كما رسموا دور العبادة والصروح الكبرى وصولًا إلى الكوخ والعرزال.
بالنسبة للسطوح الطينيّة أو الإسمنتيّة في ما بعد، غالبًا ما تتوَّج بدالية مورقة، تتدلّى منها العناقيد الصفراء أو الحمراء، بينما يخترق سقف القرميد بكوّة مخصّصة لدخان الموقد. في محيط البيت أو البيوت، دائمًا هناك أشجار تراوح بين الزيتون والسرو أو ربّما شجرة مثمرة كالتفّاح والإجاص والبرتقال. أمّا خلفيّة البيت فجبال خضراء بدرجة مخفّفة، وجبال أبعد بلون مائل للزرقة. الغيوم تضفي جماليّة على اللوحة، كذلك بعض الطيور البعيدة. ثمّ تنوّع للعناصر لا يخطف نجوميّة البيت، خصوصًا المتوّج بالقرميد.
بيوت لها أرواح
يستحضر الفنّان حسن جوني البيت اللبنانيّ في معظم لوحاته، فيرسمه في جبل أو غابة أو مندمجًا بالبحر، فيعتمد التدرجّات اللونيّة للقرميد بين الأحمر والبرتقاليّ والبنّي، بينما تتمايل الخطوط في مجمل عناصر اللوحة، فنشعر كأنّ البيوت كائنات حيّة، تتراقص، تمشي، تبتعد، وتغيب.

أمّا في لوحة الفنّان عماد أبو عجرم، فالبيت والمنظر الطبيعي أو البحر حقيقيّين، تنطق بشكل آخر، حيث أنّ الألوان المائيّة (أكواريل) تستبطن خاّصيّة التمدّد الحرّ، ولذلك يستفيد منها الفنّان اللبنانيّ، موظّفًا لها في رسوماته، كحال هادي يزبك، ورئيس جمعيّة الفنّانين التشكيليّين ميشال روحانا، الذي اتّخذ من المنظر الطبيعيّ اللبنانيّ موضوعًا ثابتًا، حاك عليه مئات اللوحات الناضحة بالبيوت، الصغيرة والكبيرة، بقرميدها وقناطرها ونوافذها وأبوابها.
الهويّة اللبنانيّة
بشكل أو بآخر، كان التشكيلي اللبنانيّ ولا يزال، شريكًا في بناء الشخصيّة اللبنانيّة لبلد احتفى بمئويّته منذ وقت قريب، وكان يحتاج إلى عناصر فكريّة تاريخيّة ميثولوجيّة فنّيّة وهندسيّة لخلق اللُّحمة بين أطرافه ومركزه، فكانت تلك الرسوم شريكة الأخوين رحباني وفيروز وسعيد عقل ويوسف السودا وميشال شيحا، وصولًا إلى حكايات الأديبة اميلي نصرالله، وقبلها مارون عبّود، ولا ننسى الأدب الشعبيّ مع سلام الراسي، والزجل بأربابه، كما الدراما التلفزيونيّة التي أنتجها تلفزيون لبنان في الستينيّات والسبعينيّات.
تشييد بلا خطط
لا شكّ في أنّ البيت اللبنانيّ التقليديّ راح يتهشّم تباعًا منذ أربعينيّات القرن الماضي، لتحمل الطفرات الماليّة والنهضويّة مدارس متعدّدة من الهندسات الغربية في أكثرها، في حين كانت الأرياف تعاني من إهمال الدولة، فبنيت البيوت بعشوائيّة، مرتكزة على مقدّرات،وخبرات معلّم البناء، فكانت مكعّبات دون تلييس من الخارج، أو بأعمدة إسمنتيّة على السطح، بانتظار احتمال استكمال البناء من قبل أحد الأبناء، وهناك أدراج (سلالم) بلا بلاط، إضافة إلى بوابات ونوافذ حديديّة خالية من أيّ عناصر جماليّة.

الحرب والعولمة
أمّا في العام 1975، فكانت الحرب كفيلة بتدمير وتشويه آلاف الأبنية والبيوت بين العاصمة بيروت وكثير من خطوط التماس في المناطق. ولن ننسى الاعتداء الاسرائيليّ في العام 1978، ثمّ الاجتياح سنة 1982، ثمّ طفرة البناء بعد انتهاء الحرب في العام 1990، والتي لم تدرس بما فيه الكفاية، لنلاحظ البناء المعولم من دون ان تظهر الاستفادة من التراث الهندسيّ اللبنانيّ، بل على العكس تمامًا، حيث هدمت بعض الأبنيّة القديمة ليشيد على أنقاضها ناطحات سحاب. وكذلك لا بدّ من ذكر انفجار المرفأ الذي هدم بعض بيوت بيروت العريقة، المصنّفة بيوتًا تراثيّة ممنوع مسّها.
ربما من أجل ذلك يلجأ معظم الرسّامين اللبنانيّين اليوم إلى تنفيذ لوحاتهم من المخيّلة وليس من الواقع، وكـأنّ هؤلاء التشكيليّين عادوا صغارًا ينجزون ذاك البيت المطوّق بالشجيرات والشمس والغيمة، فيغدو حلمهم الذي تحقّق على الورق، أيّ ورق.