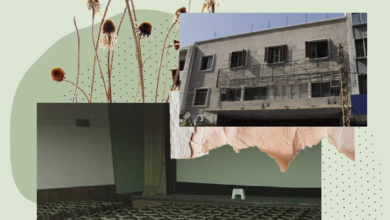من مراهقين إلى متعدّدي المواهب خمسون عاماً على روّاد معرض بعلبك

ما زالت، حتّى هذه اللحظة، صورة قاعة مدرسة الشمس في بعلبك حاضرة في ذهني، بالرغم من مرور عقود كثيرة على الحدث. ربّما يعود الأمر إلى طبيعة ذاكرتي غير العاديّة، التي ورثتها عن المرحوم والدي، صاحب صفة أستاذ التي رافقته أينما حلّ، ما أفضى إلى إطلاق صفة عليّ بدوري، تمييزًا عمن يحمل الإسم وإسم العائلة نفسيهما، إذ كنت أسمّى في صغري: محمد الأستاذ.
اعتبر والدي، رحمه الله، “ندوة الخميس” من أفضل ما استطاع القيام به في حياته، التي كان من الممكن أن تطول لو لم يفتك به المرض اللعين، ويودي به بلا رحمة. أراد، دائمًا، أن تقوم الندوة، ذات الصيت الذي لم يغب عن أحد من سكّان المدينة وحتّى البلد كلّه، بنشاطات تتعدّى الأطر العاديّة، ولا تقتصر على ندوات ذات طابع أدبيّ أو اجتماعيّ، ولا أقول سياسيّ، فقد حرص على الابتعاد عن السياسة، اللهم إلاّ إذا تعلّق الأمر بمناسبة وطنيّة، شارك فيها أفراد معروفون بانتمائهم السياسيّ.
نبش الفنّ والفنّانين
خطرت في ذهنه إقامة معرض لـ “الفنّانين” الشباب في المدينة، علمًا أن صفة فنّان تُعتبر جدّ فضفاضة هنا، إذا ما شئنا إلباسها لفرد أو لأفراد من شباب المدينة ممّن تخطّوا بالكاد سنّ المراهقة. وللمناسبة، لم تكن معارض الفنّ التشكيليّ كثيرة في ذلك الحين من بداية سبعينيّات القرن الماضي، لأسباب عديدة، قد يكون أبرزها أنّ هذا النوع من الفنّ لم يحظَ باهتمام كثيرين، كالموسيقى والغناء أو السينما مثلًا. أضف إلى ذلك أنّ ممارسي هواية الرسم، ممّن تعدّوا مرحلة الشغف الطفوليّ به، التي لا تستمرّ طويلًا عادة، لم تكن أعدادهم وفيرة.
لم تكن معارض الفنّ التشكيليّ كثيرة في ذلك الحين من بداية سبعينيّات القرن الماضي، لأسباب عديدة، قد يكون أبرزها أنّ هذا النوع من الفنّ لم يحظَ باهتمام كثيرين، كالموسيقى والغناء أو السينما مثلًا
في كلّ الحالات، تم “نبش” ستّة شبّان، لم يبلغ نصفهم سنّ العشرين، بل كانت أقلّ من ذلك بكثير، في حين كان الباقون في بداية العشرينيّات. لم يأتِ الخيار عشوائيًّا، بل قدّم العديد من الشبان أعمالًا جرى استعراضها بمساعدة الفنّان الراحل رفيق شرف، الذي وبالرغم من علمه أنّ ما جرى استعراضه لا يطمح بعد إلى شيء من الاحتراف، كان أمرًا طبيعيًّا، نظرًا إلى أن أحدًا من المشاركين لم يكن قد درس الرسم حتّى ذلك الحين.
انتهت “التصفية” إلى اختيار ستّة مشاركين هم: قاسم الطفيلي، مازن الرفاعي، حسين مرتضى، رضا منذر ياغي، عبدالله شمص وكاتب هذه الكلمات.
فنّ في زمن القحط
لم أعد أذكر كثيرًا عن تفاصيل حفل الافتتاح، الذي يكون، عادة، مؤشّرًا على الاهتمام بالحدث. لكن بعض الصور بقيت في ذهني: علامات الإعجاب التي أبداها بعض الزوّار من جهة، وكثير من الأسئلة التي طرحها آخرون من جهة أخرى، وخصوصًا إذا ما كان الرسم لا يستوفي، بجدارة، شروط المدرسة الواقعيّة، التي كانت في حينه، وما زالت، معيارًا للحكم على “جودة” المنتج الفنّيّ.
إلى ذلك، من النافل القول، في هذا الشأن، أنّ هذه المسألة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمستوى الثقافيّ عامّة، والمعرفة المتعلّقة بشؤون الفنّ التشكيليّ في شكل خاص، وتطوّر أساليبه عبر التاريخ، وهو الذي لم يكن متاحًا لكثيرين.
منذ أيّام، نشر بعض الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعيّ صورة تذكاريّة، خاصّة بـ”ندوة الخميس”، يبدو فيها المشاركون في المعرض. وللمناسبة، ليست هي المرّة الأولى التي تُنشر فيها هذه الصورة، لدرجة أنّها حققت شهرة بين سكّان المدينة وتحديدًا الشباب ومن أجيال عديدة. إعجاب اختلطت فيه جماليّة الذكرى بمشاعر النوستالجيا، السائدة في هذه الأيّام الرديئة.

ليس من الصعب التعرّف على الأفراد الستّة، الذين جمعتهم الصورة، على من عرفهم ورآهم يكبرون، وتتغيّر سحناتهم بفعل الزمن. لكنّ الجيل الجديد سيجد بعض الصعوبة للقيام بهذه المهمة. أكثر من نصف قرن مضى على ذلك المعرض، الذي كان المشاركون فيه في مقتبل العمر. أمّا الآن، وبالنظر إلى أحوالهم، وما هم عليه في هذه الأيام، فينبغي القول إن ثلاثة منهم فقط أكملوا مسيرتهم في عالم الفنّ، ولو بدرجات ومستويات متفاوتة، في حين هجره الآخرون.
بين الهندسة والمعارض
درس مازن الرفاعي الهندسة الداخليّة في معهد الفنون الجميلة، ومارس مهنته كمهندس تصميم داخلي، ولا يزال. قام بتنفيذ مشاريع خاصّة كثيرة، لكنّ إسهاماته في المشاريع ذات الطابع العام كانت بارزة. من ضمن ما قام به مازن، وربّما الأهمّ، والمتعلّق بمدينة بعلبك، نذكر مشروع تأهيل الأسواق التجاريّة، ومنها السوق القديمة، عند مدخل المدينة. هذ الفرع من مشروع الإرث الثقافيّ تمحورت فكرته الجوهريّة حول إبراز النمط المعماريّ التراثي للمدينة في مواجهة الهياكل الرومانيّة، القريبة من المكان.
الجدير بالذكر أن مشروع تأهيل المدينة القديمة هذا كان قد شارك في المؤتمر العالمي للمدن في مدينة طهران بإيران، وحاز على الجائزة الأولى. أمّا في ما يخصّ اهتمام مازن بالفن التشكيلي فلم يتغيّر، بل ازداد احترافًا مع الأيّام، وتشهد على ذلك معارضه العديدة لدى “غاليري أجيال” في العاصمة اللبنانيّة، وبعض الغاليرهات الباريسيّة بفرنسا.

سافر رضا منذر ياغي إلى هنغاريا، حيث درس الطبّ. تزوّج من سيدة هنغاريّة، وأنجب منها فتاتين على قدر واف من الجمال. قرر الدكتور رضا الاستقرار هناك، شأنه شأن عديد من اللبنانيّين الذين لم يجدوا في الوطن ما يرضي طموحاتهم المهنيّة، وما يؤمّن لهم أجواء هادئة ومريحة، بعيدًا من فوضى البلد ومشكلاته التي لا تنتهي. استمرّ بممارسة الرسم كهواية يكرّس لها أوقات فراغه، بيد أنّ أعماله التصويريّة تحمل كثيرًا من معالم الخبرة، وخصوصًا في مجال اللون، استنادًا إلى تقنيّة كان قد طوّرها مع الأيام. كان من الممكن أن يذهب ياغي بعيدًا في هذه الدرب لو شاء ذلك، لكنّه آثر أن يوليه أهمّيّة نسبيّة، كما نخمّن، استنادًا إلى كمّيّة نتاجه الموسميّ، التي نحن على علم بها.
أما كاتب هذه الكلمات، فقد انصرف نهائيًّا إلى شؤون الفنّ، رسمًا، أو كتابة ونقدًا فنّيًّا، خلال مرحلة التدريس الجامعيّ، وما بعدها، وذلك في صحف ومواقع لبنانيّة وعربيّة. أقام عدّة معارض في لبنان وبعض البلدان الأوروبّيّة، وسافر إلى زوايا مختلفة من المعمورة بهدف تنفيذ جداريّات، أو الإشراف على بعض المشاريع الفنّيّة.
ترك قاسم الطفيلي الرسم، وانشغل بالتدريس، ليس كمدرّس وحسب، بل أنشأ مدرسة تحت مسمّى “مدرسة الواحة الخضراء”. كما أنشأ أيضًا جمعيّة ثقافيّة هي “منتدى بعلبك الثقافيّ” بمساعدة أفراد آخرين من المدينة. إلى ذلك، كان قد وضع كتابًا عن مثقّفي مدينة بعلبك، تضمّن سيرًا ذاتيّة لمجموعة من مثقّفيها. عمل الطفيلي في الحقل الاجتماعيّ، وشارك في عديد من النشاطات المرتبطة بهذا الحقل.

حين تواصلت مع حسين مرتضى، لسؤاله عمّا إذا كان لا يزال يمارس الرسم، أبدى شيئًا من علامات الحزن، لكونه توقّف بدوره عن القيام بذلك، إذ لم تسمح له الظروف في القيام بهذه المهمّة. درس حسين مرتضى الهندسة الزراعيّة في الجامعة الأميركيّة، ومن ثمّ مارس مهنة التدريس في المدارس الثانويّة. لكنّه لم يستمرّ طويلًا في هذه المهنة، إذ انتقل إلى العمل في التجارة، وافتتح محلًّا لبيع الأحذية في سوق المدينة، قبل أن يتقاعد منذ سنوات. جمعتنا، مع حسين، صداقة قديمة، ثم حالت الظروف دون استكمال فصولها. نلتقي أحيانًا، في ساعات الصباح، خلال ممارسة رياضة المشي حول مرجة رأس العين، مستبقين قدوم جحافل السيّارات، التي يجعل دخان عوادمها الهواء غير صالح للرياضة وحتّى للتنفّس.
أما مصير عبد الله شمص، فقد اختلف عمّا ورد عن شؤون المشاركين المذكورين. كان عبدالله لطيف المعشر، شديد التواضع، وبوهيميًّا في أموره الحياتيّة. كما كان يمتلك موهبة فطريّة نسبيّة في ما يخصّ مسألة التلوين، أكثر من الرسم، الذي يحتاج عادة دراسة وخبرة. يُخيّل إليّ أنّ أعماله كانت تشبه أعمال Karel Appel، الفنّان السويسريّ الشهير، ومؤسّس مجموعة Cobra في خمسينيّات القرن الماضي، علمًا أن لا معرفة لعبدالله به وبزملائه في المجموعة.
لم يكن عبد الله مكتفيًا مادّيًّا في يوم من الأيام، بل صارع دائمًا من أجل لقمة العيش. عمل في تخطيط الإعلانات، وفي مهن مرحليّة أخرى، وفي السنوات الأخيرة كان يقيم أحيانًا في جبّانة المدينة، بعدما اعتمد وظيفة حفر القبور. منذ حوالي عقدين من الزمن، كنت أزور قبور أنسبائي وصادفته هناك قرب أحد الأضرحة، وبمحاذاة هذا الضريح لاحظت وجود فراش وأغطية على الأرض. سألته عن ذلك، فأجاب أنّ زوجته، التي توفّيت قبل أوانها مدفونة هنا، وأنا أنام بقربها في بعض الأحيان…
لم يعش عبد الله كثيرًا بعد هذا اللقاء الذي حصل مصادفة. علمت أن سيارة تقودها سيّدة صدمته وهو على درّاجته الناريّة فلقي حتفه، لتنتهي بذلك حياته البائسة على نحو مأسويّ، وكأنّ مجرياتها هي أشبه بصورة مجازيّة لهذا البلد العامر بالتناقضات، بحيث “نتضوّر حتّى التخمة جوعًا”، على ما يقول مظفّر النوّاب، ويكمل: فيما “يخاف البعض (القصيدة تحمل عبارة أخرى) على النقد من الجرذان”.