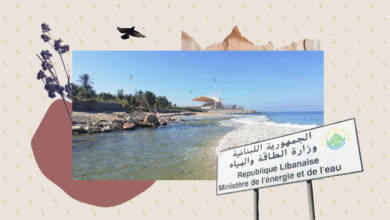من يردع استباحة “القمّوعة” محميّة عكّار المؤجّلة؟

اجتاحت حرائق غابات القمّوعة منتصف آب الجاري، نحو 10 آلاف متر مربع تتكثّف فيها أشجار الصنوبر، يُرجِّح المتابعون تواتر نموذج هذا الحريق ضمن نمط موسميّ للحرائق في لبنان، حفّزته موجة الحرّ العالمية الأخيرة. بيد أنّ القمّوعة تتعرّض بشكل متواصل لانتهاكات بيئيّة جسيمة لا علاقة لها بأحوال الطقس في غياب الرقابة المحلّيّة والرسميّة ومن دون رادع أو من يحاسب.
في عرف الاستجمام والترفيه، يتصدّر هذا الفردوس الأخضر خيارات أهالي عكّار والشمال عمومًا فيشكّل وجهة لهم، لكنّه يفتقر إلى أبسط تدابير الحماية، ما يكشف القمّوعة أمام جرائم بيئيّة خطيرة تعمّق أزمة المياه في عكّار، وتلحق الضرر بنسيجها البيولوجي النادر، وسط نزاع محلي، وقرارات حكوميّة لحمايتها بقيت حبرًا على ورق.
لوحة من فردوس
طريق إسفلتيّة مترهّلة تفرض الحذر، يحدّها “وادي جهنّم” يسارًا، وأبنية منخفضة عند كتف الوادي لا تحجب هالته السحيقة. نتقدّم داخل قرى عكّار النائية، مشمش ثمّ فنيدق، حيث تتزاحم الأبنية غير “المليّسة”، ويفيض عن الشوارع الضيّقة ازدحام الناس والدكاكين، فنغرق في اختناق مروريّ بفعل الدرّاجات الناريّة والسيّارات، وشاحنات مُحمّلة بالبحص المستخرج من الجبال، مخلّفة وراءها غبارًا كثيفًا.

نكمل صعودًا. الطريق مسيّجة بالشجر البرّي، ثم ما تلبث أن تنفرج عن عزلة قرويّة هادئة، تنساب فوق سهل يمتدّ فيه العشب على مرمى النظر. وحده طنين الرياح يتداخل مع ثغاء الماعز، ورنين الأجراس المعلّقة على رقابها. إنّها القمّوعة، تبتعد عن بيروت 146 كيلومترًا، وترتفع ما بين 1400 متر و2250 مترًا عن سطح البحر، وتنتشر على مساحة 12.3 كيلومتر مربّع، شاغلة أعلى قمم عكّار.
ينجلي المشهد عن تنوّع طوبّوغرافي ساحر. السهل الذي منح القمّوعة علامتها الفارقة، يتحوّل شتاءً إلى بحيرة، تحيط بها هضاب جبل المكمل، حيث تطلّ قلعة عارومة أو “عروبة”، فتتكامل طبيعيًّا مع محميّة “كرم شباط” ليشكّلا جسرًا طبيعيًّا يربط محافظتي عكّار والبقاع. وفي الليالي الصافية، تتحوّل سماء القمّوعة إلى وشاح كحليّ شفّاف، يتلألأ عبره حزام مجرّة درب التبّانة، تتخلّله فراغات سوداء رسمتها ظلال الشوح المعمّر، وهي جزء من سلسلة غابات جبليّة نادرة.
حماية الزرع
يستتبّ الهدوء صباح الخميس؛ باعة خضار ينزوون قرب بسطاتهم، وملاهٍ للأطفال خالية، وعلى مقربة منها خيول مسترخية تركت روثها على العشب. تنتشر حول السهل مقاه ومتنزّهات وشاليهات غالبيّتها على نمط أكواخ الخشب، وهي حديثة النشأة، تعود لرجال أعمال نافذين محلّيّين تعاقبوا على المجالس النيابية والبلدية.
على زاوية بعيدة من السهل، تجلس أمّ أحمد داخل خيمة- هي سكنها مع زوجها وأطفالها الأربعة الذين وضعت فرشهم في الخارج للتشميس، بينما تحشو الكوسى الذي جمعته من زرع أرضها.

نرافق المزارعة إلى أرض مشاع تحتشد بالذرة والباذنجان والفليفلة والبطاطا والبندورة والفاصولياء، وهي زراعات تنتشر في عكّار، إلى جانب القمح والصنوبر في الأعالي، وتعتمد على مياه المتساقطات والسواقي. تخبرنا الفلّاحة قائلة: “تركنا بيتنا في فنيدق، وسكنّا هذه الخيمة لحراسة أرضنا، لأنّنا تعرضنا مرارًا إلى سرقة المحاصيل”.
أمن مفقود ومياه عزيزة
إضافة إلى الأمن، تُقلق المياه أمّ أحمد، فتقول لـ “مناطق نت”: “المواسم غدّارة، إذ نختبر في السنوات العشر الأخيرة تضاؤلًا في كمّيّة الأمطار. العام الماضي، اضطررت إلى جرّ المياه من نبع الدلبة، وبالكاد أمّن المحصول غذاء العائلة، إذ لم أبع شيئًا. كما أنّ تكاثر الزوّار خلال الصيف زاد الضغط على مياه العين”.
وعلى مبعدة 50 مترًا، نجد أنبوبًا ناتئًا من الأرض، يتدفّق منه مجرى مياه رفيع، ليصبّ في بركة تجمّعت على شكل حوض آسن تسبح فيها النفايات. إنّها عين الدلبة.
تشترك الجارة أميرة العتيق من قرية مشمش، مع أمّ أحمد في هموم المياه. أسّست الفلّاحة وهي أمّ لخمسة أطفال، مشروعًا للزراعة البيئيّة. لكنّ أعباء التلوّث أعاقت طموحها “المجاري لوّثت مياه السواقي في قريتنا، وكذلك فإنّ نبع فنيدق ملوّث بالكامل”، تقول لـ “مناطق نت”.
تعدّ محافظة عكار ثاني أكبر سهل لبنانيّ للزراعات بعد البقاع، لكنّها تختبر تراجعًا مطردًا في المياه، معطوفًا على تلوثها
حاولت أميرة التكيّف “حفرت مع عائلتي بئرًا إرتوازيّة، وخلال الأعوام الخمسة الماضية بذلنا جهدًا مضاعفًا في ضخّ المياه بسبب انخفاض المنسوب. كذلك لجأت إلى الريّ على الشبكة التي تعتمد التنقيط عوضًا عن جرّ المياه”.
عمليًّا، يشكّل المزارعون عصب القوى الاقتصاديّة في عكّار وأفقرها، أمّا المزارعات اللواتي يساهمن بنحو 40 في المئة من هذا القطاع، فهنّ أكثر هشاشة اجتماعيًّا واقتصاديًّا في هذا المجال، وفق دراسة لهيئة الأمم المتّحدة للمرأة نشرت العام 2022.
وتعدّ المحافظة ثاني أكبر سهل لبنانيّ للزراعات بعد البقاع، لكنّها تختبر تراجعًا مطردًا في المياه، معطوفًا على تلوثها، وقد نجم عنها وباء الكوليرا في شتاء 2022، وفي طليعة أسبابه تلوّث شبكات المياه، بتأكيد من منظمة الصحّة العالميّة.
قراءة جيولوجيّة
يستدعي كشف التهديدات المائيّة للقمّوعة فهم تكوين المنطقة الجيولوجيّ. فالمعلوم أنّ جبل المكمل، يُعتبر أكبر خزّان للمياه في الشرق الأوسط، ولكنّ قلّة تعلمُ أنّه توّج القمّوعة خزّانًا مائيًّا طبيعيًّا للمحافظة، حيث تنبع منها أنهار الأسطوان والكبير وعرقا والبارد، وهي شرايين المياه الأساسيّة لعكّار وربّما أيضًا لقسم من مياه أنهر البقاع والهرمل.
هذا ما يؤكّده الباحث والأستاذ في الجيولوجيا، الدكتور عطا إلياس لـ “مناطق نت”، موضحًا “أنّ القمّوعة مثال للتضريس الصلصاليّ المكوّن من الصخور الكلسيّة، ممّا أخضعها إلى العمليّة الكارستيّة، أيّ نحت الصخور الكلسيّة على مدار آلاف السنوات بفعل الحمض في مياه المطر، والذي أدّى إلى نشوء مغاور وأحواض، موصولة بعضها ببعض عبر قنوات وممرّات سطحيّة وجوفيّة تجري عبرها المياه، وربّما تنتهي على شكل عيون صغيرة وينابيع تصبّ على مسافة بعيدة من الخزّان، الذي يغذّي 60 في المئة من قرى عكّار. وعليه، تقتبس القمّوعة اسمها من “القمع” شديد النفاذيّة والقائم فوق هذا الخزّان.”
يستنتج إلياس “أن تلوّث مياه القمّوعة يؤدّي إلى تلوّث المياه في عكّار. وتتضافر الأزمة بفعل غياب التخطيط في إمدادات المياه وحفر الآبار الجوفيّة العشوائيّ، ما يتسبّب في مناطق ساحليّة، كبلدات سهل عكّار وطرابلس وساحل جبيل والمتن وبيروت وغيرها، بتسرّب المياه المالحة للخزّانات الجوفيّة، فيفسد استخدامها في الأعمال المنزليّة والريّ ويفسد التربة”.

تبدّل مناخي وتقلّص الغطاء الثلجيّ
ويستشهد الدكتور إلياس بدراسة حديثة له ولمجموعة باحثين، نشرت في Hydrological Sciences Journal، حول تملّح المياه على الساحل اللبنانيّ، وتبيّن غزو الملوحة قرى في عكّار بمستوى يتخطّى أكثر من 20 ضعفًا ما يجب أن تكون عليه في مياه الشرب، نتيجةً مباشرة للتوسّع العمرانيّ والضخّ العشوائيّ من المياه الجوفيّة.
ولا يحيّد الباحث التغيّر المناخيّ، إذ يتوقّع انخفاض كمّيّة الثلوج، مذكّرًا أن مستوى الثلوج الكثيفة والدائمة الذي كنّا نجده على ارتفاع 2970 مترًا، ارتفع إلى 3100 متر ومعه تقلّصت مساحة الغطاء الثلجيّ السنويّ الكثيف، ما يقلّص المدّة الزمنيّة التي تبقى فيها الثلوج على الأرض، ويضعف دورها كمصدر هو الأهمّ لتغذية الخزّانات الجوفيّة.
ويختم إلياس “القمّوعة، إلى جانب مناطق مهمّشة مثل عروبة، وجبل المكمل من جبال الأربعين ورجال العشرة حتّى جبل الحبيس في الأرز، وجرد تنّورين حتّى صنّين وقاع الريم، والكنيسة وجبل الباروك، تمثّل خزّانات استراتيجيّة للمستقبل المائيّ للبنان، ويجب أن تكون مصنّفة كمناطق محميّة بيئيًّا اعتبارًا من ارتفاع 1700 متر.”
عدم حماية القمّوعة من التلوث ربّما يعرّض عكّار لنزاع محتوم على المياه
ويحذّر عطا إلياس من أنّ عدم حماية القمّوعة من التلوث ربّما يعرّض عكّار لنزاع محتوم على المياه، بخاصّة في ظلّ غياب قانون لبنانيّ فعّال لحماية الأحواض الجوفيّة.
هشاشة الحوكمة المحلّيّة
من ناحيته، يوضح العضو السابق في مجلس بلديّة فنيدق ومدير كلّيّة الهندسة في جامعة بيروت العربيّة في طرابلس، الدكتور محمّد علي، أنّ النشاط السكّانيّ الحاليّ استدرجه بشكل خاص النشاط السياحيّ القائم على المطاعم والغرف الخشبيّة.
يتابع الدكتور علي حديثه لـ “مناطق نت”: “منذ العام 2016، شهدت القمّوعة قفزة في عدد المنشآت، متجاوزة اليوم 100 وحدة تضمّ بيوتًا سكنيّة ومرافق سياحيّة. لكنّها عقارات بمعظمها غير ممسوحة، ولا تستند إلى تراخيص قانونيّة، بل إلى وثائق غير مثبتة، تقاسم بموجبها السكّان المجاورون أراضيهم الموروثة في القمّوعة، فنزحوا إليها. وكلّ هذه المنشآت تعتمد على جور صحّيّة، هي في الواقع غير صحّيّة ولا تستجيب لشروط العزل عن الأرض، ما يؤدّي إلى تسرّب نفايات النشاط البشريّ إلى المياه الجوفيّة”.
خلال زيارتنا، نوثّق بالصور تمديدات هذه الجور من مطاعم ومن أحد المنازل. يشدّد الدكتور علي على أنّ “غياب محطّات تكرير المياه المبتذلة في عكّار، إضافة إلى الإجهاد المائيّ، يفاقمان مغبّات الزحف العمرانيّ في القمّوعة. فنبع الهوّة الذي يتدفّق من القمّوعة إلى بلدة رحبة، ظهرت بوادر تلوثّه منذ العام 2019. أمّا نبع فنيدق، فهو ملوّث بشكل خطير، خصوصًا بعد إنشاء مكبّ للنفايات منذ التسعينيّات في منطقة حرف الصنوبر التي تقع مباشرة فوق النبع”. وعن عين الفروج وعين الدلبة يقول الدكتور علي “إنّهما تغذّيان القمّوعة بالمياه بالرغم من أنّ الأولى بعيدة نسبيًّا، فقد استحدثت شبكة لسحب المياه منهما، لكن إنتاجيّتهما محدودة، والأخيرة (عين الدلبة) تصبّ في بركة مياه آسنة، لكنّ منبع العين مياهه سليمة”.

الغابات تندثر
في مثال قريب جغرافيًّا، يستحضر الدكتور علي انتهاكات غابة العذر المحاذية في فنيدق، حيث بنيت فيها البيوت، وتحوّلت إلى متنزّه ومكان لجلسات التصوير نظرًا إلى طبيعتها الخلّابة وغطاء الأوراق الذهبيّة الذي يكسو أرضها في فصل الخريف. تحتضن الغابة مساحة مركّزة من العذر، وهو نوع من السنديان النادر الموجود في تركيّا، وتعدّ موطنًا لعشرات أنواع الفطريّات النادرة.
عاينت “مناطق نت” غابة العذر، ولاحظت وجود بيوت مأهولة بداخلها، ودخول وخروج المارّة والسكّان المحلّيّين بشكل طبيعيّ. وتظهر القمّوعة وضعًا مشابهًا، فإلى جانب منازل قائمة، نلاحظ أنّ شخصًا في محلّة ضهر الكاف بدأ ببناء منزله تحت شجرة شوح، وهو نمط سائر لوضع اليد، حيث يظهر فجأة حائط من الطوب ثمّ تقتلع الشجرة لإكمال البناء.
السؤال البديهي هنا، أين مسؤوليّة البلديّة في القمع والمحاسبة؟
يجيب الدكتور علي أنّ ثمّة “علاقة ترابطيّة بين القمّوعة وغابة العذر، لقد تمادت المخالفات في القمّوعة بسبب استتباب غياب سلطة الرقابة والعقاب، فقد جرى التطبيع مع هذا النمط سابقًا في غابة العذر. لم تستطع بلديّة فنيدق فرض السيطرة على الغابة لأسباب عدّة، وفي مقدّمها صناعة القرار المقوّضة من النظام العشائريّ الطاغي والسلطة السياسية الموروثة داخل المجلس والقرى العكّاريّة عمومًا”.

ويتابع “على رغم ذلك، عيّنا مأموري أحراج من شرطة البلديّة، لأنّ الأعداد المخصّصة من وزارة الزراعة لا تتكافأ مع مساحات قرانا، لكنّ معظمهم لم يؤدِّ مهامه خوفًا من الثأر، وبعضهم تواطأ مع مخالفين يقطعون الشجر أو يفتعلون الحرائق لبيع الحطب واستخراج الوقود، ما لا تستثنَى منه غابات القمّوعة. والمعلوم أنّ هذه الممارسات شهدت ذروتها في لبنان خلال استفحال الأزمة الاقتصاديّة بين 2019 و2022، دون أن يعني ذلك أنّها توقّفت”.
تخريب الأحراج
“وتخريب الأحراج لا يتمّ بشكل مباشر فقط، إذ يشكّل مفترق جبل “عروبة” ومنطقة تقع على مسافة 600 مترًا منها، بؤرًا لحرق الإطارات بهدف استخراج الخردة وبيعها. وتنجز العمليّات بفعل مخرّبين معروفين، ضمن مساحة تقدّر بـ 20 ألف متر مربّع، متسبّبة في إتلاف العشب وتلويث الشجر المحيط واختناقه. كذلك يطال التلوّث المياه الجوفيّة، فالمواد المحروقة والمتفاعلة مع المعادن الثقيلة تختزن سمومًا مسرطنة تتسرّب إلى باطن الأرض، بخاصّة مع الأمطار خلال الشتاء” وقائع يسردها لـ “مناطق نت” أشخاص يتحفّظون عن نشر أسمائهم، وأرسلوا لنا صورًا موثّقة.

وفي رصد للمساحات الخضراء في القمّوعة، استخدمنا المؤشّر المعياريّ للغطاء النباتيّ(NDV) على متصفّح كوبرنيكوس، وقارنّا شهر آب بين عاميّ 2017 و2025. أظهرت الأقمار الصناعيّة للمفوضيّة الأوروبيّة تراجعًا في درجة اللون الأخضر من الداكن إلى الخفيف، وظهور بقع بيضاء، ما يعني تراجعًا في كثافة وعافية الغابات والنبات، واختفاء مساحات خضراء.
اتّصلت “مناطق نت” بوزارة الزراعة، كونها مسؤولة عن حماية الأحراج، وذلك لكشف تفاصيل المرسوم رقم 519 الصادر في 22 حزيران (يونيو) 2025، والقاضي بتعيين 106 حرّاس أحراج وصيد وسمك في الملاك. أجاب المصدر “لم تنتهِ وزارة الزراعة من توزيع الحرّاس. وعلينا الإقرار بعدم تغطية جميع المناطق الحرجيّة لقلّة عددهم، ولمراعاة أماكن سكنهم”.
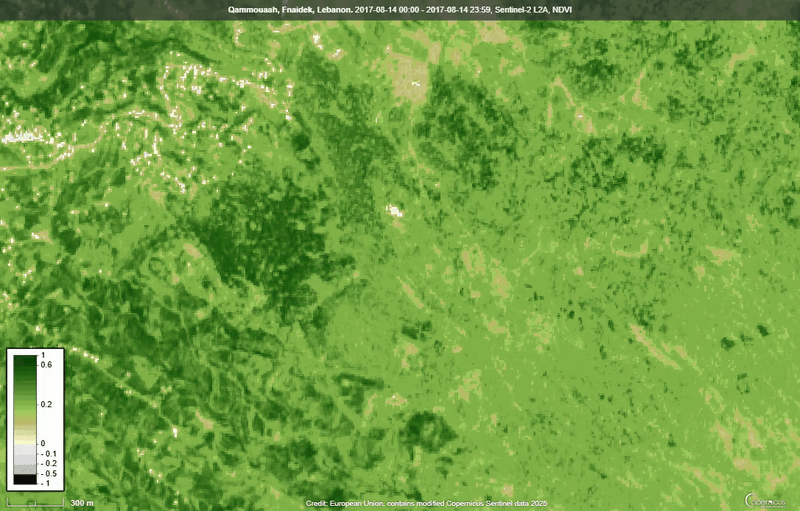
“مؤشّر الأوركيد” مهدّد
ينجلي التسيّب في الميدان، حيث نرى على طريق القمّوعة شاحنة تنقل رزم حطب. مشهد يثير أسى خالد طالب، الخبير في إدارة الغابات ومؤسّس جمعيّة “درب عكّار”. “هذه شجرة لزّاب”، يقول خالد لـ “مناطق نت” مقدّرًا عمرها بنحو 200 سنة.
ثم نلاحظ في بقعة من السهل أرضًا مجروفة حديثًا. ينتفض الشاب العكّاري قائلًا: “كان هذا مكانًا للأوركيد البرّي. جرفوه!”. يلتقط صورة: “لقد اعتمدنا الأوركيد مؤشّرًا للتنوّع البيولوجيّ ولعافية التربة في عكّار، لأنّ شروط نموّه صعبة، ويتطلّب بيئة خالية من التلوّث”.
“كلّ نوع من الأوركيد يعيش في موطن خاصّ، وعكّار وحدها تحتضن 66 من أصل 85 نوعًا مكتشفًا في كلّ لبنان. ومن هذا النبات نوع وحيد على الكوكب كلّه، وجدنا منه شتلة في القمّوعة”، بحسب طالب.

منذ العام 2013، تنظّم “درب عكّار” رحلات “هايكينغ” واستكشاف، وتتولّى الاستجابة الأوّليّة لإطفاء الحرائق، واستطاعت خلال عملها الميدانيّ توثيق أكثر 1000 عيّنة من النباتات النادرة من أصل 2700 نوع موجود في لبنان، ولم يكتمل بعد مسح المحافظة.
يوضح طالب: “المياه والنباتات والشجر مرتبطة بعلاقة تكافليّة تضمن توازن المنظومة البيئيّة. وأيّ إخلال بجودة أو كمّيّة المياه، سيضرب هذه المنظومة. حتّى الضباب الذي يلفّنا الآن، له دوره الخاص، فهو يحجب أشعّة الشمس المباشرة، ويؤمن الرطوبة للنبات والتربة”.
قلعة عروبة
بعد برهة، ينقشع الضباب عن قلعة عروبة، فتسلّقنا الجبل حتّى بلغناها. تتبلور من خلال القلعة ظاهرة طبيعيّة كارستيّة حفرتها الأمطار على صخور بلون الرصاص، فراكمت طبقات متراصفة، تتخلّلها فجوات وممرّات، بل متاهات. وفي كلّ خطوة، يتوقّف طالب عند خصائص لأعشاب وجدناها في ربع ساعة، وهي ذات قيمة بيولوجيّة عالية ونادرة.
كثير من هذه النباتات ينتمي إلى الفئات الطبّيّة والعطريّة، كذلك يمزج بالخلطات التقليديّة كالزهورات وأهمّها “الزوفا”، ومنها نوع نادر جدًّا، مثل الزوفا اللبنانيّة التي لا تنمو سوى في لبنان، فضلًا عن نباتات طبّيّة تمتلك خصائص مضادّة للالتهابات وللأكسدة مثل البرباريس اللبنانيّ، وهناك الزعفران الدمشقيّ، والذي يزهر في أيلول.
حديث حول الأشجار
يشكّل الشوح الكيليكيّ، السمة الغالبة على أحراج القمّوعة. يحتاج إلى شروط بيئيّة صارمة، وتحديدًا رطوبة عالية لينمو بشكل طبيعيّ في مراحله الأولى، ويعتبر من المؤشّرات البيئيّة الحسّاسة لنقص المياه. وآخر حدوده الطبيعيّة الجنوبيّة في الشرق الأوسط هي محميّة إهدن. ولشدّة التشابه لا يميّزه الزوّار عن الأرز، ولكنّ لونه داكن أكثر من الأرز، ويظهر في الربيع على رأسه “طربون” جديد بلون أخضر فاتح اللون، فترتسم على جبل القمّوعة خلال الربيع لوحة بديعة من التدرّجات الخضراء.
أمّا اللزاب، فالقمّوعة وحدها، تحتضن أربعة من أصل خمسة أنواع موجودة في عكّار. ويميّزها أنّها شجرة المرتفعات، إذ تعيش على ارتفاع يراوح بين 1000 و3000 متر، وتتعايش مع بقيّة الأنواع، بعكس سائر الأشجار التي تفرز مادّة صمغيّة تتسبّب في رفع حموضة التربة.
وهناك الجوز البرّيّ، المنتشر بشكل محدود جدًّا في لبنان، ولكنّ منطقة “جوز الدورة” الواقعة في جبل عروبة، اتّخذت اسمها من هذا الشجر، وهي أقدم موائله.
محميّة والتزامات مؤجّلة
على رغم هذا المزيج الفريد من الندرة والوفرة، تتواصل انتهاكات القمّوعة البيئيّة، مجسّدة نموذجًا متطرّفًا من تخلّي لبنان عن التزاماته الدوليّة بحماية البيئة، وفي طليعتها اتّفاقيّة برشلونة واتّفاقيّة التنوّع البيولوجيّ (CBD) واتّفاقيّة مكافحة التصحّر، والأدوات التكميليّة بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائيّة، وبروتوكول ناغويا بشأن الوصول والتقاسم العادل للمنافع، وبروتوكول المصادر البرّيّة، وبروتوكول المناطق المتمتّعة بحماية خاصّة.
ترجمت عهود حكوميّة سابقة التزاماتها البيئيّة، مستجيبة لمطالب من بلديتيّ فنيدق وعكّار العتيقة ومخاتيرها وضغوط من هيئات وأفراد مدافعين عن البيئة، فصدرت قرارات لحماية القمّوعة. لكن كلّ هذه القرارات بقيت خارج حيّز التنفيذ على رغم تتابعها منذ أكثر من عقدين.
بداية، اعتبرت القمّوعة “حمى وطني”، بموجب قرار وزير الزراعة 165/1، الصادر في 22/12/1991. وبعد خمس سنوات، أصدرت وزارة الزراعة القرار رقم 588/1 بتاريخ 30/12/1996 تعتبر فيه غابة الشوح والأرز واللزاب في القمّوعة “محمية” بموجب قانون حماية الغابات الصادر بتاريخ 24/07/1996. وفي عام 2002، اعتبرت القمّوعة “محمية طبيعية” بموجب القرار 19/1 الصادر عن وزارة البيئة.

كذلك طُبّقت إجراءات عديدة لمحاولة منع التعميرّ وبناء المنشآت على السهل، لكنها اخترقت بعد مدّة وجيزة، بخاّصة عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري العام 2005، إذ سادت الفوضى فاستثمرت للتحشيد الجماهيريّ وإقامة الأنشطة الرياضيّة والمهرجانات، وانتشر التعمير على غاربه ليغيّر بمعالم القمّوعة الطبيعيّة كلّيًّا بغياب التخطيط التوجيهيّ.
شكليّة القرارات
هذا المسار، يكشفه لـ” مناطق نت” خبير التنمية المستدامة محمّد عرابي، والذي يبيّن، علاوة على شكليّة القرارات، تناقض الممارسات الحكوميّة، يقول عرابي: “على رغم صدور أوّل قرارين لحماية القمّوعة، ناقضت الدولة اللبنانيّة نفسها في الخطّة التشغيليّة لوزارة الموارد المائيّة والكهربائيّة الصادرة العام 1999، وتضمّنت إنشاء بحيرة اصطناعيّة في القمّوعة، دون الاستناد إلى دراسة أثر بيئيّ أو جيولوجيّ. إذ تمّت مراجعة القرار في حينه مع وفد البنك الإسلاميّ المموّل لهذا المشروع، وتقديم شرح علميّ يبيّن مخاطر المشروع والعبث بجيولوجيّة الموقع الذي يعتبر بتكوينه الطبيعيّ مصدر مياه لكلّ عكّار، فألغي المشروع.”
نزاع فنيدق-عكّار العتيقة
في سياق متّصل، يشير عرابي إلى أنّ طلبات حماية القمّوعة المرفوعة من البلديّات، يأتي في خلفيّتها نزاع تاريخيّ مستمرّ بين عكّار العتيقة وفنيدق حول هويّة القمّوعة العقاريّة، وكلّ طرف يطلب حمايتها من الآخر. يعلّق آسفًا: “بينما ينشغل الطرفان في سرديّات ملكيّة القمّوعة، يستمر التعمير العشوائيّ على حساب أهمّيتها كمصدر مياه لكلّ عكّار واستدامة بيئتها وطبيعتها.”
يفصّل في خلفية النزاع، أنّه “يعود إلى عهد الانتداب الفرنسيّ؛ يؤكّد أهالي فنيدق أنّ القمّوعة امتداد طبيعيّ لبلدتهم، وكانوا يستخدمونها تاريخيًّا للرعي والزراعة قبل أن يُسجن وجهاؤها من قبل سلطات الانتداب الفرنسيّ، وبالتالي، مُسحت خلال إحصاء 1932 في غفلة منهم. صنّفها المسح حينها كمشاع جمهوريّ، وفي جزء من أطرافها لصالح أفراد من خارج فنيدق بموجب سندات محاصصة ومزارعة تمنحها الدولة لقاء بدل عينيّ، شرط التصرّف العلنيّ والهادئ. أمّا فنيدق، فتستند إلى نظام الملكيّة العقاريّة، والذي يجيز في المادّة 260، بسند أو بدون سند، اكتساب حقّ قيد التصرّف بالأرض بمرور عشر سنوات، شرط زراعة الأرض وبطريقة هادئة وعلنيّة”.
ويكشف مصدر مواكب لـ “مناطق نت” أنّ الخلاف تطوّر العام الماضي إلى نزاع مسلّح أسفر عن قتيلين. وعلى الأثر، دعا رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى مفاوضات في القصر الحكوميّ في أيلول (سبتمبر) 2024، أفضت إلى وثيقة تحصر الخلاف في جورة حروزا فقط، التي تشغل ربع مساحة القمّوعة، لكنّ الوثيقة لم توَقّع من قبل عكّار العتيقة.
في المحصلة، تبقى القمّوعة عالقة في مصير بيئيّ قاتم، تشهد عليه قرارات حكوميّة واهية، فيما تتواصل نزاعات الملكيّة، والممارسات الممنهجة لوضع اليد من أصحاب النفوذ المحلّيّين.