الفلسطيني وشجرة الزيتون منغرسان في الأرض الطيّبة

أضفى القرآن الكريم في سورة النور/ 35، الصفة المباركة على شجرة الزيتون. وحين أراد الفنان الفلسطينيّ ناصر سومي، المتولّد في سيَلة الظهر في تموز العام 1948، ونزيل فرنسا منذ العام 1980، أن يلملم ذاكرته، التي هي ذاكرة أهله صورًا وقطعًا وأشياء وحيوات، لم يجد أروع من شجرة الزيتون للكتابة عنها (دار النهار، 2011)، “شجرة النور” كما تجري العبارة باللسان الفلسطينيّ. وهي المرادفة لبلده، الحاضرة في معيش شعبه، والمقيمة في شغاف قلوبهم، المستقرة في وعيَهم، وما الدفاع عنها أمام الجرّافات الهادرة الكبيرة إلّا دفاعًا عن الأرض والعرض والهويّة.
يروي سومي “تاريخ شجرة الزيتون في فلسطين”، فيجدها سحيقة القِدم، قد عثر على آثار لها تعود إلى العصر الحجريّ القديم (من 35 ألف سنة إلى 12 ألف سنة) في إحدى مغاور جبل الكرمل.

فلسطين بيت شجرة الزيتون
يعتقد الباحث، إستنادًا إلى الدراسات أنّ ظروفًا مؤاتية، في أوائل الألف الخامس قبل الميلاد، سمحت بتدجين الكرمة وشجرة الزيتون، ولا سيَما أنّ المناخ في فلسطين (وسوريّا عمومًا) مناسب لزرعهما. فالنور الذي يتطلّبه الزيتون متوافر في هذه البلاد، وشجره يقاوم الجفاف ويتحمّل البرد، كما أنّ الزيتون “شجر قليل التطلّب”. وزُرع في فلسطين في نوعين من الأرض: الحمراء والكلسيّة، ويُقدِّر سومي أنّ الظروف المناخية تُعلّل اعتبار “فلسطين بيت شجرة الزيتون”.
قاد اكتشاف آثار الجران والمعاصر قرب حيفا، إلى الحدس بأن تدجين شجرة الزيتون والاستفادة منها يعودان إلى الألف الخامس قبل الميلاد كما أسلفنا. وفي شرق مدينة الرملة أيضًا عُثر على فجوات في الصخر استخدمت لعصر العنب والزيتون. وقد دفع الوضع الحضاريّ في الألف الرابع ق. م القائم في مصر وسوريّا وبلاد ما بين النهرين بفلسطين (بلاد كنعان) إلى النماء والإزدهار وإلى إقامة تبادل تجاريّ مع الجيران، ولا سيّما تصدير الخمر والزيت إلى مصر (لاستخدامه في التحنيط) في جرار خاصّة تسمّى “أبيدوس” تميّزت بالبساطة والرشاقة وتعدُّد الأشكال، مزيّنة باللون الأحمر.
قاد اكتشاف آثار الجران والمعاصر قرب حيفا، إلى الحدس بأن تدجين شجرة الزيتون والاستفادة منها يعودان إلى الألف الخامس قبل الميلاد.
ويُرجّح أنّ اليونان شجّعوا زراعة الزيتون في فلسطين، ويعزو إليهم الرحّالة العربيّ ابن الفقيه (القرن العاشر الميلادي) أصل زراعته في تلك الأصقاع. وحين وقعت هذه تحت حكم الرومان تابعوا الاهتمام بالزراعة، وخصوصًا الكرمة والزيتون، وازدهرت تجارتهما بفضل تقنيّات الريّ وإقامة السدود والتخصيب.
زراعة الزيتون بمواجهة الاحتلال
وحين وقعت فلسطين تحت سلطة “الانتداب البريطانيّ” (1920 – 1948)، شجّع اليهود وحالفهم لاحتلالها وتدمير القرى الفلسطينيّة (نحو 480 قرية) وتهجير سكّانها. فصودرت الأراضي المزروعة.
وينقل سومي احصاءً يقول: “إنّه في العام 1950 صودر نحو 137 ألف دونم زيتون في الدولة اليهوديّة الجديدة، قطع الإسرائيليّون منها 30 ألف دونم واستبدلوها بزراعات أخرى. ويٌقدِر أن 73 في المئة من مالكي الزيتون هم من الفلسطينيّين الصامدين في أرضهم بعد حرب 1948، وينتجون نحو سبعة آلاف طنّ من الزيت سنويًّا.”

تبدّى إصرار أهل فلسطين بعد الاحتلال على التمسّك بأرضهم في المثابرة على زرع شجر الزيتون. والمثل على ذلك أنّه وعلى الرغم من ضيَق مساحة غزة (370 كيلومترًا مربّعًا) وما قطعه العثمانيّون من الشجر، فقد بقي فيها نحو 11 ألف دونم.
وفي الضفة الغربيّة (مساحتها 5800 كيلومتر مربّع بما فيها القدس الشرقيّة) بلغ حجم زراعته 881 ألف دونم. ويُمثل زيت الزيتون، بحسب الدراسات، نحو 15 في المئة من الاقتصاد الزراعيّ، قسم مُعدّ للإستهلاك الداخليّ، والفائض منه للتصدير إلى الأردنّ والخليج وبعض الدول الأوروبيّة كإيطاليا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا وبلجيكا، وأيضًا الولايات المتّحدة الأميركيّة.
من الشجر إلى الحجر
وبسبب ظروف التخزين والنقل والعصر الحديثة التي قد تُقلل من جودة الزيت، اذ كان قديمًا يتمّ في المعاصر الحجريّة ويحفظ في الخوابي وفقًا للمثل الشعبيّ الفلسطينيّ “من الشجر إلى الحجر”، فإنّ المزارعين الفلسطينيّين يجهدون “لاستعادة الجودة التي اشتهر بها الزيت الفلسطينيّ من آلاف السنين”، بمساعدة من الجمعيّات الأهليّة والمنظّمات غير الحكوميّة.
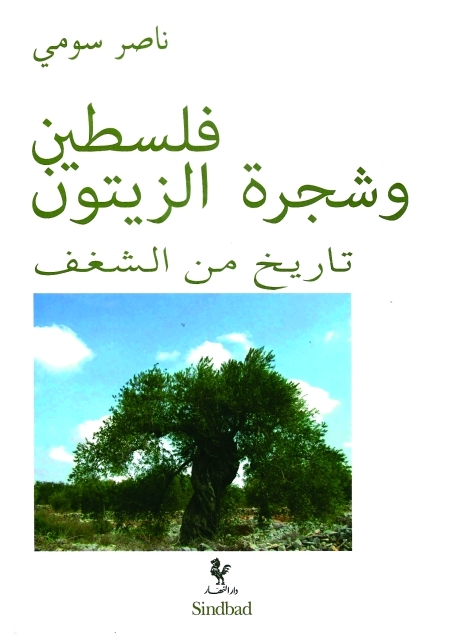
وبحسب الخبير الفرنسيّ، جان ماري بلدزاري، فإنّ الزيوت الفلسطينيّة “تتميّز بنكهات خفيفة نتذوّقها مختلطة في أوّل الأمر، ثم ما يلبث أن يتحوّل التذوّق تدريجًا من نكهات حمضيّة خفيفة في أوّل الفم، فنكهة قشر الجوز، فاللّوز الأخضر، إلى أن يصبح لها في آخر الفم مذاق البهار. وتبقى جميع هذه النكهات ثابتة مدّة طويلة. كذلك فإنّ فيها مرارة خفيفة. أمّا الحدَّة، فلا أثر لها تقريبًا”.
الزيتون في الأمثال والشعائر
يكلّمنا سومي عن “حضارة الزيتون”، المتغلغل في عيشهم اليوميّ غذاء ودواء، إلى حدّ اندراجه بكثرة في أقوالهم الشعبيّة، نظير: “الزيت عماد البيت”، “إن لسَّن الزيتون بشباط حضّروا له البطاط”، “إن لسّن الزيتون بآذار هيأوا له الزيار” ( مفردها زير وهي نوع من الجرار، وذلك لأنّ الموسم واعد)، “إن أخرج الزيتون بنيسان حضروا له الفنجان” (دليل موسم قطاف سيّء)، و”حنطة وزيت: أسدين بالبيت”، “كول زيت وهدّ الحيط”. وموسم قطاف الزيتون عيد عند الأسرة ويعكس التضامن العائليّ وحسن التنظيم، ويرافقه جو من الفرح والغناء.
والحال، زيت الزيتون موجود في الشعائر المتوارثة من أيّام الكنعانيين، فما أن يرى الطفل الحياة “حتّى يُمسّد بزيت الزيتون، بحسب التقاليد القديمة، بالزيت والملح، ثم بالزيت والحبق المفروم”، وفي الأساطير السائدة في الشرق، أنّ سكب الزيت على الرأس هو علامة فرح، ووفرة الزيت مُعادل لانبعاث البعل وللخصب.
يكلّمنا سومي عن “حضارة الزيتون”، المتغلغل في عيشهم اليوميّ غذاء ودواء، إلى حدّ اندراجه بكثرة في أقوالهم الشعبيّة، نظير: “الزيت عماد البيت”، “إن لسَّن الزيتون بشباط حضّروا له البطاط”، “إن لسّن الزيتون بآذار هيأوا له الزيار”، وغيره من الأمثال.
ولشخصيّة الخضر (أو القدّيس مار جرجس) في المعتقد الشعبيّ سِمات البعل نفسها، ويحظى بشعبيّة كبيرة عند الفلسطينيّين، مسلمين ومسيحيّين، ولا تزال “صلاة الزيت” تُقام في مقاماته وكنائسه يوم الأربعاء الذي يسبق “خميس الأسرار”. واقترنت شجرة الزيتون في وعي الفلسطينيّين بالأنبياء والقدّيسين، يشهد على ذلك جبل الزيتون في القدس، اذ يُظن أنّ الشجرات تعود إلى عهد السيَد المسيح .
إلى ذلك، ثمّة ظنّ عند الفلسطينيّين بالقدرة الشفائيّة للزيت، إلى تقديمه نذورًا أيضًا للمقامات، كما الحال مع مقام “ستنا بدريّة”، الواقع في قرية شرفات إلى الغرب من القدس، الذي تتوجّه إليه النساء بالدعاء طلبًا لعودة أبنائهنّ المهاجرين إلى الأميركيّتين، بالقول: ” يا ستنا البدريّة! نذراً عليّ جرّة زيت لو رجع ابني في أميركا سالم عالبيت”.
ولا يزال التداوي بالزيت شائعًا لدى عامّة الناس، كما عادة إضاءة الكنائس والمساجد بزيت الزيتون المحضّر بحسب الطريقة التقليديّة القديمة. وقد حافظ الفلّاحون الفلسطينيّون على نمط حياة موروث من العصور القديمة، ومن ثمّ أتى الاحتلال الإسرائيليّ للأرض ليقضي على نمط الحياة الوادع هذا.
زيتون رديف الهويّة
وإلى الاستهلاك المنزليّ وإضاءة المقامات، يستخدم الزيت في إنتاج الصابون (الغاسول في اللغة العربيّة)، وتحتلّ مدينة نابلس المقام الأوّل في عدد المصابن. ولأنّ البركة كاملة في شجر الزيتون، فقد استغل الحرفيّون الفلسطينيّون خشبه لصنع أجمل المنحوتات.

كما حضرت شجرة الزيتون في بعض أعمال الشعراء والأدباء رديفًا للهوية الفلسطينية، فكتب لها محمود درويش: لو يذكر الزيتون غارسه/ لصار الزيت دمعًا! / يا حكمة الأجداد/ لو من لحمنا نعطيك درعا! / لكن سهل الريح،/ لا يُعطي عبيد الريح زرعا! / إنّا سنقلع بالرموش/ الشوك والأحزان…قلعا!/ وإلامَ نحمل وعارنا وصليبنا!/ والكون يسعى../ سنظلّ في الزيتون خضرته،/ وحول الأرض درعا!!.
وحبّر لها سميح القاسم: منتصب القامة أمشي / مرفوع الهامة أمشي/ في كفّي قصفة زيتون/ وعلى كتفي نعشي.
وثمة من يكره الزيتون
وبقدر شغف الفلسطينيّ بشجرة حياته، بقدر كره المستوطن المحتلّ لها، لأسباب منها قدومه من بلاد باردة لا تعرفها، وحاجة هذه الشجرة إلى العمل اليدويّ التقليديّ. في حين يبحث هو عن الإنتاجيّة السريعة بالعمل المؤلّل.
ومنذ العام 1976 اقتلع ما يزيد على مليون ونصف المليون شجرة، وثمّة سياسة عدوانيّة مُتّبعة تستهدف تخريب موسم قطاف الزيتون، ومن حقد الاحتلال على هذه الشجرة المباركة بات يقتلعها بالجرّافات الضخمة من جذورها لكي لا تنبت من جديد.
لا تنفصل قصّة الزيتون عن قصّة زارعها ومقلّمها ومُستخرِج زيتها، فكأنّ الفلسطينيّ وشجرة النور المباركة هذه صنوان، مغروسة جذورهما معًا في الأرض، مُكرّسان لوهب الخيرات.
وبعد أن نقرأ “قصّة الشغف” كما يرويها سومي نفهم أنّ غصن الزيتون الذي حمله الزعيم الفلسطينيّ الراحل، ياسر عرفات (أبو عمّار)، يومًا في الأمم المتّحدة كان فلسطين، الرمز والإشارة إلى البلاد المغتَصبة بغير وجه حقّ، ويستحقّ أبناؤها حياة كريمة تشبه كرامة شجرة الزيتون.






