في رثاء خالقي الأثر.. عن موت الكتّاب والشعراء في غزّة

أشاهد الأحداث التي تتسارع أمامي على شاشة التلفاز، وأفكّر أنَّ لديّ مُتسع من الوقت لأحزن، ولأنتحب على من يفارقنا، أو ربّما أشعرُ بوجوب الحزن لأسباب تاريخيّة وأنثروبّولوجيا ترتبط بالمراسم وبالطقوس الجنائزيّة، التي نجتمع فيها نحنُ البشر ونمارسها تكريمًا للميّت.
أنا اليوم جالسة أمامَ تلفازي، وأشعرُ بأنَّ البكاء عندَ الموت إحساس إنسانيّ عام، لكن أعلم بأنَّ المراسم خاصّة جدًّا كمّا يذكّرنا الكاتب توم لوتز، وأنَّ عليّ أن أقيم انتحاب للأجساد المتناثرة كالنجوم ذلك أنَّ أهلها مشغولون بالنجاة، ولأنَّ الحزن صارَ ترفًا عندهم.
في كتابه “تاريخ الدموع” يقول توم لوتز إنَّ لسكّان جزيرتيّ أندامان، الواقعتين قبالة سواحل تايلاند وماليزيا، عادة غريبة، ذلك أنّه عندما ينفصل صديقان أو قريبان عن بعضهما فإنّهما يقومان بطقس انتحابيّ يشبه طقس ابتهاجهما عند رؤية بعضهما مجدّدًا بعدَ عدّة أسابيع: “يجلس الاثنان على الأرضيّة، أحدهما في حضن الآخر، وأذرع بعضهما حول رقبتي بعض ويبكيان أو ينوحان معًا عدّة مرّات”.
أنا اليوم جالسة أمامَ تلفازي، وأشعرُ بأنَّ البكاء عندَ الموت إحساس إنسانيّ عام، لكن أعلم بأنَّ المراسم خاصّة جدًّا كمّا يذكّرنا الكاتب توم لوتز، وأنَّ عليّ أن أقيم انتحاب للأجساد المتناثرة كالنجوم.
أفكّر مرّة أخرى وأنا لا أزال أشاهد الأحداث المترامية أمامي، في أنَّ الذين كتبوا عن المراسم، غفلوا الكتابة عن الجنائزيّات التي لا تُقام، وعن الانتحاب الذي يُقام بالنيابة عن الذين ليسَ بوسعهم الانتحاب.. هذا نصّ لانتحاب الموتى، شعراء وشاعرات، كتّاب وكاتبات غزّة، ذلك أنّه من غير العادل أن تباغتهم/نَّ الفاجعة من دون أن يكون هناك مُتسّع من أن أحمل عبء هذا الحزن التاريخيّ ولا أترجمه هنا في هذا النصّ.
عن معنى الأدب والشعر في الحالة الفلسطينيّة
في كتابها “الاعترافات”، تسعى الكاتبة الإسبانيّة إيزابيل الليندي إلى الولوج في معنى الواقعيّة في الأدب، وتُبحرُ إيزابيل مع القارئ في رحلة بقاربها لتقول لهُ بكلّ بساطة إنَّها لا ترسم في كتبها حدَّا فاصلًا بين الواقع والخيال. إنها ربما دعوة لاكتشاف ما وراء الكلمات والأشياء والأحداث والنبش في الكنوز المخفيّة، وما بين السطور عن جزيّئات الحقيقة كما تسمّيها.
وإذا ما عرجنا قليلًا إلى كتابات إدوار سعيد الفكريّة، ككتاب “الاستشراق” على سبيل المثال، فإنّنا سنرى أنَّ سعيد يستعين بالقصص والروايات ويستنطق الأدب خدمة لدراساته التاريخيّة والاجتماعيّة والسياسيّة ومن أجل أن يفسرّ الواقع المدروس، ذلك أنَّ الأدب يمكن أن يضجّ بالصراخ في وجه الواقع، أو أن ينمو معه، أو أن يعيد قراءته دونَ أن يتحوّل إلى صحافة.
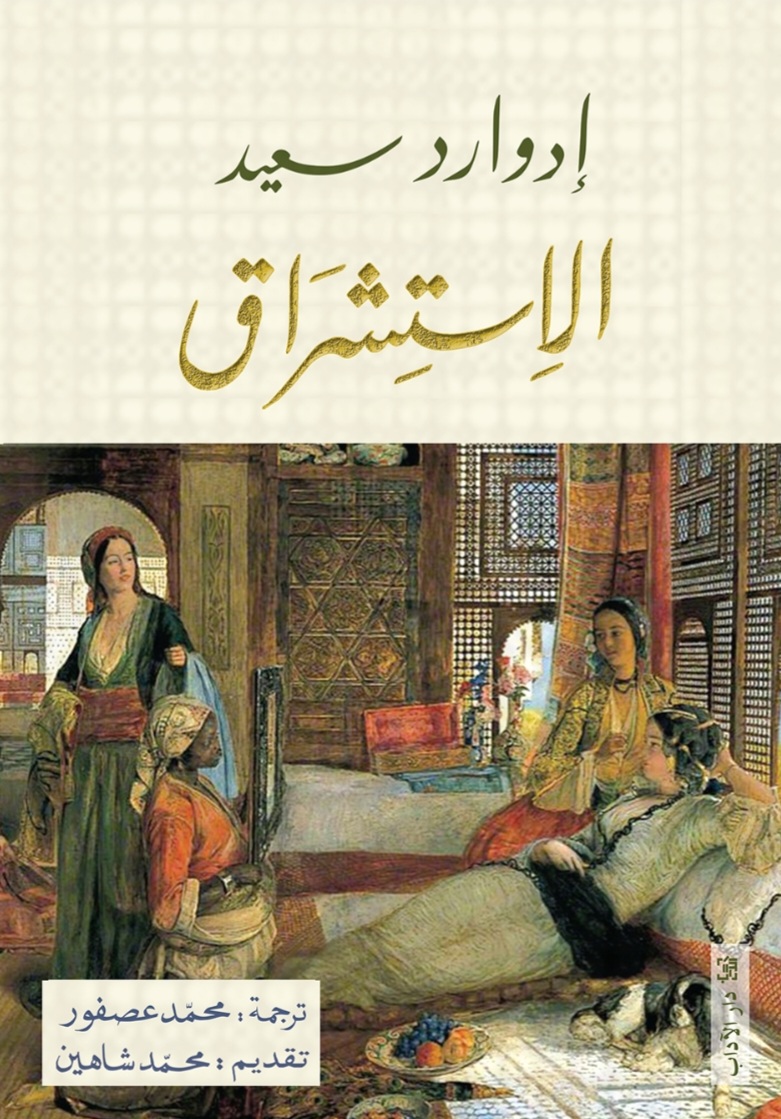
وفي الحالة الفلسطينيّة، تحديدًا في الحالة التي يعيشها أدباء وشعراء غزّة، فإنَّ الأدب يتحوّل معهم إلى مرآة لواقعهم الذي فُرضَ عليهم بسبب الاستعمار. وعطفًا على ذلك، تقول إيزابيل إنَّ الأدب يمكن أن يعكس ما يحدث بشكل أفضل من الصحافة، فكتاب “خريف البطريك” للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز، يقول عن ديكتاتور أميركا اللاتينيّة أكثر من أيّ وقائع يستطيع أيّ شخص الشروع في كتابتها.
وفي الحالة الفلسطينيّة أيضًا يمكن القول إنَّ الأدب المتاخم للواقع والخيال في آنٍ واحد، ذلك أنَّ الخيال يختلف كثيرًا عن الفانتازيا، يُمَكّن هواة الأدب والشعر، وناسجي القصص من تحمّل الحياة التي يعيشونها داخل أكبر سجن عُرفَ في القرن الواحد والعشرين.
ويذكر صاحب كتاب “فنّ الرواية” كولن ولسن، قصّة طريفة تتقاطع مع ما أقوله، وهي حادثة حصلت في رواية “جذور السماء”، للكاتب رومان غاري، ففي أحد معسكرات الاعتقال الألمانيّة، يقترح أحد السجناء الفرنسيّين الذين يعيشون بوضع كارثي داخل السجون، في أن يلعبوا لعبة، بأن يتخيّلوا امرأة فائقة الجمال في كوخ تحدقّ بهم في كلّ وقت وفي كلّ ساعة، داخل المعسكر، في الممرّات، أثناء الطعام وأثناء النوم.
وإذا ما أرادَ أحد السجناء الشتم أو التذمرّ فإنّه ينحني ويعتذر. ومع مرور الوقت تحوّلت هذه اللعبة إلى أداة لمقاومة ما يهدف له الألمان من تثبيط معنويّات السجناء الفرنسيّين. وحينَ يكتشف القائد الألمانيّ في التحقيق أمر اللعبة، يأمرهم بأن يسلّموهُ المرأة. ويسرد غاري في روايته هذه، أنَّ الفرنسيّين رفضوا تسليم المرأة، تسليمًا رمزيًّا ذلك لسبب واضح جدًا، فالمرأة قد ترحل إلى الأبد، وهم وهبوا خيالهم لها، ويستحيل إعادة إبداعها مرّة أخرى.
في الحالة الفلسطينيّة يمكن القول إنَّ الأدب المتاخم للواقع والخيال في آنٍ واحد، ذلك أنَّ الخيال يختلف كثيرًا عن الفانتازيا، يُمَكّن هواة الأدب والشعر، وناسجي القصص من تحمّل الحياة التي يعيشونها داخل أكبر سجن عُرفَ في القرن الواحد والعشرين.
ويقول غاري إنَّ السجناء استطاعوا الاحتفاظ بهذه الشريكة، التي تذكّرهم بواقع أعمق بكثير من المعسكرات، وبسرّ أعمق لدوافعهم في الحياة إذا ما استعرنا العبارة من الكاتب كولن ولسن.
وعودةً إلى الحالة الفلسطينيّة، لم يقم الإسرائيليّ باستدعاء العقاب لإنهاء هذه اللعبة الخطيرة، بل راحَ أبعد من ذلك، لقد قتل الكثير من الأدباء والشعراء وهذا ما لم يفكّر بهِ الألمان في معسكراتهم، لكيّ لا يعلن عن هزيمته أمامَ الذين ينسجون خيالهم من هذا الواقع اللامعقول، وربّما، خوفًا من أن يعرّي هذا الفنّ حقيقته الوحشيّة، وربّما أيضًا، احترازًا من التاريخ.
عن الموت والفاجعة
شرَعَ الفيلسوف الألمانيّ تيودور أدورنو، في القول إنَّه لم يعد من الممكن كتابة الشعر بعد أوشفيتز. وبأنَّ الكلمات بعدَ المحرقة تستحيلُ، ذلك أنَّ هول الهولوكوست حال دونَ قيام الكتّاب والشعراء بوصفها. لكن تراجع أدورنو بعد عدّة سنوات عن كلامه ليقول إنّه من المنطقيّ جدًّا أنًّ “للمعاناة الحقّ في أن تعبّر عن نفسها، كما للرجل المعذّب أن يصرخ من الألم”.
وهذا ما جسّده ونجح به الشاعر “باول تسيلان” بحسب بعض النقّاد، في قصيدته Todesfuge “فوغا الموت” وتعني الفوغا قالبًا موسيقيًّا، وهي كلمة مرتبطة بالـ fugere أيّ الفرار وبكلمة Fugare أيّ المُلاحقة، للدلالة على أنَّ الأصوات تطارد بعضها بشكلٍ من الأشكال. وربّما اختار تسيلان الناجي من المحرقة، هذا العنوان المُكثّف بالمعاني والرمزيّات ليصف هول المأساة التي عاشها في الهولوكوست وما تَبِعها من موت والديه فيها.
وإذ ما عرجنا إلى الحالة الفلسطينيّة، للحديث اليوم عن الإبادة الجماعيّة التي يتعرّض لها سكّان غزّة، لا بدّ من السؤال عن: من سينجو من المحرقة ليتكلم عنها أصلًا؟ أو ليصفها؟
ربّما لو قُتلَ جميع الشعراء والكتّاب في غزّة، فسيبقى الأثر كالشبح يطارد من قتلهم إلى الأبد. وربّما باستطاعتنا القول إنَّه في الحالة الفلسطينيّة موت الكتّاب والشعراء في غزّة هو امتداد للتاريخ، وللذاكرة، وللحياة وللحداد وللانتحاب أيضًا.




