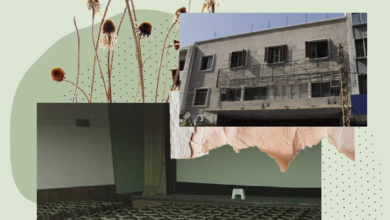مرجة رأس العين في أحوالها المتبدّلة (2)

لا شيء يبقى كما هو على هذه البسيطة. حتّى الجبال التي يُخيل إلينا أنّ مظهرها سرمديٌّ، تطاولها آثار الزمن مع مرور الوقت. “المادة لا تفنى ولا تُستحدث، بل تتغيّر من شكل إلى شكل آخر”، قال أنطوان لافوازييه، العالم الفرنسيّ الذي يُعتبر أبا الكيمياء الحديثة.
هذه العبارة حفظناها عن ظهر قلب، حين كنّا لا نزال تلامذة في الصفوف التكميليّة، وبقيت في ذهننا كذكرى لأعوام لم نرَ فيها الأمور كما نراها الآن. تلك هي حال المدينة ومرجتها الشهيرة، التي صمدت خلال عقود، مع بعض التغيّرات التي أحدثتها بلديّة المدينة، لكنّها “بقيت في مكانها”، ولم تتزحزح منه.
أمّا الذي تغيّر إلى غير رجعة فهي المدينة نفسها، في معظم وجوهها. المدن الكبيرة وحتّى الصغيرة في الغرب، على سبيل المثال، أو حتّى في بعض البلدان المحيطة بنا، تبقى كما هي قدر الإمكان، أقلّه حين يتعلّق الأمر بمراكزها القديمة، وبأنحائها ذات القيمة التاريخيّة والتراثيّة. يحافظ القائمون على تلك الأمكنة، ولا يبخلون بالموارد المادّيّة التي تساعد في عمليّات ترميمها، على اعتبارها إرثًا سوف تفخر به الأجيال القادمة، وسيذّكّرها بلحظات عاشها أجدادهم.
الذي تغيّر إلى غير رجعة فهي المدينة نفسها، في معظم وجوهها. المدن الكبيرة وحتّى الصغيرة في الغرب، على سبيل المثال، أو حتّى في بعض البلدان المحيطة بنا، تبقى كما هي قدر الإمكان، أقلّه حين يتعلّق الأمر بمراكزها القديمة، وبأنحائها ذات القيمة التاريخيّة والتراثيّة.
شغف الصور القديمة
أكثر ما تبقّى من بعلبك القديمة صور بالأسود والأبيض يتناقلها الأفراد، وقد جمع أحدهم بعضها في أرشيف، وينظر إليها من يغار على المدينة نظرات ملأى بحنين صامت، وبحزن تعود أسبابه إلى ما آلت إليه المدينة في وضعها الحالي.
هذا الكلام قد يبدو مبالغًا فيه بالنسبة لجيل لم يعرف بعلبك خلال الفترة الممتدّة بين خمسينات القرن الماضي ومنتصف ثمانيناته. وإلاّ فكيف يمكن تفسير هذا الشغف بصور المدينة القديمة، وتباهي البعض بامتلاك النادر منها؟ صور تفوح منها رائحة الهدوء والسكينة، ويرتسم عليها الاتساع المريح لطرق المدينة وساحاتها، مع قامات بشريّة قليلة العدد تتنقّل بين أرجائها.
“يتحزّر” مشاهدو الصور حول هويّة هذا المكان أو ذاك، بعدما لم يبقَ من معالمه ما يشير إليه في شكل جازم، وهذا الأمر ينطبق على مرجة رأس العين. صور المرجة القديمة لم يهتمّ ملتقطوها بالمشهد الطبيعيّ، بقدر ما وثّقت للحظات تاريخيّة ذات طابع مدرسيّ أو اجتماعيّ. وقد ظهر في بعضها رجال ونساء وأطفال يقفون وسط العشب، مع شجرة قليلة الارتفاع في الأفق، وربّما شجرتين أو ثلاث. الحاضرون في الصورة يقفون وقفة “عسكريّة”، ومن الواضح أنّهم تجمّدوا في أمكنتهم، كما طُلب إليهم، في زمن لم تكن آلات التصوير الفوتوغرافيّ ذات دقّة كبيرة وحساسيّة عالية. وجوه الحضور عكست غبطة أو بسمة خفيفة، وأيادي بعضهم تلتقط طرف غصن نبتة، أو شجرة صغيرة.

البساطة المحبّبة المميّزة لذاك الزمن تضاءلت مع الأيّام، إلى أن اختفت تمامًا. كان سكّان المدينة يقصدون رأس العين مشيًا على الأقدام من منازلهم، حتّى البعيدة منها. لم يكن السير وسط الطريق، نظرًا لانعدام الأرصفة حينذاك، أمرًا مستغربًا، كما لم يؤدِّ ذلك إلى عرقلة ما، في زمن كان عدد السيّارات التي تخترق الطريق خلال الأمسية لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.
إلى ذلك، كان الجلوس على العشب، أو التنقّل بين أرجاء المكان تقليدًا لطالما ذكّرتني به أعمال فنّيّة انطباعيّة، كلوحة “غداء على العشب” لإدوار مانيه (التي أثارت فضيحة في حينها لأسباب لا مجال لذكرها)، أو لوحة La grande jatte لبّول سينياك. توزّع المتنزّهون على الطريق الذي يحيط بالمرجة كحزام في جماعات، وكان من النادر أن ترى أحدهم يتنزّه بمفرده، سوى بضعة اشخاص عُرف حبّهم للعزلة، وذلك في مدينة يعرف معظم سكانّها بعضهم بعضًا. لذا، فقد كان، أن كثرت التحيّات بين المتنزّهين، وازدادت الإلفة بينهم، وخصوصًا لكون المرجة ومحيطها كانا شكّلا نقطة التقاء، من دون موعد مسبق، لفئات كثيرة من ساكني المدينة.
مرجة الزمن الحاليّ المتغيّرة
هذه الحال صارت من الماضي، ولم يبقَ لها أثر سوى في ذاكرة من عايش تلك الفترة، التي امتدّت، ولو ضمن مستويات مختلفة، حتّى نهاية ثمانينات القرن الماضي وبداية تسعيناته. إزداد عدد سكّان المدينة بشكل مضطرد وغير عاديّ منذ ذلك الوقت. يعود السبب في ذلك إلى نزوح جماعات بشريّة كبيرة من القرى المحيطة بالمدينة واستيطانهم ضمن حدودها. وللمفارقة الغريبة، التي نشهدها في الوقت الحاليّ، الذي تطغى عليه أوضاع اجتماعية متدهورة، فإنّ الكثيرين من شباب المدينة يسعون إلى الهجرة بكلّ قواهم، على اعتبار كونها، ربّما، أحد الحلول الافتراضية لمشكلاتهم المتفاقمة يومًا بعد يوم.
هذا، في حين أنّ سكّان القرى ينتقلون إلى بعلبك، ويستقرّون فيها، على اعتبار أنّ السكن في المدينة لطالما شكّل حلمًا بالنسبة إليهم، وذلك بعيدًا من محيطهم الصغير المنغلق، ولكون فرص العمل، في حال وجودها، ستكون أكثر واقعيّة، وأيضًا بفعل توافر وسائل التسلية في المدينة، وسهولة إهدار الوقت الذي لا ثمن له ولا قيمة في بلادنا.

أدّت الهجرة المذكورة إلى تغيير ديموغرافيّ في الطبيعة السكّانيّة، وفي الثقافة المدينيّة نفسها. فللمدينة ثقافتها، كما نعلم جميعًا، وقد يكون أوّل بنودها هو الحفاظ على المدينة كمركز جامع، والتمتّع بشكل من أشكال الانتماء، الذي يتطلّب جملة من الواجبات وأنواع السلوك تجاه الأملاك العامّة، وتجاه الأفراد الآخرين. هذا الانتماء بقي بعيدًا من بعض جماعات الوافدين، وتوحي تصرّفاتهم بضعف العلاقة الوثيقة بالمدينة وبتاريخها، وبانعدام الرغبة في بناء هذه العلاقة.
خروج على السياق
وفي حين أنّ سكّان القرى تميّزوا دائمًا ببساطتهم المحبّبة، وبالتعامل اللائق والكريم مع الآخر، فإنّ بعض من وفدوا إلى بعلبك (مع التركيز على كلمة “بعض”) خرجوا عن هذا السياق، وحلّت النزعة العشائريّة لديهم مكان لياقة سكّان القرى ودماثتهم.
وكي نكون منصفين في حكمنا، فلا بدّ من الإشارة إلى أنّ بعض سكّان المدينة الأصليّين (ونركّز مرّة أخرى على بعض) “ما بيشكوا من شي”، إذ سار هؤلاء في موجة اللامبالاة تجاه كلّ شيء، بما في ذلك تجاه مصلحة مدينتهم، والسعي إلى الاهتمام بشؤونها.
وبما أنّ رأس العين ومرجتها تعتبر أحد مرافق المدينة الأكثر ارتيادًا، فقد انعكس عليها كلّ ما تمّ ذكره. لم يعد مفهوم النزهة، المتعارف عليه، قائمًا إلاّ لمجموعة قليلة من الخليقة. جلّ هؤلاء يقصدون المكان صباحًا، سيرًا على الأقدام، إمّا من أجل تنشّق الهواء النظيف، وإمّا بهدف ممارسة رياضة المشي، إذ يمثّل محيط المرجة مكانًا مناسبًا لهذا الهدف.
تميّز سكّان القرى ببساطتهم المحبّبة، وبالتعامل اللائق والكريم مع الآخر، لكن بعض من وفدوا إلى بعلبك (مع التركيز على كلمة “بعض”) خرجوا عن هذا السياق، وحلّت النزعة العشائريّة لديهم مكان لياقة سكّان القرى ودماثتهم.
أمّا أولئك الذين يفترشون المرجة خلال الأمسيات في بعض المناسبات، وخصوصًا في الأعياد، فهم في معظمهم ممّن لا يمتلكون حافلات، أو من النازحين السوريّين، ممّن يبحثون عن فسحة تعوّض أوقات البقاء الطويلة في منازلهم المستأجرة الضيّقة.
لكنّ “الحفلة الكبرى” تبدأ منذ ساعات المساء الأولى، إذ ينحسر المشاة، ويخلون المكان للسيّارات التي تدور وتدور حول المرجة والبيّاضة مرّات عدّة، طالما أنّ أصحابها يمتلكون القدرات المادّيّة على تزويد حافلاتهم بمادّة البنزين. كنّا قد أطلقنا على هذه العمليّة تسمية “الطواف”، وتبنّى التسمية العديد من معارفنا، وغير معارفنا.
أما في ما يتعلق بالوقود اللازم للقيام بهذه الرحلة الدائريّة السرمديّة، فيبدو أنّ أصحاب السيارات، الذين لا نعرفهم شخصيًّا في معظم الأحيان، ولا علم لنا بطبيعة أعمالهم، لكنّهم يعرفون بعضهم بعضًا، ويعرفهم أصحاب كيوسكات “الإسبرسّو” المنتشرة على حواف الطريق، نقول: إنّ هؤلاء لا يعبأون بثمن الوقود المحترق بلا معنى، ممّا يشير إلى أوضاعهم المادّيّة الجيّدة، ذات المصادر المجهولة، بل تنحصر مهمّتهم بقيادة حافلاتهم ببطء شديد، وهواتفهم النقّالة لا تفارق راحاتهم.
حفلة صخب وجوقة طرشان
أمّا من “يعْلَق” خلفهم وسط الزحام، ممّن يقصدون مكانًا ما للضرورة، خارج إطار النزهة الآليّة، فعليه أن يتحلّى بصبر شديد، وأن يتحلّى كذلك بنعمة السكوت عمّا يراه ويعانيه، إذ إنّ الاحتجاج، من خلال إطلاق “الزمّور” مثلًا، أو توجيه ملاحظة ما، قد يودّي إلى عواقب وخيمة.

هكذا، لا يعود من الممكن الحديث عن نظافة الهواء المسائيّ، الصالح لنزهة على الأقدام، فالدخان المنبعث من السيّارات كافٍ لتلويث الهواء على نحو ملحوظ، ناهيك عن الضجيج الناجم من محرّكاتها، وصوت الموسيقى الصاخب الصادر عن أجهزتها السمعيّة. كما لا تعود العبارة التي تفيد بأنّ منطقة رأس العين هي رئة بعلبك ذات معنى، فهذه الرئة امتلأت دخانًا وهواءً ملوّثًا.
وفي ما يخصّ التلوّث السمعيّ، فلا بدّ من أن نضيف أصوات حافلات “التوك توك” التي انتشرت كالفطر في شوارع المدينة، والتي يقودها سائقون شبّان متهوّرون، بعضهم ما زال في سنّ المراهقة، وقد ورث هؤلاء عادات سائقي التاكسي السيّئة، كـ”المطاحشة” وسواها. إلى ذلك، يُضاف صراخ الأطفال الذين استحدثت لهم زاوية للألعاب في الناحية الشرقيّة من المرجة، بعدما اقتلع منها عشب المرج وفُرشت رملًا، ونُصبت فيها مراجيح ومزحلقات.
وبالرغم من الناحية الإيجابيّة لهذا التدبير، من حيث إيجاد مصادر تسلية للأطفال، فهو لم يأتِ في صالح الباحثين عن بعض السكينة، ولا نقول عن الكثير منها، نظرًا لواقع الحال. وإذ يتوجّب أن نذكر الوقائع كلّها، قدر الإمكان، فلا بّد من الإشارة إلى أنّ الرصيف المحيط بالمرجة، المخصّص للمشاة، قد تحوّل بدوره مرتعًا للدرّاجات الناريّة ولزعيقها، التي يجول أصحابها على طول الرصيف، وبسرعات واضحة أحيانًا، وذلك من دون حسيب أو رقيب.
بناء على ما أوردناه، يمكن القول إنّ المرجة ومحيطها لم يعودا مكانًا ملائمًا لنزهة على الأقدام، بل مكانًا يعمّه الضجيج والفوضى، إضافة إلى سلبيّات أخرى لا ضرورة لذكرها. وإذ يوجّه أحد أصحابنا، وهو من محبّي الهدوء كحالنا، أصابع الاتهام إلى الوافدين (وتلك وجهة نظره التي لا مجال لمناقشتها الآن)، فهو صاحب العبارة التي ذكرناها في الجزء الأوّل من مقالنا، حين قال: “يا أخي خليهن يفكفكوها وياخدوها .. ما عاد بدنا ايّاها”، والمقصود بالطبع هي مرجة رأس العين ليس سواها.