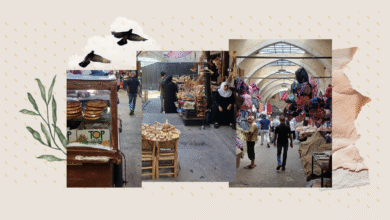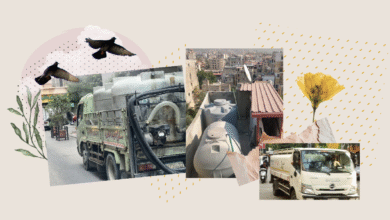كتابات الجدران من شعارات الحرّيّة إلى بصمات الاحتلال

لم تكن الجدران يومًا حياديّة، فهي دفتر الذاكرة الجماعيّة التي تحمل حكاياتنا وندوبنا معًا. وإذا كانت قد احتضنت سابقًا شعارات الحرّيّة وأسماء العشّاق، فإنّها في القرى الحدوديّة اليوم صارت مشوّهة ببصمات الاحتلال العدائيّة ورسائله التخويفيّة. تحوّلت من مساحة للتعبير عن الحياة إلى مرآة للعنف والتهديد، لتبقى شاهدة على محاولاته محو الهويّة وزرع الخوف في النفوس.
لطالما شردت مع أغنية خالد الهبر “يا سنديانة حمرا”، تلك الأغنية التي لم تكن مجرّد لحن وكلمات وموسيقى، بل ذاكرة كاملة تختزن وجوه المقاومين الذين مرّوا من هنا، فتختصر حكاياتهم. كلّما ردّد “يا عمر اللي ماتوا اللي ماتوا ع بكّير”، كنت أستحضر أرواح الذين رحلوا باكرًا، وأتخيّل المقاعد الفارغة على موائدهم، حيث بقيت الأطباق تنتظر أصحابًا لم يعودوا. هؤلاء صاروا جزءًا من الأرض، ومن حجارتها، ومن هوائها، ومن ترابها.
عندما يصل خالد إلى مقطع “إيّام اللي كنتو قلال، إيّام المصانع إيّام العمال، إيّام اللي كانت صعبة الكتابة على الحيطان”، نعود إلى زمن كانت فيه الجدران دفترًا، نكتب عليها ما لا نستطيع أن نقوله جهرًا، نلوّنها بالرفض والمقاومة، لنغطّي الإسفلت والأحجار في الأزقّة بشعارات الحرّيّة والتمرّد.
تلك الكتابات لم تكن مجرّد حروف، كانت ثورة مؤجّلة في العلن، ورسائل مشفّرة من جيل إلى جيل
نوستالجيا
تلك الكتابات لم تكن مجرّد حروف، كانت ثورة مؤجّلة في العلن، ورسائل مشفّرة من جيل إلى جيل. في بيروت، كما كلّ منطقة تعبت من الطائفيّة واللادولة، كانت الجدران تتحوّل مساحة حرّة حين تُغلق كلّ المنابر في وجهنا.
الجدران لم تقتصر على السياسة فقط، بل احتضنت الحبّ أيضًا. من منكم لم يقرأ أسماء العشّاق على جدران الطرقات؟ كم من أسماء سُطّرت على الإسمنت كأنّها تعويذة ضدّ النسيان؟ كنّا نقرأ تلك العبارات كجزء من يوميّاتنا، نضحك أحيانًا، ونتأمّل أحيانًا أخرى في حبّ محاصر أو صرخة في وجه سلطة.
الساديّة الإسرائيليّة
الاحتلال، بعادته يشوّه كل ما يدركه ويقع تحت يديه، والأداة التي اعتدناها أداةً للتعبير عن الحبّ والحرّيّة صارت فعلًا من الشيطان. في القرى الحدوديّة، صارت الحيطان شاهدة على عنفهم، ملطّخة بكتابات لا تعبّر إلّا عن حقد وعنصريّة وادّعاءات فارغة. يتركون عباراتهم وكتاباتهم كما يتركون رصاصهم، تذكيرًا وقحًا بمرورهم. وكأنّهم يقولون: “كنّا هنا”. وكأنّ الدمار وأصوات القصف التي لم تنقطع، لم تكن كافية لإعلان وجودهم.

تعلّق المعالجة النفسية دينا حامد لـ “مناطق نت” أنّه “حين يمرّ الإنسان في شارع يحمل على جدرانه عبارات عدائيّة أو تهديديّة، فإنّه لا يقرأ مجرّد كلمات مطبوعة بالطلاء، بل يواجه مرآة تعكس خوفه العميق وتهزّ شعوره بالأمان، هذه العبارات تتحوّل إلى جرح حيّ في النسيج النفسيّ والاجتماعيّ، لأنّها تستفزّ الدماغ والجسد والذاكرة في آن واحد”.
فمن منظور علم النفس العصبيّ “النيو سيكولوجيا”، الكلمة المكتوبة ليست حياديّة. العين تلتقطها كصورة بصريّة تنتقل بسرعة إلى الأميغدالا، المركز الدماغيّ المسؤول عن رصد الخطر، قبل أن نعي معناها الكامل. لهذا ربّما يشعر المرء بانقباض في صدره أو تسارع في نبضه لحظة رؤيته رسالة من هذا النوع، حتّى لو حاول إقناع نفسه بأنّها مجرّد “كتابة على الحائط”. هذه الاستجابة الفوريّة ليست ضعفًا، بل آليّة بيولوجيّة وُجدت لحمايتنا من الأخطار، وفقًا لحامد.
بصمة عنف
الكتابات تعمل كبصمة عنفٍ، تذكير بوجود تهديد، وإعادة فتح جروح سابقة. لفهمها نفسيًّا لا يكفي تفسيرها كـ “شغب” عابر، بل لا بدّ من رؤية التداخل الفرديّ والجماعيّ والاستراتيجيّ.
عمّا وراء هذه الكتابات، تقول حامد “الشرح الأفضل هو تبنّي منظور متعدّد المستويات: فبعض الأفراد قد يكتبون بدافع تفريغ الغضب، تباهٍ، أو رغبة في شعور السيطرة. هذا ينسجم مع مفاهيم في علم النفس الجنائيّ عن السلوك التخريبيّ كوسيلة لاسترجاع شعور القوّة لدى من يشعرون بالعجز أو بالإثارة من فعل المحظور”.

من المعلوم أنّه داخل المجموعات العسكريّة، توجد آليّات تعزيز سلوكيّات معيّنة، مثل التشجيع الضمنيّ، السخرية الجماعيّة، التي تُقاس عبر إظهار التشدّد. لذا تشير حامد إلى أنّ “هذه الديناميكيّة تقوّي سلوك الفرد وتحوّله من فعل فرديّ إلى ممارسة مقبولة داخل المجموعة”. وأنّ “هذه الظاهرة لا تقف أمام سببٍ واحد، بل أمام حبكة من أسباب فرديّة، اجتماعيّة- مؤسسيّة، واستراتيجيّة”.
ففي سياق الحرب أو الاحتلال، تصبح الرسائل المكتوبة أدوات حرب نفسيّة بامتياز، وسيلة لمحاولة زرع الخوف، تقليل الشعور بالأمن، وإرسال رسالة رمزيّة بأنّ “المكان هُنا مُحتلّ”.
ماذا تقول جدران القرى
يقول جواد بدرالدين، من راشيّا، عن زيارته قرية كفركلا الحدوديّة، وكان قد فسّر إحدى الكتابات التي شاهدها على جدار في القرية: “رأيت الحائط والكتابات الموجودة عليه بالعبريّ، ترجمت الكلمات لتظهر أنّها تعني: كاهانا حيّ أو Kahane lives”. ويسأل “من كاهانا؟ وماذا تعني العبارة؟” يتابع بدرالدين لـ “مناطق نت”: “الحاخام مئير كاهانا هو سياسيّ إسرائيليّ- أميركيّ معروف بتوجّهاته اليمينيّة المتطرّفة”.
ويوضح أنّ “أنصاره استخدموا هذه العبارة للتعبير عن أنّ أفكاره لا تزال حيّة على رغم مقتله. وتُعتبر هذه العبارة شعارًا سياسيًّا متطرّفًا. مع العلم أنّه دعا إلى طرد العرب من فلسطين بالكامل، وإقامة دولة يهوديّة “نقيّة عرقيًّا ودينيًّا”، وتطبيق الشريعة اليهوديّة (الهالاخا) كقانون رسميّ للدولة”.
زنجي: عندما رأيتُ الكتابات على الجدران، خطر ببالي مباشرةً الاستيطان ومعاناة الفلسطينيّين مع المستوطنين، وكم يشعرون بالقهر
ويرى أنّه من “الضروريّ أن يفهم الجميع، ليس فقط أهل الجنوب، من هم هؤلاء، وماذا يريدون من أرضنا، والخطر المترافق معهم، لنتنظّم ونفكّر كيف نقاوم من يريد تهجّيرنا وقتلنا”.
“تنمّر جماعيّ” أم “عدوان ساديّ”؟
تعتبر حامد أنّ الإجابة الدقيقة قد تكون كلا الاثنين، لكنّ كلّ واحدة منها توضح زاوية مختلفة. وتلفت إلى أنّه “عندما نستخدم مصطلح التنمُّر الجماعيّ collective bullying، نؤكّد أنّ الفعل موجّه ضدّ مجموعة يُهدف إلى إذلالها أو إخضاعها. أمّا العدوان الساديّ فمرتبط أكثر بالحافز النفسيّ الذاتيّ وهو ما يعني استمتاعُ بعض الأفراد بإيذاء الآخر أو بإلحاق الألم النفسيّ بالآخر”.
هذا يفسّر حالات فرديّة يمكن أن تكون أكثر قسوة وتميّزًا. لكنّ وجود أفراد ساديّين لا يفسّر وحده لماذا أصبحت هذه الكتابات ظاهرة منتشرة. لذا ترى حامد أنّه “عمليًّا، يمكن أن نرى تداخلًا؛ فعلى المستوى النفسيّ توجد سلوكيّات قد تنشأ من دوافع فرديّة ساديّة لكنّها تُقبل أو تُشجّع جماعيًّا، وتُوظَّف تكتيكيًّا”.
يقول حسين زنجي من الطيبة، وقد زار قرية عديسة (مرجعيون) “لا أستطيع أن أصف الشعور الذي انتابني عند دخولي إلى بلدة عديسة، إذ تغيّرت ملامحها بشكل كبير. هذه البلدة جارتنا، وكنّا نتردّد إليها كثيرًا، وهي أقرب إلى فلسطين، فكانت تتمتّع بخصوصيّة فريدة بالنسبة إلينا”.
يتابع لـ “مناطق نت”: “عندما رأيتُ الكتابات على الجدران، خطر ببالي مباشرةً الاستيطان ومعاناة الفلسطينيّين مع المستوطنين، وكم يشعرون بالقهر حين يرون أرضهم تحتلّ ويستمتع بها الغريب ويقتات منها. شعرتُ وكأنّهم وضعوا أوّل علم لهم على أرضنا. وفي الوقت نفسه، قلت في سرّي: لو بقيت البلدة مهدّمة لا ينبغي أن نتركهم يتمتّعون بها”.

يضيف “ثمّ أخذتُ أتخيّل ذلك الجندي الذي كتب هذه الشعارات: ما هي حالته النفسيّة حين فعل ذلك؟ هل كان يعيش نشوة نصر، أم كان يقصد الاستفزاز، أم أنّ ما حرّكه هو الحقد؟”
“نزع إنسانية الآخر” Dehumanization
نظريّة نزع الإنسانيّة تصف كيف يمكن أن تُحرم مجموعةٌ ما من صفات “الإنسانيّة”، إمّا بإنكار الصفات الفريدة للإنسان (العقل، الثقافة) أو بإنكار صفات الطبيعة الإنسانيّة (العاطفة، القدرة على المعاناة). ولذا عندما تُكتب عبارات تُقلِّل من شأن السكّان أو تصوّرهم كـ “هدف” أو “حيوانات”، تُسهِم هذه اللغة عمليًّا في إلغاء الحواجز التي تمنع ارتكاب الأذى .
يشرح ألبيرت باندورا آليّات “فصل الضمير” بأنّه إعادة تأطير الفعل العنيف على أنّه “ضروريّ”، أو تحميل الضحايا مسؤوليّة ما يحدث، أو توزيع المسؤوليّة. ووفقًا لحامد، هذه كلّها طرق نفسيّة تجعل الفاعل يبرّر أفعاله ويستمرّ بها دون شعورٍ بالذنب. وإنّ الكتابة العدائيّة على الجدران تعمل كجزء من هذا النظام: لغة تُنسخ فيها الإهانة وتُعمّم، فتنفصل الضمائر ويُصبح الإيذاء متاحًا نفسيًّا .
التأثير النفسي على أهل القرى
من أبرز الآثار النفسيّة، تفعيل ذكريات جماعيّة وصدمات قديمة(flashbacks) لدى من لديهم تاريخ صدمة. فقد أظهرت دراسات ميدانيّة في جنوب لبنان ارتفاع معدّلات الـ PTSD والاكتئاب بين السكّان المتعرّضين لسنوات من الاحتلال والنزاعات، تبعًا لحامد.
تأثيرات مشاهدة مثل هذه العبارات تتوزّع على مستويات زمنيّة ونفسيّة واجتماعيّة، منها الفوريّ ومنها ما يمتدّ مع الزمن. وطبعًا الآثار الفوريّة تختلف بين الأشخاص، وبين من كان قد عانى مسبقًا من الاحتلال، وتتنوّع بين الشعور بالخوف، الاشمئزاز، الغضب، أو الخزي أو مجرّد شعور التفاهة تجاه الفعل.
حول ذلك، يعلّق المصوّر عباس بيطار، الذي جال على عدد من القرى الحدوديّة بعد الحرب، “أكثر ما علق في ذهني كانت الكتابات العبريّة في الخيام وعيترون، ولا سيّما أنّ الخيام شهدت معارك وملاحم من مسافة صفر. لكن عندما نرى هذه الكتابات بعد كلّ ذلك، نزداد قناعة بأنّهم كيان موقّت، وأنّنا الأقوى، صحيح أنّهم دخلوا وفجّروا وكتبوا، لكنّهم خرجوا، ونحن ما زلنا هنا اليوم.”
يتابع لـ “مناطق نت”: “في مدرسة بقرية راميا، رأيت كثيرًا من المخطوطات والكتابات التي تركوها، ورسموا أشكالًا هدفها التخويف. لم تستفزّني، بل جعلتني أشعر بمدى تفاهتهم.”
مقاربة إنسانيّة – نفسيّة
ترى حامد ختامًا أنّ “ما نحتاجه في مواجهة هذه الظاهرة لا يقتصر على حلول أمنيّة أو تقنيّة، بل يتطلّب أيضًا مقاربة إنسانيّة- نفسيّة متكاملة: حماية الأفراد عبر برامج دعم تراعي أثر الصدمة، خلق فضاءات مجتمعيّة بديلة تستعيد الألوان والرموز الإيجابيّة، وتعليم الأجيال الجديدة كيفيّة قراءة هذه العلامات دون أن تؤثّر فيهم. فمن المفيد تشجيع حملات مجتمعيّة تنظّف وتغطّي الجدران برسومات أو جداريّات تبعث رسائل أمل”.
يقول الطبيب النفسيّ النمساويّ فيكتور فرانكل، الناجي من معسكرات الاعتقال: “كلّ شيء يمكن أن يسُلب من الإنسان، إلّا شيئًا واحدًا: أن يختار موقفه تجاه أيّ ظرف يُفرض عليه”. وهنا تكمن القوّة.
ليس من السهل الكتابة عن تلك القرى، التي تحمل في تفاصيلها كلّ هذا الثقل حتّى في جدرانها. والتي كانت شاهدة على رغبتهم في محو هويّتنا ومحاولة بائسة لخلق هويّة لهم مكانها. لكنّ الجدران تعرف أصحابها الحقيقيّين. تعرف من كتب عليها كلمات الحرّيّة الأولى، ومن خطّ عليها أسماء العشّاق، ومن لوّنها بالدم عند الاحتلال. هذه القرى ليست مجرّد بلدات، هي مرآة لذاكرة جماعيّة، كلّما عدنا إليها، نجد أنفسنا في مواجهة مع تاريخ لا ينتهي.